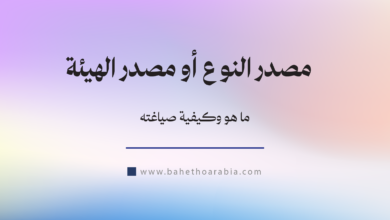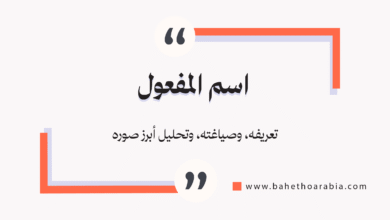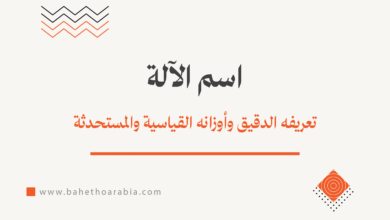التصغير: تعريفه ومعانيه وشروطه وطريقته وأحكامه وشواذه وتصغير الترخيم
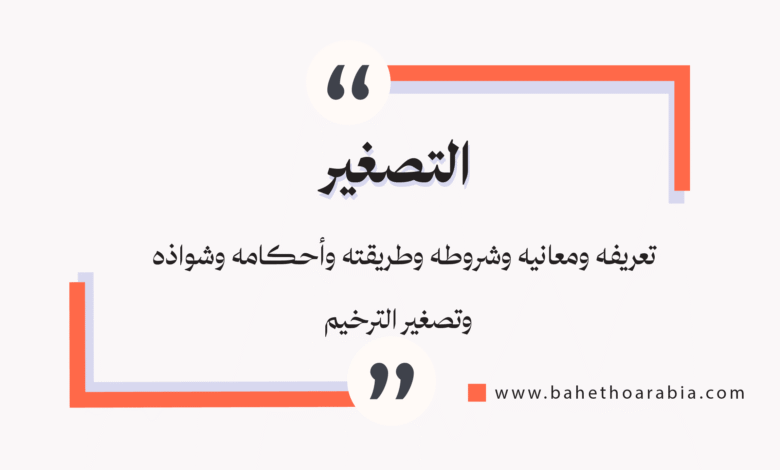
يُعدّ التصغير ظاهرة صرفية محورية في العربية؛ إذ يُحدث التصغير تغييراً منظّماً في بنية الاسم المعرب لإنتاج معنى جديد مضاف إلى المعنى الأصلي، مع الحفاظ على هوية الجذر وبنيته. يقدّم هذا العرض تحليلاً أكاديمياً مباشراً لباب التصغير بوصفه أداةً دلالية وصرفية ذات وظائف متعددة. ينطلق من تعريف التصغير وضبط حدّه الاصطلاحي، ثم يعرض معاني التصغير مثل التحقير، والتقليل، والتقريب، والتعطف، والتعظيم، مدعّماً ذلك بشواهد نثرية وشعرية.
ويتوقف عند شروط التصغير وقيوده في الاستعمال القياسي والسماعي، مبيّناً ما يُقاس وما يُحفظ. كما يفصّل صيغ التصغير المنتظمة كفعيل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل، ويربطها بأبنية الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية. ويُعنى بأحكام التصغير المتعلقة بالحروف الزائدة، وحروف العلة، وألف التأنيث المقصورة، وما حُذف من أصول الكلمة، وما أُبدل من حروفها. ويتناول التصغير في الأسماء المركبة، والتصغير في المؤنث والجمع، مع بيان مواضع الرد إلى المفرد. ويعرض شواذ التصغير وما ورد فيه على غير قياس، ثم يختم ببيان تصغير الترخيم وآلياته. وبذلك يوفّر هذا العرض إطاراً ممنهجاً لفهم التصغير في ضوء الصناعة الصرفية والاستعمال اللغوي، مع إبراز أثر التصغير في الدلالة والأسلوب.
تعريفه
تعريفه: التصغير في اصطلاح النحو هو تغيير يطرأ على بنية الاسم المعرب ليؤدي معنى جديداً بالإضافة إلى معناه الأصلي، نحو: ( قُلَيْم). في هذا المثال وقع تغيير على كلمة (قلم) بإضافة ياء تُسمّى ياء التصغير ليؤدي معنى القلم الصغير، وهذه العملية من تطبيقات التصغير في العربية ضمن باب التصغير.
معانيه
معانيه: يؤدي التصغير معاني عدة، أهمها: التحقير، والتقليل، والتقريب، والتعطُّف، والتعظيم. وهذه الدلالات من أشهر ما يعبّر عنه التصغير.
- التحقير: نحو: شُوَيْعِر، رجيل، كويتب.
- التقليل: نحو: دُرَيهمات، سويعات، لقيمات، وريقات.
- التقريب: نحو: فويق، تحيت، دوين، قبيل، بعيد، قال الشاعر:
دَانٍ مُسِفٌّ فويْقَ الأرضِ هَيْدَبُه يكاد يدفعُه مَنْ قامَ بالرّاح - التعطف: نحو: بني، أخيّ، بنيتي، مسيكين، سليمى، بثينة.
- التعظيم: نحو: دُريهمات، داهية عظيمة، قال الشاعر:
وكلُّ أناسٍ سوف تدخلُ بينهم دُوَيْهِيَةٌ تصفَرُّ منها الأنامل
شروطه
شروطه: للتصغير ثلاثة شروط رئيسة، هي:
١- أن يكون الاسم معرباً، فلا يُصّغّر في باب التصغير الاسم المبني، كاسم الشرط، واسم الاستفهام، واسم الإشارة، والضمير، وغيرها من المبنيات. وقد سُمع عن العرب تصغير بعض الأسماء المبنية، فيُحفظ، ولا يُقاس عليه، نحو تصغير أسماء الإشارة (ذا، وتا، وأولاء). سُمع تصغيرها على ذيّا، وتيّا، وأولياء، وحُمِل عليها تصغير (ذان، وتان) فصُغِّرا على (ذيّان وتيّان). وصُغِّر اسما الموصول (الذي والتي) على ( اللذيّا و اللتيّا)، وصُغِّر بعض الأسماء المركبة ( أحد عشر إلى تسعة عشر): وسيبويهِ ونفطويه، فقالوا: ( أحيدَ عشر… وسيبويه، ونفطويه). وهذا كله وارد في التصغير سماعاً.
٢- أن يكون الاسم في الأصل غير مصغّر؛ وفي نظام التصغير تصغّر الأسماء التي يلازمها التعظيم، كاسماء الله، والأنبياء، والملائكة، ولا تصغّر الأسماء التي تدل على العموم أو الشمول، نحو: (كلّ)، أو ما يدل على الجزء، أو القلة، نحو ( بعض)، أو ما يدل على زمان محدد، كأيام الأسبوع، وأسماء الشهور، وفق قواعد التصغير.
طريقة التصغير
ـ طريقة التصغير: للتصغير ثلاث صيغ أساسية:
- (فعيل) لتصغير الثلاثي المجرّد وما في حكمه، نحو: (جُبَيل وبُدَير وقُمَير).
- (فُعَيْعِل) لتصغير الرباعي المجرّد، والثلاثي المزيد بحرف واحد، نحو: (جعيفر، أحيمر، ومجيلس). ومن الملاحظ أن وزن (أحيمر) هو ( أُفَيْعل)، وهو وزن يشبه من جهة الإيقاع والشكل صيغة التصغير ( فُعَيْعِل)؛ فأوله مضموم، وثانيه مفتوح، وثالثه ياء ساكنة، ورابعه مكسور، وخامسه حرف إعراب.
- الصيغة الأخيرة في التصغير هي ( فُعَيْعِل) لتصغير الخماسي إذا كان رابعه حرف علة، نحو: ( قنديل، عصيفير). وكذلك ما كان على خمسة أحرف، وكان رابعه حرف علة، نحو: ( مصيبيبح، مسيمير). ووزن مصيبيح هو ( مفيعيل)، وهو يشبه ( فُعَيْعِيل).
أحكام التصغير
ـ أحكام التصغير:
١- الحروف التي لا تُحسب حين تصغير الاسم: لا تُحسب الحروف التالية حين يُصغَّر الاسم في التصغير: تاء التأنيث، ألف التأنيث المقصورة او الممدودة، والألف والنون الزائدتان، وياء النسب، وعلامة التثنية، وعلامة الجمع السالم، وعجز الاسم المركب تركيباً مزجياً. تقول: وردة ـ وُرَيدة، غرفة ـ غُريفة، حنظلة ـ حُنيظلة، مَرْحلة ـ مًرَيْحلة. وتقول: نُعمى ـ نُعيمى، حَمراء ـ حميراء، قُرفصاء ـ قُرَيْفِصاء. وتقول: عطشان ـ عطيشان، عثمان ـ عُثَيمان، زعفران ـ زُعَيْفَران. وتقول: طالبان ـ طويلبان، كاتبون ـ كويتبون، طالبان ـ طويلبات. وتقول: عبقري ـ عُبَيْقَري، جَوْهري ـ جُوَيْهريّ. وتقول: بعلبك ـ بُعَيلبك، سمر قند، سمير قند.
٢- تصغير ما كان على خمسة أحرف أصلية: يُحذف الحرف الأخير، ويُحذف الحرف الزائد على الخماسي إذا كان الخماسي مزيداً فيه حرف، وذلك بحسب قواعد التصغير. تقول: في تصغير سفرجل ـ سُفَيْرِج، وفي تصغير فرزدق ت فُرِيْزِد، وفي تصغير عندليب ـ عُنَيْدل.
٣- تصغير ما فيه زيادة: إذا كان في الكلمة حرف زائد، حُذف حتى تبقى على وزن يمكن تصغيره. تقول في باب التصغير: منطلق ـ مطيلق، استرخاء ـ سُرَيْخيء.
٤- تصغير ما فيه حرف علة:
١- إن كان حرف العلة ثانياً رُدّ إلى أصله (الواو أو الياء) إن كان منقلباً، وتنقلب الألف إلى واو إن كانت زائدة، وذلك وفق أصول التصغير. تقول: باب ـ بُوَيب، لأن أصل الألف واو؛ فالجمع (أبواب)، مال ـ مُوَيل، الألف أصلها واو لأن الجمع (أموال). وناب ـ نُييب لأن الألف أصلها ياء، فالجمع (أنياب). وموسر ـ مُيَيْسر، لأن الواو أصلها ياء لأنها مشتقة من الفعل أيسر، وتقول: مُوَيزِين في تصغير ميزان، لأن أصل الياء واو، فهي من الفعل (وزن). وشذّ تصغير بيضة على بويضة، والقياس بييضة. وتقول في تصغير طالب ـ طويلب؛ وشاعر ـ شويعر، وعالم ـ عويلم، وقارئ ـ قويرئ… لأن الألف زائدة.
ب ـ إذا كان حرف العلة ثالثاً بقي على حاله إن كان ياء، وقُلب ياء إن لم يكن ياء، وأُدغم في ياء التصغير. عصا ـ عصيّة، دعوة ـ دعيّة، جميل ـ جميِّل، كريم ـ كُرَيِّم.
جـ ـ إن كان حرف العلة رابعاً رُدّ إلى أصله إن كان له أصل، وقُلب إلى ياء إن كان واواً أو ألفاً زائدة، وبقي كما كان ياء زائدة، وذلك في نظام التصغير. تقول: منشار ـ منيشير، أرجوحة ـ أريجيحة، قنديل ـ قنيديل، وتقول في تصغير ملهى ـ مليهٍ، فقد قلبت الألف واواً، ثم قلبت ياء لأنها متطرفة، وقبلها مكسور، ثم حذفت لا لتقاء الساكنين.
٥- تصغير ما انتهى بألف التأنيث المقصورة: ضمن قواعد التصغير:
آـ إن كانت الألف رابعة صُغِّر على وزن فُعَيْعِل، وفتح ما قبل الآخر، في التصغير نحو: سلمى ـ سليمى، حبلى: حبيلى، كَسْلى ـ كسيلى.
ب ـ إن كانت الألف فوق الرابعة، وفي الكلمة حرف مد، حُذفت، أو حُذف حرف المد بحسب قواعد التصغير، نحو: حُبارى ـ حبيرى، أو حبيِّر. فإن لم يكن في الكلمة حرف مد حُذفت ألف التانيث نحو: سبطرى ـ سبيطر.
٦- تصغير ما حذف منه شيء: يعود الحرف المحذوف إلى الاسم في التصغير، إلا إذا وقع حيث يجب الإعلال بالحذف. تقول في يد ـ يُديّة، فأصل ( يد) هو ( يَدَي)، وهي اسم مؤنث تأنيثاً معنوياً، ولذلك أضيفت تاء التأنيث، ومثل ذلك دم ـ دُمى، أصل (دم) هو (دَمَوٌ)، عادت الواو ثم قلبت ياء لأنها سبقت بياء ساكنة، وتقول شُفَيْهة في تصغير شفة. عادت الهاء محذوفة. وتقول: وُعَيْدة في تصغير عِدَة، ووزينة في تصغير زنة، عادت الواو المحذوفة، ولا تُردّ المحذوف في نحو: قاضٍ وقويضٍ، لأن التقاء الساكنين يمنع ذلك.
٧- تصغير ما آخره حرف مُبدل: التصغير يعيد الحروف إلى أصلها الذي أبدلت منه، نحو ماء ـ مُوَيْه، لأن الهمزة مبدلة من الهاء، والدليل على ذلك أن جمعه (مياه) او (أمواه)، وتصغير سماء ـ سميّة، لأن الهمزة أصلها واو، ثم قلبت الواو ياء لأنها مسبوقة بياء ساكنة، ثم أدغمت في الياء، علاء ـ عُلَيّ.
٨- تصغير الاسم المركب: في التصغير يُصغَّر صدر الاسم المركب، سواء أكان التركيب إضافياً أم مزجياً، فتصغير عبد الله ت عبيد الله، أم سعيد ـ أميمة سعيد، وسمع تصغير المضاف إليه. قال الشاعر:
أعَلاقة أمَّ الوليّد بَعْدَما أفنانُ رأسِك كالثّغام المُخْلَس
وتقول في تصغير خمسة عشر ـ خميسة عشر.
٩- تصغير المؤنث: في التصغير إذا صُغِّر المؤنث الثلاثي وجب أن تظهر فيه علامة التأنيث إن لم تكن ظاهرة إلا إذا أدى ذلك إلى اللبس. يد ـ يديه، عين ـ عيينة، أُذن ـ أذينة، دار ـ دويرة، شمس ـ شميسة، سن ـ سنينة.
١٠- تصغير الجمع:
آـ يُصغّر جمع القلّة، وهو بلفظ الجمع. نحو: أشيهر، أصيحاب، أعيمدة.
ب ـ لا تصغّر الجموع الأخرى (جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير). بل تُردّ إلى المفرد، فيُصغّر، ثم تُجمع جمع السلامة، تقول: رجال ـ رجيلون، دراهم ت دريهمات، شواعر ـ شويعرات، طالبات ـ طويلبات. وفي التصغير لا تُصغّر هذه الجموع مباشرة.
شواذ التصغير
شواذ التصغير: جاءت بعض الكلمات مصغرة تصغيراً قياسياً، وآخر سماعياً، وجاءت بعض الكلمات مصغّرة على غير قياس، فعُد ذلك من شواذ التصغير. من ذلك: عشية ـ عُشيشية، غِلْمة ـ أُغَيلمة، صبية ـ أصيبية، بنين ـ أبينين أو أبينيون، حرب ت حريب، عِشاء ـ عُشيّان، عرس ـ عُريس.
تصغير الترخيم
الترخيم في النحو حذف آخر المنادى للتخفيف، والترخيم في التصغير تجريد الاسم المصغر في الأحرف الزائدة. شاعر ـ شُعير، حامد ـ حُميد، عالم ـ عُليم، ضارب ت ضريب. وقد ورد في ذلك ( رويداً). فالمصدر هو ( إرواد) حُذفت الأحرف الزائدة، ثم صُغّر تصغير ترخيم. ومثل ذلك ( زهير) فهو تصغير ( أزهر). حُذفت الهمزة لأنها زائدة. ومنه ( سُوَيد) تصغير أسود. وتزاد تاء التأنيث إن كان مؤنثاً، نحو: زرقاء ت زريقة، إلا إذا كان وصفاً خاصاً بالإناث .نحو: طالق ت طليق، حائض ت حُييض. ومنه: عُصيفِر تصغير عُصفور، ومُفَيْتح تصغير مفتاح، وقريطس تصغير قرطاس. وهذا الباب من أبواب التصغير، وضمن التصغير تظهر أساليب التصغير وقواعد التصغير في الاستعمال.
خاتمة
يتبيّن من هذا العرض أنّ التصغير منظومة صرفية دقيقة تتكامل فيها القاعدة والسمع، وتنتج عنها ثروة دلالية تُنمّي قدرة العربية على الإيجاز والإيحاء. فقد كشف تتبّع تعريف التصغير ومعانيه عن طاقةٍ أسلوبية تجمع بين التحقير والتقليل والتقريب والتعطف والتعظيم، كما أظهر تحليل شروط التصغير وصِيَغه كيف تُراعي العربية أوزان الأصول وتصرّف الحروف الزوائد وحروف العلة ضبطاً يحقق الانسجام الصوتي والمورفولوجي.
وأبرزت أحكام التصغير حدود القياس وما يُستثنى بالسماع، سواء في الأسماء المبنية أو المركبة أو المؤنثة أو الجموع، مع ضرورة ردّ بعض الألفاظ إلى أصولها عند التصغير أو منع تصغير بعضها الآخر. وتؤكد شواذ التصغير أن باب التصغير ليس ميكانيكياً تماماً، بل هو تاريخ استعمالي يحتفظ بخصوصياته.
ويظلّ تصغير الترخيم وجهاً عملياً لتجريد الأبنية من الزوائد بما يخدم الخفة والوضوح. عملياً، يتطلب إتقان التصغير مرونة في تطبيق القاعدة، وحسّاً صرفياً يميّز بين ما يُقاس وما يُحفظ، وتدريباً مستمراً على الأمثلة والشواهد. وبذلك ينهض التصغير بدورٍ بيّن في توسيع دوائر المعنى، وتدقيق الفروق الدلالية، وصياغة خطاب عربي رشيق يجمع بين الطواعية والضبط.
الأسئلة الشائعة
١) ما المقصود بالتصغير من منظور صرفي، وما حدّه الاصطلاحي؟
التصغير في العربية تغيير منظّم يطرأ على بنية الاسم المعرب لإفادة معنى جديد يضاف إلى معناه الأصلي مع الحفاظ على أصوله الصرفية. يقوم التصغير على إقحام ياء مخصوصة في موضع معيّن من البنية الصرفية وفق أوزان قياسية، فينتقل الاسم من دلالته العامة إلى دلالة تُشعر بصِغَر الحجم أو قلة العدد أو قرب الزمن أو نحو ذلك. مثال ذلك: قلم ← قُلَيْم، وجبل ← جُبَيْل.
من الناحية الاصطلاحية، يعرّف التصغير بأنه “إحداث بنية مشتقة تلائم وزن التصغير المعهود مع إجراء ما يلزم من ردّ الحروف إلى أصولها أو حذف الزوائد أو تسكين وفتح ما ينبغي تسكينه وفتحه”، وهو لذلك بابٌ صرفي يتقاطع مع مباحث الإعلال والإبدال والزيادة، كما يتداخل مع مباحث دلالية وبلاغية؛ إذ يتوسّل المتكلّم بالتصغير لإيصال تحقيرٍ أو تقليلٍ أو تعظيمٍ أو تعطفٍ أو تقريبٍ بحسب السياق.
٢) ما الدلالات الرئيسة التي يحملها التصغير، وكيف نميّز بينها في الاستعمال؟
للتصغير محمولات دلالية متعدّدة أبرزها:
- التحقير: كقولهم شُوَيْعِر، رُجَيْل، كُوَيْتِب؛ ويُستعمل لإظهار ضعة الشأن أو ضعف القدرة.
- التقليل: مثل دُرَيهمات، سُوَيْعات، لُقَيْمات، وُرَيْقات؛ ويغلب في سياقات تقدير الكمّ القليل أو التهوين.
- التقريب: نحو فُوَيْق، تَحَيْت، دُوَيْن، قُبَيْل، بُعَيْد؛ وترد لبيان قربٍ زمانيّ أو مكانيّ، وقد شاع في الشواهد الشعرية: دانٍ مسفّ فويق الأرض هيدبه.
- التعطف والتحبيب: كنداء القريب: بُنيّ، أُخَيّ، بُنَيّتي، مسيكين، سُليمى، بثينة؛ ويُقصد به الملاطفة.
- التعظيم على خلاف الأصل: كاستعمال دُرَيهمات في مقام التفخيم للحدث لعِظَم أثره في سياقٍ ما، ومن الشواهد: وكل أناس سوف تدخل بينهم دُوَيْهِية تصفرّ منها الأنامل.
والتمييز بين هذه الدلالات محكوم بالسياق والنبرة وملابسات الخطاب، فالكلمة الواحدة قد تحمل تحقيراً أو تعطفاً بحسب المقام.
٣) ما شروط إجراء التصغير قياساً، وما المواضع المستثناة سماعاً؟
يشترط لإجراء التصغير قياساً ما يأتي:
- أن يكون الاسم معرباً؛ فلا يُصغَّر المبنيّ قياساً مثل أسماء الشرط والاستفهام وأسماء الإشارة والضمائر. وقد وردت أمثلة سماعية نادرة يُحفظ فيها التصغير دون قياس، مثل: ذا ← ذيّا، تا ← تيّا، أولاء ← أولياء، وذان/تان ← ذيّان/تيّان، والموصولان الذي/التي ← اللذيّا/اللتيّا، وبعض المركبات كأحد عشر ونحوه، وسيبويه ونفطويه.
- أن يكون الاسم في أصله غير مصغّر.
- ألّا يكون ممّا يلازمه التعظيم شرعاً أو عرفاً؛ فلا يُصغَّر أسماءُ الله تعالى والأنبياء والملائكة ونحو ذلك.
ويُلحق بهذه الشروط قواعد تخص الألفاظ الدالة على العموم أو الشمول (كلّ) والجزء أو القلة (بعض) وأسماء الأزمنة المحدّدة كأيام الأسبوع وأسماء الشهور؛ فالأصل عدم تصغيرها قياساً. ويُستثنى ما ورد فيه السماع، فيُحفظ ولا يُقاس عليه.
٤) ما صيغ التصغير القياسية وكيف تُطبّق عملياً؟
الصيغ القياسية الأساسية:
- فُعَيْل: لتصغير الثلاثي المجرّد وما في حكمه. أمثلة: جبل ← جُبَيْل، قلم ← قُلَيْم، قمر ← قُمَيْر، بدر ← بُدَيْر.
- فُعَيْعِل: لتصغير الرباعي المجرّد، والثلاثي المزيد بحرف. أمثلة: جعفر ← جُعَيْفِر، أحمر ← أُحَيْمِر، مجلس ← مُجَيْلِس.
- فُعَيْعِيل: لتصغير الخماسي إذا كان رابعه حرف علّة، أو ما كان على خمسة أحرف ورابعه علّة. أمثلة: مصباح ← مُصَيبيح، مفتاح ← مُفَيْتاح، عصفور ← عُصَيْفِير.
خطوات تطبيق الصيغة: - تحديد عدد الأصول وتمييز الزوائد.
- اختيار الوزن الموافق (فُعَيْل/فُعَيْعِل/فُعَيْعِيل).
- إدخال ياء التصغير وضبط الحركات.
- ردّ الحروف إلى أصولها أو حذف الزائد بحسب القاعدة.
- مراعاة الإعلال والإدغام حيث يلزم.
٥) كيف نتعامل مع الزوائد واللواحق والعلامات عند التصغير؟
هناك عناصر لا تُحسب من بنية الكلمة عند بناء التصغير:
- تاء التأنيث: وردة ← وُرَيْدة، غرفة ← غُرَيْفة، حنظلة ← حُنَيْظِلة، مرحلة ← مُرَيْحِلة.
- ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة: نُعمى ← نُعَيْمى، حمراء ← حُمَيْراء، قرفصاء ← قُرَيْفِصاء.
- الألف والنون الزائدتان: عطشان ← عُطَيْشان، عثمان ← عُثَيْمان، زعفران ← زُعَيْفِران.
- علامات التثنية والجمع السالم: طالبان ← طُوَيْلبان، كاتبون ← كُوَيْتِبون، طالبات ← طُوَيْلِبات.
- ياء النسب: عبقري ← عُبَيْقَرِيّ، جوهري ← جُوَيْهَرِيّ.
- عجز الاسم المركّب تركيباً مزجياً: بعلبك ← بُعَيْلبك.
القاعدة العملية: نجرّد اللفظ من العلامات والزوائد التي لا تُعدّ من أصوله، ثم نُجري الوزن المناسب، ثم نردّ ما يلزم ردّه من علامات بعد التصغير إذا اقتضى السياق.
٦) ما أثر حروف العلّة في بناء التصغير، وما أهم قواعد الإعلال والإبدال هنا؟
حروف العلة تؤثّر بعمق في بنية التصغير، وأهم القواعد:
- إذا كان حرف العلة ثانياً: يُردّ إلى أصله إن كان منقلباً، وتُنقل الألف الزائدة إلى واو. أمثلة: باب ← بُوَيْب (أصل الألف الواو: أبواب)، مال ← مُوَيْل (أموال)، ناب ← نُيَيْب/نُييب (أنياب). ميزان قد يُقال فيه مُوَيْزين لردّ الياء إلى أصلها الواوي (وزن). وشذّ بيضة ← بُوَيْضة على خلاف القياس المحتمل.
- إذا كان حرف العلة ثالثاً: يبقى إن كان ياء، ويُقلب ياء إن كان واواً أو ألفاً، ثم يُدغم في ياء التصغير: عصا ← عُصَيّة، دعوة ← دُعَيّة، جميل ← جُمَيِّل، كريم ← كُرَيِّم.
- إذا كان حرف العلة رابعاً: يُردّ إلى أصله إن كان له أصل، ويُقلب ياء إن كان واواً أو ألفاً زائدة، ويثبت الياء الزائدة كما هي. أمثلة: منشار ← مُنَيْشِير، أرجوحة ← أُرَيْجِيحة، قنديل ← قُنَيْدِيل. وفي ملهى قد يقال: مُلَيّهٍ مع الحذف لاتقاء الساكنين بعد قلبات لازمة.
المعيار العام: تقديم سلامة الوزن ثم مراعاة المخارج والتآلف الصوتي عبر الإعلال والإدغام.
٧) متى نعيد المحذوف في التصغير، وكيف نتعامل مع الحروف المبدلة؟
الأصل إعادة المحذوف إذا كان من بنية الكلمة ثم حُذف لعلةٍ صوتية أو صرفية:
- ما حُذف منه شيء: يد ← يُدَيّة (الأصل يدي)، شفة ← شُفَيْهة (عودة الهاء)، عِدَة ← وُعَيْدة، زِنة ← وُزَيْنة. ويُراعى عدم الردّ إذا أدّى إلى التقاء ساكنين لا يُحتمل، كقاضٍ حيث يقال في التصغير نحو قُوَيْضٍ مع مراعاة التخفيف.
- ما آخره حرف مبدل: يعيد التصغير الحروف إلى أصولها إن عُرف الأصل. ماء ← مُوَيْه (الهمزة مبدلة من الهاء؛ جمعه مياه/أمواه)، سماء ← سُمَيّة (أصل الهمزة واو ثم تُقلب ياء وتُدغم)، علاء ← عُلَيّ.
المبدأ: نُقدّم ردّ الأصل حيث أمكن علمياً وسماعياً، ثم نُجري أحكام الإعلال والإدغام بما يوافق الاستعمال العربي.
٨) كيف يُصغَّر المركّب، والمؤنث، والجمع على وجه القياس؟
- المركّب: يُصغَّر صدر المركّب الإضافي أو المزجي غالباً. عبد الله ← عُبَيْد الله، أمّ سعيد ← أُمَيْمة سعيد. وقد يُسمع تصغير المضاف إليه نادراً في الشعر. وفي الأعداد المركّبة: خمسة عشر ← خُمَيْسَة عشر.
- المؤنث: إذا صُغِّر المؤنث الثلاثي ظهرت علامة التأنيث إن لم تكن ظاهرة، دفعاً للبس: يد ← يُدَيّة، عين ← عُيَيْنة، أُذن ← أُذَيْنة، دار ← دُوَيْرة، شمس ← شُمَيْسة، سنّ ← سُنَيْنة.
- الجمع: يُصغَّر جمع القلّة بلفظ الجمع: أشهُر ← أُشَيهر، أصحاب ← أُصَيحاب، أعمدة ← أُعَيْمدة. أما جموع السلامة والتكسير غير جموع القلّة فيُردّ لفظها إلى المفرد ثم يُصغَّر ويُعاد جمعه: رجال ← رُجَيْلون، دراهم ← دُرَيْهمات، شواعر ← شُوَيْعرات، طالبات ← طُوَيْلبات.
القاعدة: معيار القياس هو البنية الأقرب إلى الضبط الصوتي والوضوح الدلالي، مع حفظ الشواذ سماعاً.
٩) ما شواذ التصغير، ولماذا تُعدّ خارجة عن القياس؟
الشاذّ ما ورد على غير القياس المشهور أو تعدّدت فيه الأوجه السماعيات. من أمثلته: عشية ← عُشَيشيّة، غِلْمة ← أُغَيْلمة، صبيّة ← أُصَيْبية، بنين ← أُبَيْنين/أُبَيْنيون، حرب ← حُريب، عشاء ← عُشَيّان، عرس ← عُرَيْس.
وتُعدّ شاذةً لأنها:
- خالفت الوزن المتوقع مع الأصول.
- أو تضمنت قلباً وإبدالاً غير مطّردين.
- أو جاءت على أكثر من وجه سماعي.
ومنهج التعامل: تُحفظ ولا تُقاس عليها، وتُستحضر كشواهد على مرونة النظام الصرفي وثرائه التاريخي.
١٠) ما تصغير الترخيم، وكيف يختلف عن الترخيم في النداء؟
الترخيم الندائي حذف آخر المنادى للتخفيف: يا حارِ في يا حارث. أما تصغير الترخيم فهو تجريد الاسم المصغّر من الزوائد قبل إجراء التصغير على أصله؛ أي نُرخّم بنية الكلمة ثم نُصغّرها. أمثلة: شاعر ← شُعَيْر، حامد ← حُمَيْد، عالم ← عُلَيْم، ضارب ← ضُرَيْب. ويُستشهد أيضاً: رُويداً (من إرواد بحذف الزوائد ثم التصغير)، زُهَيْر (تصغير أَزهر بحذف الهمزة الزائدة)، سُوَيْد (تصغير أسود). وتزاد تاء التأنيث عند الحاجة: زرقاء ← زُرَيْقة، إلا إذا كان الوصف خاصاً بالإناث كطالق وحائض فيقال: طُلَيْق، حُيَيْض. ومن صيغ المشهور: عُصَيْفِر (من عصفور)، مُفَيْتاح (من مفتاح)، قُرَيْطِس (من قرطاس).
الفارق الجوهري: الترخيم الندائي إجراء نحوي صوتي للتخفيف في النداء، أما تصغير الترخيم فإجراء صرفي يسبق وزن التصغير بإزالة الزوائد ليرجع إلى الأصل ثم يُبنى على الأوزان القياسية، فيتحقق الانسجام الصوتي والوضوح الدلالي في آن.