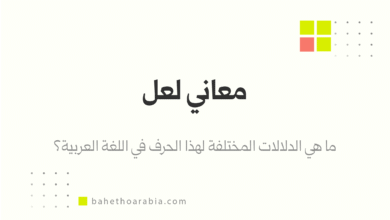ما هو الفرق بين الشاهد وموضع الشاهد والمثال ووجه التمثيل؟

شكّل تدوين قواعد اللغة العربية لحظةً فارقةً في تاريخ الحضارة، حيث اعتمد العلماء الأوائل على منهجية استقرائية صارمة، تستند إلى جمع المادة اللغوية الفصيحة وتحليلها لاستنباط القوانين الكلية التي تحكمها. وقد أفرز هذا المنهج نظاماً دقيقاً في التعامل مع النصوص، يميز بين ما يصلح أن يكون “شاهداً” (Proof-text) يُحتج به لتأسيس قاعدة، وما هو مجرد “مثال” (Example) يُستعان به للشرح والتوضيح. إن هذا التمييز ليس مجرد ترف اصطلاحي، بل هو حجر الزاوية في منهجية البحث اللغوي التراثي. تسعى هذه المقالة إلى تفكيك هذا النظام الاصطلاحي، من خلال استعراض مفهوم الشاهد ومصادره المعتبرة، وتحديد معايير قبوله الزمانية والمكانية، ومن ثم مقارنته بمفهوم المثال، بهدف الكشف عن الأسس الإبستمولوجية التي حكمت عملية تقعيد النحو العربي.
أولاً: تعريف الشاهد النحوي
يُعرَّف الشاهد اصطلاحاً بأنه الكلام العربي الفصيح الذي يصح الاحتجاج به في بناء القواعد اللغوية. ويشكّل مجموع هذه الشواهد المدونة اللغوية التراثية الضخمة التي استقرأها العلماء لاستنباط قواعد اللغة العربية، واستكشاف أساليب العرب الأوائل في تركيب الجمل والتعبير عن المعاني.
وقد التزم العلماء بمنهجية صارمة في قبول المادة اللغوية التي اتخذوها حجة في صياغة القواعد؛ حيث تتبعوا مصادرها النقية وتحروا الدقة في قبولها، وتوقفوا عند أدنى شك أو ريبة. وقد حصر العلماء هذه المصادر المعتبرة في أربعة موارد أساسية، هي على النحو التالي:
أ – القرآن الكريم: بوصفه المصدر الأعلى والأول للغة العربية.
ب – الحديث النبوي الشريف: وقد تباينت مواقف النحاة من الاستشهاد به وفقاً لثلاثة مذاهب رئيسة:
- المذهب الأول: أحجم أصحابه عن الاستشهاد بالحديث النبوي نظراً لخطر الوضع والكذب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الرواية بالمعنى.
- المذهب الثاني: تبنى أصحابه منهج التوسع في الأخذ بالحديث النبوي كمصدر للاستشهاد.
- المذهب الثالث: رأى أصحابه أن الدقة المنهجية التي اتبعها علماء الحديث، والقواعد الصارمة في ضبط متن الحديث وسنده، والبحث العميق في علم الرجال، والمصنفات التي ميزت الصحيح من الحسن والضعيف والموضوع، كل ذلك يجعل الاستشهاد بما صح أو حَسُنَ من الحديث أمراً سليماً ومأموناً؛ إذ إن فصاحة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي فصاحة القرآن الكريم مباشرة.
ج – الشعر العربي القديم: الذي تناقله الرواة الثقات وحفظته الذاكرة الجمعية.
د – أقوال الفصحاء من العرب الأقحاح: وهم الذين سلمت سليقتهم اللغوية، واستقامت ألسنتهم، وابتعدوا عن اللحن وفساد اللغة.
ولضبط عملية قبول الشواهد، وضع النحاة لها حَدَّيْنِ أساسيين هما: الحَدُّ الزماني والحَدُّ المكاني.
- الحَدُّ الزماني: حُدِّد الإطار الزمني بالقرن الرابع قبل الهجرة وصولاً إلى القرن الرابع بعد الهجرة. وبشكل أكثر تحديداً، لم يقبل العلماء كلام أي من سكان الحواضر ممن تأخرت وفاته عن عام ١٥٠ هجرية، بينما امتد هذا القبول في البوادي لمدة قرن إضافي. وقسّم العلماء هذا الامتداد الزمني إلى قسمين:
- الاحتجاج للقواعد النحوية: حُدِّدَت نهايته بوفاة الشاعر ابن هرمة القرشي سنة ١٧٦ هجرية.
- الاحتجاج للمعاني اللغوية والبلاغية: أجاز بعض العلماء الاستشهاد بأشعار المتأخرين مثل أبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي في استنباط المعاني، لا في تأسيس القواعد النحوية.
- الحَدُّ المكاني: كان الرواة وعلماء اللغة يقصدون إلى البوادي لسماع اللغة من الأعراب الفصحاء، جاعلين ما يسجلونه عنهم مادةً لمؤلفاتهم وآرائهم النحوية. وقد فرق النحاة بين القبائل التي تسكن وسط الجزيرة العربية وتلك التي تقطن أطرافها؛ فجعلوا شواهدهم من قبائل الوسط مثل: قيس، وتميم، وأسد، وطيئ، وهُذيل، التي استوطنت نجدًا والحجاز. وفي المقابل، تجنبوا الاستشهاد بأشعار قبائل الأطراف مثل: لخم، وجذام، وقضاعة، وغسان، وإياد، نظراً لاختلاطها بالأمم المجاورة.
إن مجموع المادة اللغوية المستقاة من هذه الموارد الأربعة، وضمن هذه الحدود، هو ما يُعرف اصطلاحاً بالشواهد النحوية.
ثانياً: تعريف موضع الشاهد ووجه الاستشهاد
لتوضيح مفهومي “موضع الشاهد” و”وجه الاستشهاد”، يتم اللجوء إلى عرض تطبيقي يُستخلص منه التعريف الاصطلاحي. من ذلك قول الشاعر:
أَقَاطِنٌ قَومٌ سَلْمَى أَمْ نَوَوا ظَعْناً * إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيشُ مَنْ قَطَنَا
- موضع الشاهد: أقاطنٌ قومُ سلمى.
- وجه الاستشهاد: تمثل وجه الاستشهاد في مجيء المبتدأ (قاطن) على هيئة وصف عامل معتمد على استفهام (الهمزة)، ورفعه فاعلاً (قوم) سدَّ مسدَّ الخبر، وهذا جائز في القاعدة النحوية.
وفي قول شاعر آخر:
أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيلِ الْمُنَى * وَدَاعِي الْمَنُونِ يُنَادِي جِهَارَا
- موضع الشاهد: أنفساً تطيب.
- وجه الاستشهاد: يكمن وجه الاستشهاد في تقديم التمييز (نفساً) على عامله (تطيب)، وقد جاز ذلك لأن العامل فعل متصرف. ولا يجوز تقديم التمييز في غير هذه الحالة، حيث إن الأصل هو: أتطيبُ نفساً بنيل المنى.
بناءً على ما سبق، يمكن تعريف موضع الشاهد بأنه الجزء المحدد من النص الذي يمثل تطبيقاً لقاعدة نحوية معينة، بينما يُعرَّف وجه الاستشهاد بأنه الشرح الذي يوضح تلك القاعدة ويبين صلتها الدقيقة بموضع الشاهد.
ثالثاً: تعريف التمثيل ووجه التمثيل
إذا استدل عالم نحوي على قاعدة ما بكلام فصيح لا يندرج ضمن مصادر الشاهد المعتبرة آنفة الذكر، فإن هذا الاستدلال يُعد مثالاً لا شاهداً، حتى لو أجمع النقاد على فصاحة قائله. ومن ذلك التمثيل بأبيات لكبار الشعراء المتأخرين كأبي تمام أو البحتري أو المعري أو من يماثلهم. فعلى سبيل المثال، يسوق النحاة بيت أبي العلاء المعري:
يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ * فَلَولَا الْغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالَا
- وجه التمثيل: صرّح الشاعر بخبر المبتدأ (الغمد) الواقع بعد (لولا)، وهو جملة (يمسكه). وقد وجب التصريح بالخبر هنا لأنه كونٌ خاصّ وليس كوناً عاماً، مما يمثل القاعدة النحوية.
ولا يُطلق على ذلك “وجه استشهاد”؛ لأن المعري من الشعراء المتأخرين، حيث توفي سنة ٤٤٩ هجرية، مما يجعله خارج الإطار الزمني لقبول الشواهد النحوية.
خاتمة
تناول هذا البحث بالتحليل والتوضيح مفهوم الشاهد النحوي، وموضعه، ووجه الاستشهاد به، مبيناً الفارق الجوهري بينه وبين المثال ووجه التمثيل. وقد تم إيضاح أن الشاهد هو الكلام الفصيح المعتمد لإثبات القواعد، وأن مصادره تنحصر في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر العربي القديم، وأقوال الفصحاء من العرب، ضمن حدود زمانية ومكانية دقيقة. كما تم تعريف موضع الشاهد بأنه الجزء الممثل للقاعدة، ووجه الاستشهاد بأنه بيان تلك القاعدة وصلتها به. وفي المقابل، فالمثال هو كلام فصيح خارج مصادر الاحتجاج، ووجه التمثيل هو شرح القاعدة التي يوضحها.
الأسئلة الشائعة
السؤال ١: ما هو الفرق الجوهري بين “الشاهد النحوي” و”المثال” في منهجية الاستدلال عند علماء العربية؟
الإجابة:
يكمن الفرق الجوهري بين “الشاهد النحوي” و”المثال” في الوظيفة المنهجية والقوة الحُجّية لكل منهما. فالشاهد هو نص لغوي أصيل يُستمد من مصادر محددة ومعتمدة، ويمتلك سلطة تشريعية تُمكّن العالم من تأسيس قاعدة نحوية أو إثبات صحتها. فهو ليس مجرد دليل، بل هو حجة ملزمة تقوم عليها أركان القاعدة. ولكي يكتسب النص صفة “الشاهد”، يجب أن يستوفي شروطاً صارمة تتعلق بالمصدر (القرآن، الحديث، الشعر القديم، كلام الفصحاء)، وبالزمان (عصور الاحتجاج المحددة)، وبالمكان (القبائل العربية ذات الفصاحة المعتبرة).
أما المثال، فهو نص لغوي، قد يكون فصيحاً وبليغاً، لكنه لا يمتلك تلك السلطة التشريعية لتأسيس القواعد، وذلك لأنه لا يستوفي واحداً أو أكثر من شروط قبول الشاهد، وفي الغالب يكون السبب هو خروجه عن الإطار الزمني للاحتجاج. وظيفته الأساسية هي وظيفة توضيحية وتعليمية بحتة؛ حيث يستخدمه العالم النحوي لتقريب قاعدة نحوية قد تم إثباتها بالفعل بواسطة شاهد معتمد، أو لتقديم تطبيق مبسط وواضح لها. ومن ثم، فإن الشاهد هو أداة تأسيس وتقعيد، بينما المثال هو أداة شرح وتمثيل.
السؤال ٢: ما هي المصادر المعتمدة التي استقى منها النحاة شواهدهم، وما هو المبرر المنطقي لاعتماد هذه المصادر دون غيرها؟
الإجابة:
حدد علماء اللغة أربعة مصادر أساسية وموثوقة لاستقاء الشواهد النحوية، وهي مرتبة ضمنياً حسب درجة قوتها وحُجّيتها على النحو التالي:
١. القرآن الكريم: يُعد المصدر الأعلى والأسمى، فهو نص معجز ومحفوظ، ويمثل ذروة الفصاحة والبيان، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذا فهو حجة قاطعة لا تُرد.
٢. الحديث النبوي الشريف: يُحتج بما صح سنده ومتنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وكلامه يمثل الدرجة الثانية في الفصاحة بعد القرآن الكريم.
٣. الشعر العربي القديم: سُمّي “ديوان العرب”، لأنه كان السجل الحافظ لأيامهم وأنسابهم ولغتهم. وقد اعتُمد الشعر الذي قيل في عصور الاحتجاج لأنه يعكس السليقة اللغوية في أنقى صورها قبل شيوع اللحن.
٤. أقوال الفصحاء من العرب الأقحاح: يُقصد به كلام الأعراب الذين لم تتأثر لغتهم بمخالطة الأعاجم، والذين عُرفوا بسلامة السليقة اللغوية واستقامة ألسنتهم.
المبرر المنطقي لاختيار هذه المصادر ينبع من السعي الحثيث نحو “النقاء اللغوي” و”الأصالة”. فالقرآن والحديث يمثلان القداسة والنقاء المطلق. أما الشعر وكلام الأعراب فيمثلان السليقة العربية في عصرها الذهبي، أي قبل أن تتأثر بفساد الألسنة الذي نتج عن التوسع الحضاري واختلاط العرب بغيرهم من الأمم.
السؤال ٣: لماذا تباينت مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف رغم مكانته الدينية واللغوية؟
الإجابة:
يعود تباين مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي إلى إشكالية منهجية دقيقة تتعلق بـ”ثبوت اللفظ”. وقد تبلورت هذه المواقف في ثلاثة مذاهب رئيسة:
- المذهب المانع: تبنى هذا الفريق موقف الحيطة والحذر الشديدين، فامتنع عن الاستشهاد بالحديث. حجتهم في ذلك أن الحديث النبوي تعرض لخطر الوضع والكذب، والأهم من ذلك، أنه كان يُروى في كثير من الأحيان “بالمعنى” لا “باللفظ” الحرفي الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعله غير صالح لتأسيس قاعدة نحوية دقيقة تعتمد على بنية اللفظ ذاته.
- المذهب الموسّع: توسع أصحاب هذا المذهب في قبول الحديث كمصدر للاستشهاد دون قيود مشددة، نظراً لمكانته السامية.
- المذهب الوسطي المعتدل: وهو الموقف الأكثر شيوعاً وقبولاً، حيث رأى أصحابه أن المنهجية الصارمة التي طورها علماء الحديث (المُحَدِّثون) في نقد السند والمتن، وعلم الرجال، وتصنيف الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، توفر الأدوات الكافية لتمييز ما ثبت لفظه مما لم يثبت. وبناءً على ذلك، يجوز الاستشهاد بما صح أو حَسُنَ من الحديث استشهاداً آمناً وموثوقاً، لأنه يمثل الدرجة الثانية من الفصاحة بعد القرآن الكريم.
السؤال ٤: اشرح مفهومي “الرقعة الزمانية” و”الرقعة المكانية” اللذين اعتمدهما النحاة كمعيارين لقبول الشاهد.
الإجابة:
“الرقعة الزمانية” و”الرقعة المكانية” هما معياران منهجيان صارمان وضعهما علماء اللغة لضمان أصالة ونقاء المادة اللغوية المعتمدة كشواهد.
- الرقعة الزمانية: تشير إلى الإطار الزمني الذي اعتُبرت اللغة فيه حجة. وقد حُدِّد هذا الإطار تقريبياً بالقرن الرابع قبل الهجرة إلى القرن الرابع بعدها. وبشكل أكثر تفصيلاً، توقف العلماء عن الأخذ من سكان الحواضر (المدن) بعد عام ١٥٠ هجرية، بينما امتد هذا القبول لقرن إضافي في البوادي لنقائها النسبي. كما تم التمييز داخل هذا الإطار بين:
- الاحتجاج لتأسيس القواعد النحوية: الذي حُدّت نهايته بوفاة الشاعر ابن هرمة عام ١٧٦ هجرية.
- الاستشهاد للمعاني والبلاغة: حيث سُمح بالاستشهاد بأشعار المتأخرين (كأبي تمام والمتنبي) لإثبات المعاني، لا القواعد.
- الرقعة المكانية: تشير إلى النطاق الجغرافي الذي اعتُبرت قبائله مصدراً موثوقاً للغة الفصيحة. فضّل النحاة قبائل وسط الجزيرة العربية (نجد والحجاز) مثل: قيس، وتميم، وأسد، وهُذيل، وطيئ، لأنها كانت بمنأى عن الاحتكاك بالأمم الأخرى. في المقابل، تحرّزوا من الأخذ عن قبائل الأطراف التي جاورت الفرس والروم مثل: لخم، وجذام، وغسان، لأن لغتها تعرضت للتأثر وشابها بعض اللحن.
السؤال ٥: ما الفرق الدقيق بين “موضع الشاهد” و”وجه الاستشهاد”؟ وكيف يتكاملان في عرض الحجة النحوية؟
الإجابة:
“موضع الشاهد” و”وجه الاستشهاد” هما مكونان متلازمان في عملية التحليل النحوي للشاهد.
- موضع الشاهد: هو الجزء المحدد من النص (كلمة، أو تركيب، أو جملة) الذي تتجلى فيه القاعدة النحوية المراد إثباتها. إنه بمثابة “العينة” أو “المحل” الذي تتم ملاحظة الظاهرة اللغوية فيه. على سبيل المثال، في بيت الشعر “أَقَاطِنٌ قَومٌ سَلْمَى…”، فإن موضع الشاهد هو التركيب: “أقاطنٌ قومُ”.
- وجه الاستشهاد: هو الشرح والتفسير العلمي الذي يوضح “كيف” ولماذا” يُعد هذا الموضع دليلاً على القاعدة. إنه التحليل الذي يربط بين الظاهرة الملحوظة والقانون النحوي الكلي. في المثال نفسه، يكون وجه الاستشهاد هو القول بأن المبتدأ “قاطن” جاء وصفاً عاملاً معتمداً على استفهام، فرفع فاعلاً “قوم” سد مسد الخبر.
يتكامل المفهومان لتشكيل حجة نحوية متكاملة؛ فـ”موضع الشاهد” يقدم الدليل المادي الملموس، بينما يقدم “وجه الاستشهاد” التفسير النظري والتحليل الذي يكشف عن قيمة هذا الدليل وأهميته في بناء القاعدة.
السؤال ٦: لماذا يُعد بيت المعري “فَلَولَا الْغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالَا” مثالاً وليس شاهداً رغم فصاحته وقوته البيانية؟
الإجابة:
يُصنّف بيت أبي العلاء المعري كمثال وليس كشاهد لسبب منهجي بحت يتعلق بـ”الرقعة الزمانية” للاحتجاج النحوي. لقد توفي المعري سنة ٤٤٩ هجرية، وهذا التاريخ يقع خارج عصر الاحتجاج لتأسيس القواعد، الذي حدد النحاة نهايته بوفاة ابن هرمة سنة ١٧٦ هجرية. وعلى الرغم من الإجماع على فصاحة المعري وبلاغته، فإن لغته تنتمي إلى ما يُعرف بعصر “المولدين” أو “المتأخرين”، وهي فترة زمنية لا يُحتج بكلام أهلها لتأسيس القواعد النحوية. لذلك، عندما يستدل النحاة بهذا البيت لإثبات وجوب ذكر خبر المبتدأ بعد “لولا” إذا كان كوناً خاصاً (وهو جملة “يمسكه”)، فإنهم يستخدمونه على سبيل “التمثيل” أي التوضيح، ويقولون “وجه التمثيل فيه…”، ولا يقولون “وجه الاستشهاد”، إقراراً منهم بأن هذا البيت لا يمتلك القوة الحُجّية للشاهد الأصيل.
السؤال ٧: هل يمكن استنتاج وجود تسلسل هرمي (Hierarchy) بين مصادر الشواهد النحوية؟
الإجابة:
نعم، يمكن استنتاج وجود تسلسل هرمي واضح بين مصادر الاحتجاج، مبني على درجة القداسة والثبوت والوثوقية. يأتي في قمة هذا الهرم القرآن الكريم، فهو حجة مطلقة لا تقبل النقاش أو الرد، نظراً لثبوته القطعي ومكانته المعجزة. يليه في المرتبة الثانية الحديث النبوي الشريف الذي يصح سنده ومتنه، حيث يمثل كلام أفصح البشر. ثم يأتي الشعر العربي القديم من عصور الاحتجاج، والذي يُعتبر مصدراً غنياً وأصيلاً للسليقة اللغوية. وأخيراً، يأتي كلام العرب الأقحاح الفصحاء من الأعراب. هذا الترتيب ليس اعتباطياً، بل يعكس منهجية دقيقة في التعامل مع النصوص؛ فالنص القرآني له الأولوية المطلقة، وفي حال وجود شاهد من القرآن، فإنه يغني عن غيره. وتزداد قوة الحجة النحوية كلما استندت إلى مصدر أعلى في هذا الهرم.
السؤال ٨: ما هي الحكمة المنهجية وراء تفضيل النحاة لقبائل وسط الجزيرة العربية وتجنبهم لقبائل الأطراف؟
الإجابة:
الحكمة المنهجية وراء هذا التمييز الجغرافي تكمن في مفهوم “النقاء اللغوي” أو “سلامة السليقة”. لقد رأى علماء اللغة الأوائل أن القبائل القاطنة في قلب الجزيرة العربية، مثل قيس وتميم وأسد، عاشت في بيئة لغوية مغلقة نسبياً، مما حافظ على لغتها نقية وفصيحة وبعيدة عن التأثيرات الخارجية. أما قبائل الأطراف، مثل لخم وجذام وغسان، فكانت بحكم موقعها الجغرافي على تخوم الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، في احتكاك دائم مع غير العرب، مما أدى إلى تسرب بعض اللحن أو التأثر باللغات المجاورة إلى ألسنتهم. ولأن الهدف الأسمى كان بناء قواعد اللغة على أنقى صورها وأكثرها أصالة، فقد كان من الطبيعي منهجياً الاعتماد على المصادر التي يُطمأن إلى سلامتها اللغوية، وتجنب تلك التي يُحتمل أن تكون قد تأثرت بعوامل خارجية.
السؤال ٩: إذا كان “المثال” لا يمتلك قوة “الشاهد” الحُجّية، فما هي القيمة العلمية التي يضيفها للمصنفات النحوية؟
الإجابة:
على الرغم من أن “المثال” لا يمتلك قوة تأسيسية كالشاهد، إلا أن له قيمة علمية ووظيفية كبيرة في الكتابة النحوية، وتتجلى هذه القيمة في عدة جوانب:
١. القيمة التعليمية (Pedagogical Value): يُستخدم المثال لتبسيط قاعدة نحوية معقدة أو نادرة الورود في الشواهد الأصلية. قد يصوغ العالم مثالاً سهلاً وواضحاً ليصل بالفكرة إلى ذهن المتعلم بشكل أسرع من تحليل شاهد قديم قد يكون غريب الألفاظ أو معقد التركيب.
٢. القيمة التوضيحية (Illustrative Value): يُستخدم المثال لإبراز جوانب دقيقة في القاعدة قد لا تكون واضحة في الشاهد وحده.
٣. المرونة في الاستخدام: بما أن المثال غير مقيد بشروط الشاهد، يمكن للنحوي أن يستشهد بأبيات فصيحة من عصور متأخرة (كشعر المتنبي أو المعري) للاستفادة من جمالها البياني وقوتها في إيضاح المعنى، دون ادعاء أنها حجة تشريعية.
٤. سد النقص: في بعض الحالات التي قد يندر فيها الشاهد على قاعدة فرعية، يلجأ النحوي إلى صياغة مثال (يُسمى أحياناً المثال المصنوع) لتغطية جميع جوانب القاعدة نظرياً.
لذلك، فالمثال ليس عنصراً هامشياً، بل هو أداة مكملة وضرورية تجعل من النص النحوي أكثر وضوحاً وشمولاً وقابلية للفهم.
السؤال ١٠: كيف تتضافر مفاهيم “الشاهد”، “موضع الشاهد”، و”وجه الاستشهاد” لبناء حجة نحوية متكاملة؟
الإجابة:
تتضافر هذه المفاهيم الثلاثة في عملية متسلسلة ومنطقية لتشكيل بنية الحجة النحوية الكاملة. يمكن وصف هذه العملية على النحو التالي:
١. الانطلاق من الشاهد: تبدأ الحجة بتقديم النص المرجعي المعتمد، أي “الشاهد”، الذي يُستمد من أحد المصادر الأربعة الموثوقة. هذا الشاهد هو أساس الشرعية للحكم النحوي.
٢. تحديد الموضع: بعد تقديم الشاهد، يقوم النحوي بعزل وتحديد “موضع الشاهد”، وهو الجزء الدقيق من النص الذي يمثل تطبيقاً عملياً للقاعدة. هذه الخطوة تنقل النقاش من العموم إلى الخصوص، وتركّز انتباه القارئ على الظاهرة اللغوية قيد التحليل.
٣. تقديم وجه الاستشهاد: هذه هي الخطوة الحاسمة التي يتم فيها التحليل النظري. في “وجه الاستشهاد”، يشرح النحوي بالتفصيل كيف أن “موضع الشاهد” يتوافق مع القاعدة النحوية التي يدافع عنها، ويوضح العلل والأسباب التي تجعل هذا التركيب اللغوي صحيحاً وفصيحاً.
بهذه الطريقة، تشكل هذه العناصر الثلاثة معاً برهاناً متكاملاً: فالشاهد يقدم السلطة، والموضع يقدم الدليل المادي، ووجه الاستشهاد يقدم التفسير العلمي. هذا التكامل هو ما يمنح القاعدة النحوية قوتها ورصانتها في التراث اللغوي العربي.