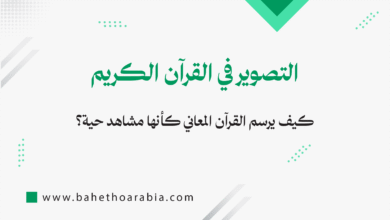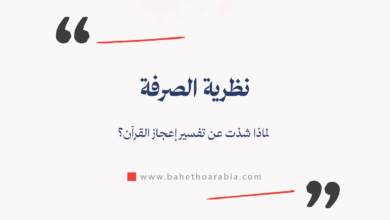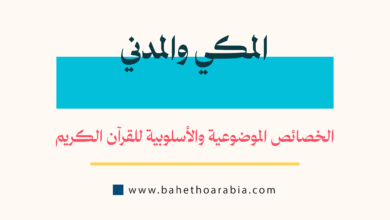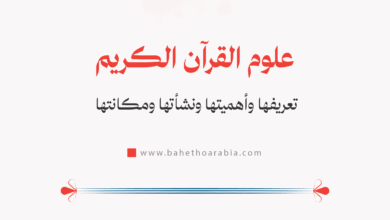فن القصة في القرآن الكريم: كيف يتميز بمنهجه وأهدافه عن غيره؟
ما الذي يجعل القصص القرآني فريداً في أسلوبه وتأثيره؟
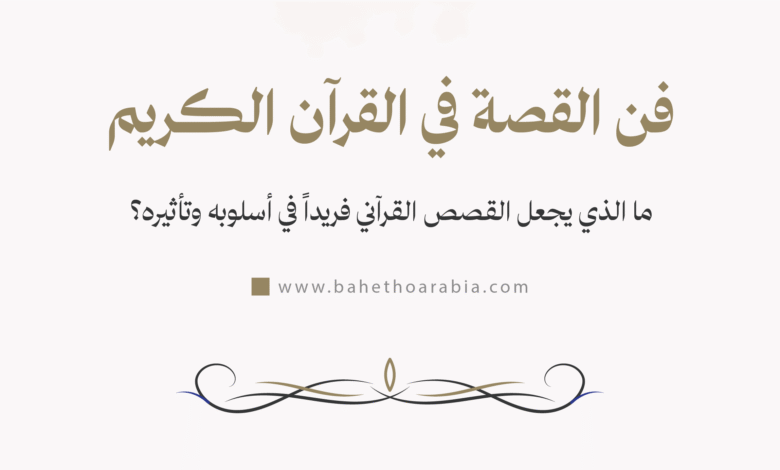
يمثل فن القصة في القرآن الكريم نموذجاً فريداً يجمع بين الإعجاز البياني والهدف الديني السامي، حيث سبق القرآن الآداب العالمية في توظيف القصة لتحقيق مقاصد عقدية وأخلاقية عميقة. وتتجلى عظمة هذا الفن في منهجه المتميز الذي يخاطب العقل والقلب معاً، ويستخرج من الوقائع التاريخية دروساً خالدة تتجدد مع كل عصر.
المقدمة
تحتل القصة مكانة مرموقة بين فنون الأدب العالمي، حتى عدها النقاد المعاصرون سيدة الأدب المنشور، واتخذها كبار الكتاب وسيلة للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم. وقد سبق القرآن الكريم هذا كله بقرون طويلة، فأولى القصة اهتماماً بالغاً، وشغلت أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها مساحة واسعة من آياته الكريمة. ويكتسب فن القصة في القرآن الكريم خصوصية تميزه عن كل ما سواه من القصص الأدبي، إذ يجمع بين الواقعية التاريخية المطلقة والهدف الديني السامي والإعجاز البياني المبهر. وتستمد القصة القرآنية أهميتها من كونها تصحح ما علق بأخبار الماضي من خرافات، وتكشف عن غيب الماضي البعيد الذي طمست معالمه الأيام، مما يشكل دليلاً قاطعاً على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
مكانة القصة في الأدب العالمي واهتمام القرآن بها
القصة فن له مكانته في الآداب العالمية، تسنمت بين فنون الأدب ذروة عالية، ونافست فنون الأدب، حتى عدها كثير من النقاد المعاصرين، سيدة الأدب المنشور دون شك، ولهذا اتخذها كبار الكتاب وسيلة للتعبير واشتهر عن طريقها كذلك فحول الأدباء العالميين. وليست هذه المكانة للقصة قاصرة على زمن سابق دون زمن لاحق، بل هي كما يرى والتر ألِين: أكثر الأنواع الأدبية فعالية في عصرنا الحديث بالنسبة للوعي الأخلاقي، ذلك لأنها تجذب القارئ لتدمجه في الحياة المثلى التي يتصورها الكاتب كما تدعوه ليضع خلائقه تحت الاختبار، إلى جانب أنها تهبنا من المعرفة ما لا يقدر على هبته أي نوع أدبي سواها، وتبسط أمامنا الحياة الإنسانية في سعة وامتداد، وعمق وتنوع.
ومن قبل بكثير سبق القرآن الكريم فأولى القصة اهتماماً كبيراً، حتى شغلت أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها، ووقائع الماضي البعيد الذي عفت عليه الأيام مساحة واسعة، لما لها من تأثير عظيم، ومن دلالة على إعجاز القرآن بإخباره عن غيب الماضي البعيد الذي طُمس على رسمه، وذهب علمه، وتصحيح ما كان باقياً منه عما علق به من الخرافات. ويتجلى فن القصة في القرآن الكريم من خلال استخدامه لكلمات دالة معبرة عن الحقائق والمقاصد الضخمة التي تشتمل عليها، مما يجعل القصة القرآنية متفردة في منهجها وأهدافها.
المعنى اللغوي للقصة وإطلاقات القرآن عليها
ويستعمل القرآن في التعبير عن هذا اللون من موضوعاته الكلمات الدالة المعبرة عن الحقائق والمقاصد الضخمة التي تشتمل عليها. وأول ما نذكر من هذه الكلمات: مادة «قص»، وهذه المادة في أصلها اللغوي تدل على التتبع لأمر ما. ومن ذلك القص مصدر بمعنى تتبع الأثر، وكذا القصص، ومنه قوله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا. وقوله: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، أي قالت أم موسى لأخته حين ألقته في الماء تتبعي أثر موسى لتعلمي من يأخذه وأين يكون مستقره. ومنه القصص: بمعنى ذكر الحوادث والوقائع السابقة، لأن القاص يتتبعها في الحديث عنها. وكذا القصة.. ومن هذا المعنى آيات كثيرة، كقوله تعالى في ختام قصة مريم: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. وقال تعالى في أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ومن استعمال هذه المادة أيضاً قوله تعالى عن لسان يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً… وقص الرؤيا هو تتبع ما رآه النائم بذكره والتحدث به. أما إطلاق القصة والقَصَص بمعنى ما يؤلفه الإنسان ويخترعه من وقائع وحوادث وأشخاص فهو اصطلاح مستحدث في اللغة العربية، سرى إلينا من الآداب الأجنبية التي يضيق عطن لغاتها عن الدلالات الدقيقة لكل لفظ وكلمة، ومعنى جزئي، خلافاً لما تميزت به لغتنا العربية من سعة وثروة واسعة جداً. كذلك يستخدم القرآن عبارة نبأ وما يشتق منها. والنبأ هو الخبر الذي له شأن وخطر، لأن ما تضمنته القصص في القرآن وقائع جليلة عظيمة يدوي بها سمع الزمان. كقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال أيضاً: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وقال أيضاً: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. كذلك يشير القرآن لقصص السابقين بكلمة أيام، كقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، أي وقائعه العظيمة في الأمم السابقة، ومنه قولهم: أيام العرب، أي وقائعهم العظيمة وحروبهم الهائلة.
التعريف الفني للقصة وأقسامها
يعرف الأدباء المعاصرون القصة تعريفات شتى أقربها إلى جوهر القصة الحديثة: أن القصة حكاية تروى نثراً وجهاً من وجوه النشاط والحركة في حياة الإنسان. لكن ليس معنى هذا أنها تروي واقعة كما هي، بل إنها مع أشد القصاص الواقعيين تمسكاً لا تروي الواقع كما هو، وإنما تؤلف من الواقع بناء يعمل فيه الخيال عمله. ولهذا قسموا القصة من حيث صلتها بالواقع أقساماً: القصة الواقعية التاريخية، كما تؤثر أن نعبر نحن عنها، والقصة الواقعية المعبرة عما يجري مثله في الواقع، لكنه ليس نقلاً لواقع محقق لقصة الكاتب، والقصة الأسطورية أي الخيالية.
أما قصص القرآن فهو من النوع الأول فقط وهو القصص الواقعي التاريخي، كما صرح بذلك القرآن نفسه بتسميته لتلك الأخبار قصصاً، كما عرفناه من معنى القصص لغة، وتسميته إياها أنباء، وأياماً. ولتصريحه بمثل قوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقوله: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. وهذا ما يميز فن القصة في القرآن الكريم عن القصص الأدبي الذي يمزج الواقع بالخيال، فالقصة القرآنية واقعية تاريخية خالصة لا تشوبها شائبة من الخرافة أو الأسطورة، وهذا يمنحها مصداقية مطلقة ويجعلها مصدراً موثوقاً للمعرفة التاريخية والعبر الأخلاقية.
الأهداف السامية للقصة في القرآن الكريم
لئن سجل الأدب لقصته أهدافاً متنوعة: أخلاقية، أو دعاية لفكرة ما، أو غير ذلك من أهداف القصة الحديثة، فإن أهداف القصة في القرآن تسمو على أهداف كل ما سواها، لأنها حكم وأسرار مرتبطة برسالة القرآن ومقاصد دعوته الاعتقادية والعلمية، والسلوكية والأخلاقية. ونلخص فيما يلي أهم تلك الأهداف:
أولاً: الهدف الأكبر والأعظم وهو إعجاز القرآن، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق شرحه.
ثانياً: بيان أن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله في النهاية، ويهلك الكافرين المكذبين، ولا يخفى ما في ذلك من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية نفوس المؤمنين وزجر الضالين المعاندين وزحزحتهم عن مواقفهم، فتتأثر النفوس كل نفس بحسب ما تحتاج إليه، إذ يتوالى عليها بيان نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ويتكرر رفع راية العدل، ومحق قوة الظلم من خلال وقائع القصص التي يذكرها القرآن، بل بما يقع فيه من التصريح بهذا التنبيه، وإثارة هذه القضية، في كثير من مناسبات القصص.
ثالثاً: بث المعاني الدينية الواضحة وترسيخ قواعد الدين، بما يقع في ثنايا القصص من حوار، ومواعظ وحجاج، يصغي إليها السامع، ويتابعها القارئ، سواء كان موافقاً أو مخالفاً، مؤمناً أو كافراً، لما في طبيعة القصص من التشويق والإثارة.
الأمثلة التطبيقية على أهداف القصة القرآنية
تأمل هذه الآيات تعقيباً على قصص الأنبياء في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي سورة غافر يقول تعالى عقب قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون وإنجاء الله موسى والمؤمن وإهلاك فرعون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
انظر هذا النص من قصة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فقد كشفت الآية بهذا الحوار دجل المتألهين أينما كانوا وحيثما وجدوا، بأنهم لا يخرجون عن كونهم عبيداً لله خاضعين لنواميسه في هذا الكون، لا يملكون لها تغييراً ولا تبديلاً، وفي هذا رفع لهذا الإنسان عن مهانة الذلة لأي من الناس واعتاق له أن يكون خاضعاً مستذلاً لأحد من بني الإنسان. وتأمل أيضاً ما يلقيه مؤمن آل فرعون لما خشي على موسى من طغيان فرعون وبطشه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد… ففي قصة موسى مع فرعون برزت هنا التوجيهات على لسان الرجل المؤمن يقرر أموراً على غاية من الأهمية، وهي جميعها معان دينية، وتوجيهات صريحة تضمنها الحوار القصصي، يجعل وقعها في النفوس أبلغ وأعمق.
منهج القصص في القرآن الكريم وخصائصه المتفردة
لما كانت القصة في القرآن تهدف إلى مقاصد دينية وإيمانية كانت طريقة القص في القرآن متميزة عن المألوف في هذا الفن، لكي يتلاءم أسلوب عرض القصة مع الوفاء بحق الغرض الذي سيقت لأجله، ومن أبرز سمات منهج القرآن في القصص ما يلي:
أولاً: أن القصة لا ترد في القرآن بتمامها دفعة واحدة، بل يقتصر على الجزء الذي يناسب الغرض الذي تساق القصة لأجله، كما يكتفى بالجملة من الآية أو شطر البيت من الشعر للاستشهاد به. وهذا الجزء الذي يذكر إنما يذكر بالحدود الملائمة للغرض كذلك.
ثانياً: استخراج التوجيهات والعظات، والإعلان بها في ثنايا القصة وختامها، مما توحي به القصة من العبر والدروس.
ثالثاً: التكرار.
مشاهد تطبيقية من منهج القصص القرآني
فقصة موسى مع فرعون في سورة غافر وردت في جو كأنه جو معركة، لأن فيها بيان الصراع بين الحق والباطل، والمعركة بين الإيمان والكفر، فتذكر السورة من القصة ما يلائم ذلك: محاولة قتل موسى، والتفكير بقتل أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ثم ظهور الرجل المؤمن بين قوم فرعون يكتم إيمانه ينصر موسى ويدافع عنه، واحتيال فرعون للتهرب من دلائل الحق وبراهينه إلى أن تأتي نهايته بالهلاك والعذاب الأليم. ويحفظ الله تعالى لهذا المؤمن الحكيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب… فكان الختام ملائماً لجو السورة، كما أنه في الوقت نفسه ختام فني رائع وهو ذلك المشهد الذي يبرز فرعون وقومه قد حلَّ بهم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياً…
ففي قصة لقمان مثلاً: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يأتي البيان القرآني بتعقيب على هذه الموعظة بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه… فهذا بعد وصية لقمان الأولى ليس من كلام لقمان، بل هو من كلام الله تعالى يوجهه سبحانه لعباده بمناسبة وعظ لقمان، يحقق غرضين كبيرين: الأول: التأكيد على وصية لقمان لا تشرك بالله ببيان أنه أعظم الحقوق، وأنه لا يجوز التساهل إزاء قضية الإيمان وتوحيد الله تعالى لأي اعتبار، ولو كان هو حق الوالدين البالغ غاية التقديس. الثاني: تأكيد حق الوالدين، وبيان أنه أجلّ حقوق العباد على الإنسان، وأقدس واجبات الإنسان تجاه الإنسان لكنه مع ذلك لا يقاوم حق الله تعالى. ومن ذلك ما نقرؤه في ثنايا حوار موسى ومؤمن آل فرعون، فموسى يقول: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا يشير إلى فظاعة من اتصف بذلك، وفي ثنايا كلام مؤمن آل فرعون: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ونقرأ في سورة غافر هذا التعقيب على القصة الذي جاء وكأنه استنتاج من وقائعها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
التكرار في القصة القرآنية وأسراره البلاغية
والتكرار خاصة من خصائص أسلوب القرآن بصورة عامة، وهو في طريقة عرض القرآن للقصة جزء من تلك الطريقة. ولهذا نجمع بحث هذه السمة الأخص بحثها في هذه المناسبة في فقرتين: تكرار القصة في القرآن، تكرار العبارات في القرآن.
١ – تكرار القصة في القرآن:
إن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل، فإن تعرض القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء مع قومه في أكثر من موضع ليس هو تكراراً بالمعنى الحقيقي، إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة، لذلك لا نجد القصة تعاد كما هي، وإنما يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة باستعراض سريع. أما القصة فلا يكرر إلا نادراً. ولاستنباط دروس وعبر جديدة منه مما يجعله على الحقيقة غير مكرر. وهكذا وردت قصة آدم في ست مواضع من القرآن تثير العبر حول خطر اتباع الهوى ومخالفة أمر الله، وضعف الإنسان، وتوبته وقبول توبته وهكذا.. كذلك وردت قصة إبراهيم في نحو عشرين موضعاً تثير في كل موضع عبرة ودرساً في التوحيد، أو الإنابة، أو تأسيس البيت العتيق، أو الأذان في الحج.. إلى آخر ما هنالك. وهكذا تكررت قصة موسى، مع فرعون، ومع قومه، ومع نبي الله شعيب في مدين، … وفي كل موضع عبرة وعظة وحكمة ودروس.
٢ – تكرار العبارات في القرآن:
هذا القسم من التكرار يبرز بعض خصائص أسلوب القرآن، وأسرار بلاغته المعجزة، فتارة يكرر الجملة أو العبارة بنصها دون تغيير فيها، لما في ذلك من التأكيد، أو التهويل، أو التصوير، وكل ذلك له أثر عظيم في تعميق المعنى في النفس وصدعها عما تصر عليه. ويظهر ذلك بوضوح بالمثال الذي يتبادر للذهن أول شيء لدى ذكر التكرار، وهو سورة الرحمن التي تكرر فيها كثيراً قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن هذه السورة تعدد للمنكرين نعم الله عليهم ودلالة كل نعمة على وجوب الانقياد لله تعالى شكراً له، وخضوعاً لعظمته، لكنهم كفروا هذه النعم كلها، فوضعوها في غير موضعها: وكفروا بالمنعم وأشركوا به غيره فعبدوا الأوثان والشركاء، فجاءت سورة الرحمن تحاجهم وتخاصمهم بإيقافهم على كل واحدة منها بالحجة الملزمة، وهكذا بالتعداد المفصل لتلك النعم والدلائل حتى تزحزح المعاند عن عناده، وترسخ في أعماق النفس الشعور بوجوب شكره تعالى. فعقب ذكر كل واحدة من النعم والدلائل بهذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تصريف البيان وإعجازه في القصة القرآنية
وتارة يكون التكرار مع اختلاف في نظم الجملة، أو إيجاز أو إطناب أو نحو ذلك. وذلك يبرز سراً من أسرار إعجاز القرآن، وهو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوب دون أن ينال تكرار المعنى من سمو الأسلوب وإعجازه، بينما لا يخلو كلام البشر في مثل هذا الحال من تفاوت بين الأسلوبين واختلاف مستوى الأداءين. وذلك من جملة تصريف البيان في القرآن الذي ذكره القرآن في مناسبات متعددة، كقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وقوله: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست.. وقوله: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً. وحقيقة التصريف: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى، خشية تناسي الأول لطول العهد به..
وبهذا التصريف المعجز حقق القرآن هدفاً عظيماً هو خطاب الناس كافة: ممن تكفيه الإشارة والموجز من القول، ومن لا يسد خلل فهمه إلا التفصيل وهكذا تنوع أسلوب القرآن. وقد لفت هذا التصريف المعجز أنظار البلغاء وراحوا يكشفون ما في كل موقع من سر بلاغي، وإعجاز بياني، حتى في الكلمة الواحدة تختلف بها العبارة من موقع إلى موقع، ونشأ لهذا الغرض الأخير فن جليل دقيق هو متشابه القرآن اللفظي، أذكر منها كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي. ومن أمثلة ذلك هذا التحليل نسوقه لك من الكتاب المذكور: قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالسؤال هنا: لم قدم في الأول: ضمير المخاطب نحن نرزقكم وفي الثاني ضمير الغائب: نحن نرزقهم.. والجواب عن هذا من أكثر من وجه نذكر منها ما يختص بالمعنى: أن الآية الأولى تحريم قتل الأولاد الذي يدفع إليه الفقر النازل فعلاً بالآباء، كما قال من إملاق، مناسب لذلك تقديم ذكر الآباء لأنهم هم الذين يعانون هنا الفقر فعلاً، وهو يدفع بعضهم للتخلص من أعز شيء عليه، فكان الملائم للمقام تقديم ذكر الآباء. أما الآية الثانية: فتحرم قتل الأولاد الذي يدفع إليه خوف الفقر في المستقبل خشية إملاق لتضاعف مسؤوليات النفقة بسبب الأولاد، مناسب لذلك تقديم ذكر الأبناء نحن نرزقهم، لأن ضمان مستقبلهم من الله وإزاحة هذا التخوف والوسواس الذي تحرك في القلب بسببهم. ولذلك أمثلة كثيرة: أتى في دراستها العلماء بروائع الإعجاز القرآني.
الخصائص الفنية للقصة القرآنية ومدى تطورها
نقف ههنا على جديد في أسلوب القرآن المعجز، هو تجاوب أسلوب القصص الفني في القرآن مع فن القصة المعاصر: ونوضح ذلك من أربعة أوجه هي أعمدة الخصائص الفنية للقصة. وتكشف هذه الخصائص عن سبق القرآن الكريم لكل الآداب العالمية في توظيف الأساليب السردية المتقدمة التي لم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث، مما يؤكد الإعجاز البياني للقرآن الكريم ويثبت أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
ويتجلى فن القصة في القرآن الكريم من خلال مجموعة من الخصائص الفنية التي تميزه عن كل ما سواه من القصص الأدبي في العالم، وتجعله متفرداً في منهجه وأسلوبه. وقد تنبه الباحثون المعاصرون إلى البون الهائل بين القصة في الأدب العربي وآداب العالم في عصر نزول القرآن وما تطور إليه فنها في العصر الحديث، ووجدوا أن القرآن قد سبق كل هذا التطور بقرون عديدة، مما يشكل دليلاً إضافياً على إعجازه وعلى أنه ليس من صنع البشر.
تنوع طريقة العرض في السرد القرآني
أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض. وقد لاحظنا في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة، على النحو التالي:
١ – مرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها: ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها. وذلك كطريقة قصة أصحاب الكهف فهي تبدأ هكذا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشداً، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً. ذلك ملخص للقصة، ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل دخولهم الكهف، وحالتهم بعد دخوله، ونومهم، ويقظتهم، وإرسالهم واحداً منهم ليشتري لهم طعاماً، وكشفه في المدينة، وعودته، وموتهم، وبناء المعبد عليهم واختلاف القوم في أمرهم… الخ. فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات.
٢ – ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها: ثم تبدأ القصة بعد ذلك وتسير بتفصيل خطواتها من أولها ومن ذلك قصة يوسف، فهي تبدأ بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم. هكذا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. ثم تسير القصة بعد ذلك: وكأنما هي تأويل للرؤيا، ولما توقعه يعقوب من ورائها، حتى إذا تحققت أنهى القصة، ولم يسر فيها كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفني الدقيق.
٣ – ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص: ويكون في مفاجآتها الخاصة ما يغني. مثال ذلك قصة مريم عند مولد عيسى، ومفاجآتها معروفة. وكذلك قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس.
٤ – ومرة يحيل القصة تمثيلية: فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض، ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بواسطة أبطالها. وذلك كالمشهد الذي يصوره القرآن من قصة إبراهيم وإسماعيل في بنائهما للكعبة المشرفة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه إشارة البدء. أما ما يلي ذلك فمتروك لإبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم… إلى نهاية المشهد الطويل. ولهذا نظائره في كثير من قصص القرآن.
فن المفاجأة وأسراره في القصة القرآنية
تنوع طريقة المفاجأة من الخصائص البارزة في فن القصة في القرآن الكريم، وهي تتخذ أشكالاً متعددة تبرز براعة الأسلوب القرآني في جذب القارئ وإثارة انتباهه. فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة، حتى يكشف لهم معاً في آن واحد. مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم في سورة الكهف، فهي تجري هكذا: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجباً! قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصاً، فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علماً. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً؟ قال: ستجدني – إن شاء الله – صابراً، ولا أعصي لك أمراً. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً. فانطلقا. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً! قال: ألم أقل: إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسراً. فانطلقا. حتى إذا لقيا غلاماً فقتله. قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً! قال: ألم أقل لك: إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذراً. فانطلقا. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجراً! قال: هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً.
فإلى هنا نحن أمام مفاجآت متوالية، لا نعلم لها سراً وموقفنا منها كموقف بطلها موسى. بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة، ولا ينبئنا القرآن باسمه، تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا. وما قيمة اسمه؟ إنما يراد به أن يمثل حكمة الغيب العليا، التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة: فعدم ذكر اسمه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها. وإن القوى المجهولة لتتحكم في القصة منذ نشأتها، فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود، فيمضي في طريقه ولكن فتاه ينسى غذاءهما عند الصخرة، وكأنما نسيه ليعودا، فيجدا هذا الرجل هناك، وكان لقاؤه يفوتهما لو سارا في وجهتهما، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى.. كل الجو غامض مجهول، وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول. ثم يأخذ السر في التجلي، فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين: فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحاً، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً. وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا. لقد يخطر للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا؟ ولكنها لن تتلقى جواباً. لقد مضى في المجهول، كما خرج من المجهول، فالقصة تمثل الحكمة الكبرى: وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار، ثم تبقى مجهولة أبداً.
ومرة يكشف السر للنظارة، ويترك أبطال القصة عنه في عماية، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر، وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين. وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية، ليشترك النظارة فيها، منذ أول لحظة حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين! وقد شاهدنا مثلاً من ذلك في قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. وبينما نحن نعلم هذا، كان أصحاب الجنة يجهلونه: فتنادوا مصبحين: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم، وهم يتنادون ويتخافتون، والجنة خاوية كالصريم، حتى انكشف لهم السر أخيراً بعد أن شبعنا تهكماً وسخراً: قالوا: إنا لضالون. بل نحن محرومون! وذلك جزاء من يحرم المساكين. فهذا لون من التناسق كذلك، يضاف إلى نظائره. ومرة يكشف بعض السر للنظارة، وهو خاف على البطل في موضع، وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر، في القصة الواحدة. مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في غمضة عين؛ وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان، على حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم. ولكن مفاجأة الصرح الممرد من قوارير ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها. ومرة لا يكون هناك سر، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد، فقد فوجئنا مع السيدة مريم العذراء بالمخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً…
التصوير الفني ورسم الشخصيات في القصص القرآني
الاعتناء بفن التصوير، ويظهر هنا واضحاً في رسم الشخصيات، فشخصية موسى تظهر هنا بصورة ذلك النبي الواثق بقضيته فهو يواجه تهديد فرعون باللجوء إلى الله تعالى، وشخصية الرجل المؤمن تبدو من خلال الحوار شخصية الرجل الحكيم الذي يتبع المنطق المعقول، مع إثارة عواطف قومه بالنداء المتكرر يا قوم.. يا قوم… وشخصية فرعون تبدو بجبروتها وكبريائها وإصرارها على الباطل، يقابل دعوة الحق بسفك الدماء، ويواجه المنطق المفحم بالحيلة والدهاء: يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب…
ويتجلى فن التصوير في فن القصة في القرآن الكريم من خلال قدرته الفائقة على رسم الشخصيات بدقة بالغة، حيث تظهر كل شخصية بملامحها النفسية والسلوكية الواضحة التي تميزها عن غيرها. وهذا الرسم الدقيق للشخصيات يجعل القارئ يعيش مع أحداث القصة ويتفاعل معها، ويستخلص منها الدروس والعبر بطريقة طبيعية دون تكلف. ويستخدم القرآن في هذا الرسم الحوار الذي يكشف عن أعماق الشخصيات، والوصف الموجز المعبر الذي يبرز أبرز ملامحها، والأفعال التي تدل على طبيعتها وتوجهاتها.
حذف الثغرات والانتقال السينمائي بين المشاهد
حذف الثغرات بين الوقائع مما لا حاجة إليه لفهم القصة بطريقة فنية عجيبة اخترق بها قصص القرآن أستار القرون ليأتي متلائماً مع العرض التمثيلي الذي نما في هذا العصر إلى أبدع أسلوب وصل إليه الأدب، فتجدنا مع قصص القرآن ننتقل من مشهد إلى مشهد كما لو كنا أمام القصة نفسها تعرض علينا صوراً فمن مشهد إرسال موسى ودعوته فرعون وتهديد فرعون موسى بالقتل، إلى مشهد مجلس خاص بين فرعون وحاشيته يبرز فيه مؤمن آل فرعون حيث يدور الحوار الذي يشغل القسم الأكبر من القصة، إلى مشهد آل فرعون، وقد حاق بهم سوء العذاب في ختام القصة.
ومن تأمل سائر قصص القرآن تبين له ما عرضناه هنا، وتذوق إعجاز أسلوب القرآن في القصة، وزاد إحساسه بذلك إذا لاحظ البون الهائل بين القصة في الأدب العربي وآداب العالم في عصر نزول القرآن وما تطور إليه فنها في العصر الحديث. فقد سبق القرآن الكريم كل هذا التطور بأكثر من أربعة عشر قرناً، واستخدم تقنيات سردية لم تعرفها البشرية إلا في العصور المتأخرة، مما يؤكد أن هذا القرآن ليس من وضع البشر، بل هو كلام الله المعجز الذي تحدى به العرب والعجم أن يأتوا بمثله فعجزوا. ويظهر هذا الإعجاز بصورة خاصة في فن القصة في القرآن الكريم الذي يجمع بين الواقعية التاريخية والبلاغة الفائقة والتأثير العميق في النفوس، مما يجعله متفرداً بين كل الآداب العالمية قديمها وحديثها.
الخاتمة
يتضح مما سبق أن فن القصة في القرآن الكريم يمثل نموذجاً فريداً في الأدب العالمي، يجمع بين الواقعية التاريخية المطلقة والأهداف الدينية السامية والإعجاز البياني المبهر. فقد تناولنا في هذه المقالة المكانة الرفيعة التي تحتلها القصة في الآداب العالمية، وكيف سبق القرآن الكريم كل الآداب بقرون طويلة في الاهتمام بهذا الفن العظيم، مستخدماً كلمات دالة معبرة مثل القصص والنبأ والأيام للإشارة إلى هذه الوقائع التاريخية العظيمة.
وقد بينا أن القصة القرآنية تتميز بكونها واقعية تاريخية خالصة، خلافاً للقصص الأدبي الذي يمزج الواقع بالخيال، وأن أهدافها تسمو على كل الأهداف الأدبية، فهي تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين نصر الله لأنبيائه وإهلاكه للكافرين، وتبث المعاني الدينية وترسخ قواعد الإيمان. كما أوضحنا أن منهج القرآن في عرض القصة يتميز بذكر الجزء المناسب للغرض فقط، واستخراج التوجيهات والعظات، والتكرار الذي يحقق أغراضاً بلاغية عميقة ويخاطب فئات مختلفة من الناس.
أما الخصائص الفنية للقصة القرآنية فقد كشفت عن سبق مذهل للقرآن الكريم في استخدام تقنيات سردية لم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث، ومنها تنوع طريقة العرض بين التلخيص المسبق والعرض المباشر والأسلوب التمثيلي، وتنوع طريقة المفاجأة بين كتم السر عن الجميع وكشفه للنظارة دون الأبطال، والاعتناء بفن التصوير ورسم الشخصيات بدقة بالغة، وحذف الثغرات والانتقال السينمائي بين المشاهد. كل هذه الخصائص تجعل فن القصة في القرآن الكريم معجزة قائمة بذاتها، تثبت أن هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه سيبقى نبراساً للبشرية في كل زمان ومكان، يهديهم إلى الحق ويرشدهم إلى طريق النجاة والفلاح.
سؤال وجواب
١. ما الفرق بين القصة في القرآن الكريم والقصة الأدبية الحديثة؟
القصة في القرآن الكريم واقعية تاريخية خالصة لا تشوبها شائبة من الخيال أو الأسطورة، بينما القصة الأدبية الحديثة تمزج بين الواقع والخيال حتى عند أشد القصاصين الواقعيين تمسكاً بالواقع. والقصة القرآنية تهدف إلى مقاصد دينية وإيمانية وأخلاقية سامية، بينما تتنوع أهداف القصة الأدبية بين الترفيه والدعاية لفكرة معينة والتأثير الأخلاقي والاجتماعي.
٢. لماذا تتكرر بعض القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم؟
ليس التكرار في القرآن تكراراً بالمعنى الحقيقي، وإنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة، حيث يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة. فقصة موسى مثلاً تذكر في مواضع مختلفة لاستنباط دروس وعبر متنوعة تتعلق بالصبر أو التوكل أو مواجهة الظلم أو غير ذلك، مما يجعل كل موضع على الحقيقة غير مكرر.
٣. ما أبرز الأهداف التي تسعى القصة القرآنية لتحقيقها؟
تسعى القصة القرآنية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: أولها إثبات إعجاز القرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن غيب الماضي البعيد، وثانيها بيان أن الله ينصر أنبياءه ورسله ويهلك الكافرين المكذبين مما يثبت قلوب المؤمنين ويزجر الضالين، وثالثها بث المعاني الدينية الواضحة وترسيخ قواعد الدين من خلال الحوار والمواعظ التي تتضمنها القصص بطريقة مشوقة ومؤثرة.
٤. كيف يستخدم القرآن الكلمات للتعبير عن القصص؟
يستخدم القرآن الكريم كلمات دالة ومعبرة للإشارة إلى القصص، منها مادة قص التي تدل لغوياً على تتبع الأثر، ومنها النبأ الذي يعني الخبر العظيم ذا الشأن والخطر، ومنها الأيام التي تشير إلى الوقائع العظيمة والحروب الهائلة. وكل هذه الكلمات تحمل دلالات عميقة تتناسب مع عظمة الأحداث والوقائع التي يرويها القرآن الكريم.
٥. ما المقصود بتصريف البيان في القصة القرآنية؟
تصريف البيان هو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوب دون أن ينال تكرار المعنى من سمو الأسلوب وإعجازه، وهو سر من أسرار الإعجاز القرآني. وحقيقة التصريف هي إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به. وبهذا التصريف المعجز حقق القرآن هدفاً عظيماً هو خطاب الناس كافة ممن تكفيه الإشارة والموجز من القول ومن لا يسد خلل فهمه إلا التفصيل.
٦. ما الطرائق المختلفة التي يستخدمها القرآن في عرض القصة؟
يستخدم القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة: الأولى ذكر ملخص للقصة يسبقها ثم عرض التفصيلات كقصة أصحاب الكهف، والثانية ذكر عاقبة القصة ومغزاها ثم سرد الأحداث من أولها كقصة يوسف، والثالثة ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة كقصة مريم، والرابعة تحويل القصة إلى أسلوب تمثيلي حواري كقصة إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة.
٧. كيف يوظف القرآن عنصر المفاجأة في القصة؟
يوظف القرآن المفاجأة بطرق متنوعة: فمرة يكتم السر عن البطل والنظارة معاً ثم يكشفه للجميع كقصة موسى والعبد الصالح، ومرة يكشف السر للنظارة ويتركه خافياً على الأبطال للسخرية من تصرفاتهم كقصة أصحاب الجنة، ومرة يكشف بعض السر ويخفي بعضه كقصة سليمان وبلقيس، ومرة تفاجئ الأحداث الجميع في آن واحد كمخاض مريم. وهذا التنوع يحقق التشويق والإثارة ويعمق الأثر النفسي.
٨. كيف يبرز فن التصوير في رسم الشخصيات القرآنية؟
يبرز فن التصوير في القصة القرآنية من خلال رسم الشخصيات بدقة بالغة تكشف عن ملامحها النفسية والسلوكية، فشخصية موسى تظهر بصورة النبي الواثق بقضيته الذي يلجأ إلى الله عند التهديد، وشخصية مؤمن آل فرعون تبدو من خلال الحوار شخصية الرجل الحكيم الذي يتبع المنطق ويثير العواطف، بينما تبدو شخصية فرعون بجبروتها وكبريائها وإصرارها على الباطل. وهذا الرسم الدقيق يجعل القارئ يعيش مع الأحداث ويستخلص العبر بطريقة طبيعية.
٩. ما المقصود بحذف الثغرات في القصة القرآنية؟
حذف الثغرات يعني عدم ذكر التفاصيل والوقائع التي لا حاجة إليها لفهم القصة وتحقيق غرضها، والانتقال مباشرة من مشهد إلى آخر كما يحدث في العرض السينمائي الحديث. فالقرآن ينتقل من مشهد إرسال موسى ودعوته فرعون إلى مشهد المجلس الخاص بين فرعون وحاشيته حيث يظهر مؤمن آل فرعون، ثم إلى مشهد هلاك آل فرعون. وهذه الطريقة الفنية سبقت العرض التمثيلي الحديث بأربعة عشر قرناً.
١٠. لماذا يُعَدُّ فن القصة في القرآن معجزة قائمة بذاتها؟
يُعَدُّ فن القصة في القرآن معجزة لأنه سبق كل الآداب العالمية في استخدام تقنيات سردية لم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث، مع المحافظة على الواقعية التاريخية المطلقة والأهداف الدينية السامية والبلاغة الفائقة. فالقرآن استخدم تنوع طرائق العرض والمفاجأة، وفن التصوير ورسم الشخصيات، والانتقال السينمائي بين المشاهد، وتصريف البيان بأساليب متعددة، وكل ذلك قبل أربعة عشر قرناً من ظهور هذه التقنيات في الأدب الحديث، مما يثبت أنه كلام الله المعجز.