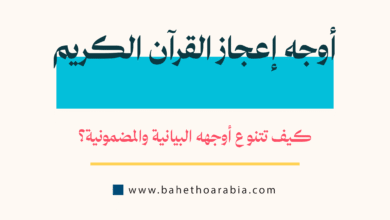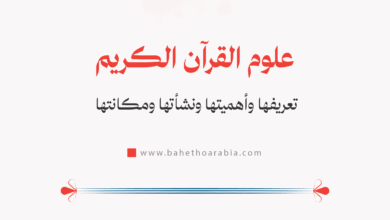قراءات القرآن وتواترها: كيف حُفظت وما ضوابط قبولها؟
هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة وما الفرق بينهما؟
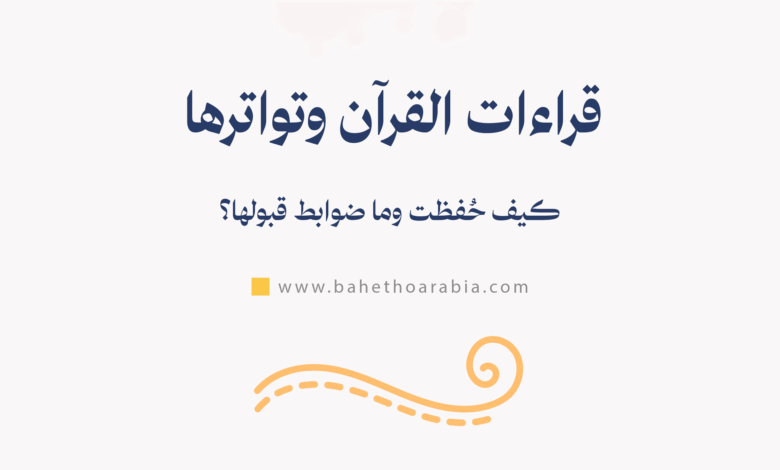
يُعد موضوع قراءات القرآن وتواترها من أهم المباحث القرآنية التي تكشف عن عظمة حفظ كتاب الله تعالى ودقة نقله عبر الأجيال. فقد حظي القرآن الكريم بعناية فائقة من الأمة الإسلامية في الحفظ والضبط والتلقي، مما جعل علم قراءات القرآن وتواترها من أدق العلوم وأوثقها سنداً.
المقدمة
تمثل قراءات القرآن وتواترها شاهداً حياً على حفظ الله تعالى لكتابه العزيز، فمنذ عصر النبوة والصحابة الكرام يتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة وأوجه مختلفة، كلها صحيحة ومتواترة. وقد نشأ عن هذا التلقي المباشر علم عظيم هو علم القراءات، الذي يُعنى بمعرفة كيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها المنقول عن الأئمة الثقات. ولم يكن هذا الاختلاف تناقضاً أو اضطراباً، بل كان رحمة وتيسيراً على الأمة، وإعجازاً يشهد بأن القرآن وحي من عند الله. ومع انتشار الإسلام في الأمصار، احتاج العلماء إلى ضبط هذه القراءات وتمييز الصحيح منها، فوضعوا لذلك ضوابط دقيقة وشروطاً محكمة، وسجلوا أسانيدها المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قراءات القرآن وتواترها من أعظم الشواهد على حفظ الكتاب العزيز.
نشأة قراءات القرآن في الأمصار
كان الصحابة خرجوا في الفتوحات قبائل، كل قبيلة بمجموعها في الجيش الإسلامي، ثم أقامت هذه القبائل حيث استقر بها المقام، وهي تقرأ القرآن على حرفها الذي تلقنته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم المعلمون للقرآن. فلما كتب عثمان بن عفان المصاحف ووجهها إلى الأمصار قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما يوافق قراءاتهم، وعلى وفق رسم المصحف الذي ضبطت به القراءات المقبولة كما سبق أن ذكرنا، فاختلفت قراءة أهل الأمصار.
وكان العلماء في كل مكان يقومون بتلقين القرآن للناس وفق تسلسل النقل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الكمال في علم ذلك وإتقانه غاية الإتقان وضبطه أدق ضبط إلى أئمة اشتهروا وأخذ الناس عنهم، باتفاق أهل عصرهم على غاية إتقانهم لتلك القراءة فنسبت إليهم القراءات ونشأ علم القراءات. وهكذا تبلورت قراءات القرآن وتواترها عبر هذا النقل المحكم والضبط الدقيق، مما جعلها في مأمن من التحريف والتبديل.
تعريف القراءة في اللغة والاصطلاح
القراءة في اللغة: مصدر لقرأ. أما في الاصطلاح فكما قال ابن الجزري: القراءات: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. أي أن هذا العلم ثابت بعزو الناقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مصدر له سوى النقل. وهذا التعريف يوضح أن قراءات القرآن وتواترها لا تقوم على الاجتهاد الشخصي أو الذوق اللغوي، وإنما تستند إلى النقل الموثق والرواية الصحيحة.
والمقرئ: العالم بالقراءات، الذي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حفظ كتاب «التيسير» في القراءات مثلاً فليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. وهذا يدل على أن علم قراءات القرآن وتواترها علم عملي تطبيقي لا يكفي فيه مجرد الحفظ النظري من الكتب، بل لا بد من التلقي المباشر والمشافهة الصوتية لضمان الدقة في الأداء.
ضوابط القراءة المقبولة وشروطها
ولما كان النقل بعزو الناقلة يختلف قوة وضعفاً بحسب حال الناقلة، فقد احتاج الأمر إلى ضابط تميز به القراءة المقبولة من غير المقبولة. وقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم وهي: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة.
ويتبين من هذا الضابط ثلاثة شروط يتوقف قبول القراءة على اجتماعها كلها، وهذه الشروط تمثل المعايير الدقيقة التي وضعها العلماء لضمان صحة قراءات القرآن وتواترها:
الشرط الأول: موافقة العربية ولو بوجه
ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، ولو كان مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله، فلا يصح مثلاً الاعتراض على قراءة حمزة «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بجر الأرحام بأنه عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وهو خلاف مذهب البصريين، لأنا نقول إن الكوفيين يجيزون مثل هذا العطف، وهكذا.
الشرط الثاني: موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالاً
وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف تحقيقاً، إذا كان مطابقاً للمكتوب، وقد يوافقه احتمالاً أو تقديراً باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة به تسمح بقراءته على أكثر من وجه. مثال ذلك «مالك يوم الدين» رسمت (ملك) بدون ألف في جميع المصاحف، فمن قرأ «ملك يوم الدين» بدون ألف فهو موافق للرسم تحقيقاً، ومن قرأ «مالك» فهو موافق تقديراً، لحذف هذه الألف من الخط اختصاراً.
الشرط الثالث: صحة السند
وهو أن يروي القراءة عدل ضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. ويشترط في هذه القراءة أن تنال ثقة أئمة القراء الضابطين، بحيث تكون مشهورة لديهم متلقاة بالقبول عندهم. وهذا الشرط هو الأساس الذي تقوم عليه قراءات القرآن وتواترها، إذ يضمن اتصال السند الصحيح إلى المصدر الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
القراءات المتواترة وأئمتها المشهورون
لقد عنيت الأمة الإسلامية بكتاب ربها أكبر عناية، فحفظته عن ظهر قلب ولازمت قراءته آناء الليل وأطراف النهار، فكثر قراء القرآن بكل قراءة، وكان لكل بيئة قراءتها التي تقرأ بها. وتصدر لتعليم القرآن خيار الأمة علماً وعملاً، وعقلاً وورعاً، فكان في الصحابة حفاظ لا يحصيهم العدد ولا يحيط بهم الاستقصاء، وكذلك في كل جيل وقبيل من أمم المسلمين عرباً وعجماً.
ومن الضروري والطبيعي أن يشتهر في كل عصر جماعة من القراء، في كل طبقة من طبقات الأمة، يتفوقون في حفظ القرآن وإتقان ضبط أدائه، والتصدي والتفرغ لتعليمه، من عصر الصحابة، ثم التابعين، وأتباعهم، وهكذا، وكان من القراء من بلغ الذروة في الإتقان والضبط، كما كان ثمة قراء دونهم، وآخرون ليسوا من أهل الإتقان، فقام العلماء بتمحيص هذه القراءات ودراسة أحوالها، وبينوا للناس المتواتر منها. وهكذا تميزت قراءات القرآن وتواترها من غيرها بفضل جهود العلماء المخلصين.
أئمة القراءات في الأمصار الإسلامية
واعتباراً من عصر التابعين انتشرت القراءات كثيراً فشعرت طائفة من أهل العلم بضرورة الاحتياط للقرآن وقراءاته، فنهض كل إمام بضبط القراءة عن الأئمة المقرئين وهكذا في العصور التالية، ثم أودعت تلك القراءات في مؤلفات خاصة، كما فعله أبو عبيد، ثم الطبري ومن جاء بعد. قال الإمام ابن الجزري في كتابه: (النشر في القراءات العشر): تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم، أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول، ولم يختلف فيها اثنان، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم. وهذا يؤكد أن قراءات القرآن وتواترها لم تنسب إلى هؤلاء الأئمة لأنهم أنشأوها، بل لأنهم تصدروا لتعليمها وضبطها ونقلها.
وقد توزع هؤلاء الأئمة في مختلف الأمصار الإسلامية، فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. وكان بمكة عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن محيصن. وكان بالكوفة يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النجود الأسدي، وسليمان الأعمش، ثم حمزة بن حبيب، ثم الكسائي علي بن حمزة. وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي. وكان بالشام عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي.
القراءات السبع المشهورة واختيار ابن مجاهد
ثم جاء الإمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى سنة ٣٢٤، فأفرد القراءات السبع المعروفة، فدونها في كتابه «القراءات السبع»، فاحتلت مكانتها في التدوين وأصبح علمها مفرداً يقصده طلاب القراءات. وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جداً، فلم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة الإقراء، مع الاتفاق على الأخذ منه، والتلقي عنه. وبذلك أصبحت القراءات السبع معلماً بارزاً في تاريخ قراءات القرآن وتواترها.
فكان له من ذلك قراءات هؤلاء السبعة، وهم:
١ – عبد الله بن كثير الداري المكي المتوفى سنة ١٢٠ هـ
٢ – عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي المتوفى سنة ١١٨ هـ
٣ – عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي المتوفى سنة ١٢٧ هـ
٤ – أبو عمرو زبان بن العلاء البصري، المتوفى سنة ١٥٤ هـ
٥ – حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة ١٥٦ هـ
٦ – نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة ١٦٩ هـ
٧ – أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي المتوفى سنة ١٨٩هـ
وقد كانت هذه القراءات مشتهرة يقرأ بها أهل أمصار كل واحد من هؤلاء الأئمة، فجاء الإمام ابن مجاهد وأفردها بهذا التأليف، غير أن الشهرة كانت للإمام «يعقوب الحضرمي» فجعل مكانه الكسائي، وذلك لما جرى عليه واشترطه في الاختيار من الشروط التي عرفناها، لذلك كان عمله هذا أبعد أعمال أئمة القراءات أثراً وأوسعها شهرة، وأبقاها على الزمان، واشتهر اختياره هذا حتى صارت القراءات السبع التي اختارها علماً في فن القراءة، وعناوين لكتب عدة، ومنظومات شتى مشهورة، هي إلى الآن المراجع التي تستظهر وتشرح وتدرس في حلقات الإقراء.
إتمام القراءات العشر المتواترة
وقد علمت من مسرد أئمة الأمصار الإسلامية القراء أن القراءات أكثر من ذلك بكثير، لكن ابن مجاهد انتقى جمع هذه السبع لشروطه التي راعاها، وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة، حتى استقر الاعتماد العلمي واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى السبع فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات. وبذلك اكتملت منظومة قراءات القرآن وتواترها في صورتها النهائية المعتمدة عند العلماء.
وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة:
٨ – أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة ١٣٠ هـ
٩ – يعقوب بن إسحاق الحضرمي الكوفي المتوفى سنة ٢٠٥ هـ
١٠ – خلف بن هشام المتوفى سنة ٢٢٩ هـ
التفريق بين القراءات السبع والأحرف السبعة
هذا وقد أصبح من الجلي الواضح بعد هذه الدراسة أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، والخلط بينهما خطأ عظيم ناشئ من مجرد اتفاق العدد، وعدم المعرفة بجلية الأمر. فإن هذه القراءات إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع، على يد الإمام المقرئ ابن مجاهد كما عرفنا، فلو كانت الأحرف السبعة هي القراءات السبع لكان معنى ذلك أن يتوقف تحقيق مضمون أحاديث الأحرف السبعة والعمل بها حتى يأتي ابن مجاهد في القرن الرابع. وهذا التوضيح ضروري لفهم حقيقة قراءات القرآن وتواترها وعلاقتها بالأحرف السبعة.
وقد كثر تنبيه العلماء على التفريق بين القراءات السبع والأحرف السبعة والتحذير من الخلط بينها، نذكر منها هذه الكلمة لأبي شامة المقدسي: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. فالأحرف السبعة أوسع وأشمل من القراءات السبع، وقد نزل بها القرآن تيسيراً على الأمة في عصر النبوة، بينما القراءات السبع هي اختيار علمي قام به ابن مجاهد لأدق وأشهر القراءات المتواترة.
إثبات تواتر القراءات العشر بالأدلة القاطعة
اتفق العلماء المحققون على أن هذه القراءات العشر هي قراءات متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قد أثبتوا تواترها بذكر طبقات رواتها. لكن بعض أهل العلم خالفوا هذا التحقيق، وتوهموا أن هذه القراءات متواترة إلى الأئمة الذين قرؤوا بها وأخذت عنهم. واستند صاحب هذا الرأي إلى أنه لا بد في التواتر أن يكون بنقل جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب وأن يستمر ذلك في كل جيل إلى النهاية، وهذا متحقق في القراءات إلى هؤلاء الأئمة، لكنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها، كما قال أبو شامة، ووافقه على ذلك الزركشي في البرهان.
وهذا زعم مخالف للواقع ولما كانت عليه حقيقة تواتر القراءات بين الأمة الإسلامية، منشؤه الاغترار بنسبة القراءة للإمام الذي نسبت إليه، لكن الدلائل القاطعة أثبتت تواتر هذه القراءات كما أثبته أهل الاختصاص بعلمها، وذلك بالأدلة القاطعة، ومنها:
١ – أن نسبة القراءة للإمام كقولنا (قراءة حفص)، أو «قراءة حمزة» إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً، وإلا فكل أهل بلده كانوا يقرؤونها أخذوها أمماً عن أمم. كما سبق أن أوضحناه من كيفية انتقال القبائل العربية في الفتوحات. فالقراءة لم تكن خاصة بإمام واحد، بل كانت منتشرة في المصر الذي ينتمي إليه، وهذا يؤكد تواتر قراءات القرآن وتواترها من جميع الجوانب.
٢ – ما سبق أن ذكرناه في ضابط القراءة المقبولة من اشتراط كونها مشهورة، لذلك نصوا على أنه: لو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
٣ – أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم، إنما القضية هي القراءة، ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد، كما قال إبراهيم النخعي «كانوا يكرهون أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان»، قال ابن الجزري: «وذلك خوفاً مما توهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نسبت إلى شخص فتكون أحادية، ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم».
شبهات المستشرقين حول القراءات والرد عليها
دأب بعض المستشرقين على محاولة التشكيك بالقرآن العظيم وتشويش أذهان الناس، ولما أن القرآن محوط بأعظم أنواع الحفظ والصيانة في نقله وأدائه بالسطور والصدور، كان سبيل هذه الشبهات هو المغالطة وتجاهل الحقائق الثابتة، وكذلك فعل المستشرق جولد تسيهر في موضوع القراءات. قال جولد تسيهر: وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة تبعاً لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط، بل كذلك في حال تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وهذا إلى اختلاف دلالتها، وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط أو اختلاف الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً، أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه. وهذه الشبهة تحاول تقويض أساس قراءات القرآن وتواترها بادعاء أنها نشأت من اجتهادات فردية لا من تلقٍ نبوي.
هكذا يحاول هذا المستشرق نسبة القراءات إلى تصرف فردي واختيار شخصي مصادماً الوقائع الثابتة والحقائق القطعية ونكتفي منها بما يلي:
١ – أن أحداً لم يقبل القرآن إلا موافقاً للمتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا الأحاديث واختلافات الصحابة لكون أحدهم سمع قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان من شرط القراءة المقبولة التلقي بواسطة سلسلة الأسانيد.
٢ – لو كان ثمة تسامح في القراءة وفق رسم المصحف من غير توقيف على التلقي لوجب أن يكون عدد القراءات كثيراً كثرة تبلغ أضعافاً هائلة بالنسبة للقراءات الثابتة التي دققها العلماء وحققوا صحة سندها وتواترها، وقد اعترف جولد تسيهر نفسه بقراءات يسمح بها الخط، لكنها اعتبرت عند العلماء منكرة. مثل قراءة «تستكثرون» في قوله تعالى: «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون». ومثل قراءة حماد الراوية (أباه) عوضاً عن «إياه» في قوله تعالى: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه». ولو كان مجرد موافقة الخط كافياً لاعتمدت هذه القراءات، وحسبنا هذا دليلاً على أن مجرد موافقة الخط لم يكن هو العمدة في صحة القراءة.
٣ – إن فذلكة تسيهر للموضوع جرت على قلب القضية من أساسها، وذلك أنه ليس هناك أي اختلاف في أن تجريد المصاحف العثمانية من الشكل والنقط كان بقصد استيعاب الأحرف المروية الثابتة من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، لكن هذا الزاعم قلب القضية وجعل هذا الرسم للمصحف سبباً لظهور القراءات فيما بعد بزعمه الباطل. وهذا يؤكد أن قراءات القرآن وتواترها محفوظة بالتلقي والسماع، وأن الرسم جاء تابعاً لها لا أصلاً منشئاً.
القراءات الشاذة وحكمها
تعريف القراءة الشاذة هي كل قراءة لم يتوفر فيها شرط واحد من شروط القراءة الصحيحة التي سبقت في ضابط القراءة الصحيحة. وهذا الإطلاق للشذوذ قديم، وكان الأصل فيه إطلاق الشذوذ على ما خالف رسم المصحف، واستوفى سائر الشروط. ويطلق على القراءة التي استوفت الشروط إلا أن سندها ضعيف: (رواية ضعيفة)، كما أطلقوا عليها وصف: (الشذوذ) أيضاً على سبيل التوسع. وبهذا تتميز قراءات القرآن وتواترها الصحيحة عن القراءات الشاذة التي لا يجوز الاعتماد عليها في القراءة.
أما إذا لم يوجد للقراءة سند فإنها تكون رواية مكذوبة مختلقة، يكفر متعمدها حتى لو وافقت المعنى ورسم المصحف. أما حكم القراءة الشاذة فيتلخص بما يلي: يحرم القراءة بها، ولا تجوز الصلاة بها، لأنها ليست قرآناً، ويعاقب القارئ بها ويستتاب. أما الاحتجاج بها في اللغة، فالراجح قبولها، لأنها لا تقل عن كثير من شواهد النحويين واللغويين. فالقراءة الشاذة وإن لم تكن من القرآن المتواتر، إلا أنها قد تحمل قيمة لغوية وعلمية تفيد في فهم بعض الجوانب اللغوية، لكنها لا ترقى إلى مستوى قراءات القرآن وتواترها الصحيحة.
أهمية القراءات وفوائدها المتعددة
إن الأحرف السبعة والقراءات ظاهرة هامة جاء بها القرآن الكريم من نواحٍ لغوية وعلمية متعددة نوجز طائفة منها فيما يلي:
١ – التيسير على العرب الذين شوفهوا بالقرآن
فقد كانت حياتهم على النمط القبلي، الذي يقوم على التعصب لكل ما يتصل بالقبيلة، وقد ألف كل منهم لسان قبيلته، مما يحرج المتعلم التحول عنه فكيف بالأميين الغارقين في الجهالة والتعصب، كما سبق أن ذكرنا. ونضيف هنا التذكير بتسهيل حفظ القرآن عليهم كذلك، وتسهيل قراءته على المسلمين كلهم، حيث قد يجد بعضهم سهولة في بعض القراءات أكثر من غيرها. وهذه من أعظم فوائد قراءات القرآن وتواترها على المسلمين في كل العصور.
٢ – إثراء اللغة العربية
أ – إن القرآن لما شاع وذاع في أرجاء الجزيرة العربية بأحرفه، فقد جمع العرب على قدر مشترك كبير تنطق به كافة القبائل، وأمات اللهجات واللغات المستبعدة عن الفصاحة، أو المختلطة بشيء من العجمة، وأبقى للعرب الفصيح من لغاتها، تقرأ بها آناء الليل وأطراف النهار، وتؤثر التكلم به على غيره، فحصلت الأمة بذلك على عنصر من مقومات وحدتها وهو وحدة اللغة، إذ خفت حدة خلافات اللهجات واللغات، وآذنت تلك اللهجات البعيدة عن الفصاحة بالزوال.
ب – عني العلماء منذ عهود السلف الأولى بعلم القراءات، فصنفوا فيه كتباً كثيرة غزيرة، ولا تزال التآليف تتوالى حتى عصرنا هذا. وقد وجدوا في القراءات ينبوعاً جديداً لدراسات لغوية متنوعة، فمن دارس لها يبين موقعها اللغوي مثل كتاب «الحجة» لأبي زرعة الدمشقي، والكتاب الحافل الضخم «الحجة في القراءات» لأبي علي الفارسي، ومن دارس يوازنها باللهجات مثل كتاب: «القراءات واللهجات» لأبي علي الفارسي أيضاً. وفي عصرنا الحديث تبدأ محاولة دراسة القراءات في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، لكونها الوثيقة اليقينية الثبوت اللغوية التي تحمل خصائص اللغة العربية، فهي سجل لظواهر النطق الحية، كما أنها تحافظ على الثابت الموروث من سجايا اللسان العربي في لغته الفصحى ولهجاتها. ويظهر في هذا المجال دور القراءات الشاذة كتراث غني بمادة واسعة للدراسة اللغوية، يسهم بحظ وافر بجلاء تاريخ لغتنا العربية. وكل هذا يؤكد الأهمية العظمى لقراءات القرآن وتواترها في الحفاظ على اللغة العربية وإثرائها.
فالقرآن الكريم كتاب هداية يحمل دعوتها إلى العالم، وهو كتاب إعجاز يتحدى ببيانه هذا العالم، مبرهناً بمعجزة بيانه عن حقيقة دعوته، ونزول القرآن بهذه الأحرف والقراءات تأكيد لهذا الاتحان، والبرهان على أنه وحي السماء لهداية أهل الأرض. ومن أوجه هذه الدلالة:
أ) أن هذه الأحرف والقراءات العديدة يؤيد بعضها بعضاً من غير تناقض في المعاني والدلائل، ولا تنافٍ في الأحكام والأوامر، فلا يخفى ما في إنزال القرآن على سبعة أحرف من عظيم البرهان وواضح الدلالة، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف – في الأداء – وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض، ولا تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضاً، ويبين بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آية بالغة، وبرهان قاطع على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم.
ب) أن نظم القرآن المعجز، والبالغ من الدقة غايتها في اختيار مفرداته وتتابع سردها، وجمله وإحكام ترابطها، وتناغمه الموسيقي المعبر يجري عليه كل ما عرفنا من الأوجه السابقة في الأحرف والقراءات ثم يبقى حيث هو في سماء الإعجاز، لا يمثل بأفواه قارئيه، ولا يختل بآذان سامعيه، منزهاً عن أن يطرأ على كلامه الضعف أو الركاكة، أو أن يعرض لإيقاعه خلل أو نشاز، ودونك القراءات المتواترة، وازن بينها وبين أي كلمة يدخلها أحد على نص القرآن، ودونك أساليب البلغاء وكبار الأدباء، هل تجد في شيء منها ما يمكن أن يجرى عليه مثل هذه التغييرات في الأحرف السبعة ثم يظل الأسلوب في مستواه الذي وضعه عليه صاحبه أو أراد له أن يكون، فكيف بهذا الأسلوب القرآني المعجز. وهذا من أعظم الأدلة على صدق قراءات القرآن وتواترها وكونها وحياً من عند الله تعالى.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وتبارك الذي نزل في محكم كتابه: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً».
الخاتمة
وبعد هذه الجولة العلمية في موضوع قراءات القرآن وتواترها، يتبين لنا عظمة الجهود التي بذلها علماء الأمة في حفظ كتاب الله تعالى وضبط قراءاته وتمييز صحيحها من شاذها. فقد وضع العلماء شروطاً دقيقة للقراءة المقبولة، وسجلوا أسانيدها المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وميزوا القراءات المتواترة من غيرها، فكانت القراءات العشر هي المتواترة المعتمدة. ولم تكن القراءات السبع المشهورة هي الأحرف السبعة التي وردت في الأحاديث النبوية، بل هي اختيار علمي قام به الإمام ابن مجاهد لأشهر القراءات وأضبطها.
وقد ظهرت أهمية قراءات القرآن وتواترها في جوانب متعددة، منها التيسير على الأمة في حفظ القرآن وتلاوته، وإثراء اللغة العربية بما حفظته من لهجات فصيحة وأساليب بليغة، والبرهان على إعجاز القرآن وكونه وحياً من عند الله تعالى. فالقراءات المتعددة رغم اختلافها لم يتطرق إليها تناقض أو تضاد، بل يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض، وكلها تحافظ على الإعجاز البياني والتناسق الموسيقي للقرآن الكريم. وهكذا تبقى قراءات القرآن وتواترها شاهداً حياً على حفظ الله تعالى لكتابه، وعلى دقة المنهج العلمي الذي اتبعه علماء الأمة في خدمة القرآن الكريم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
سؤال وجواب
١. ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟
الأحرف السبعة هي الأوجه التي نزل بها القرآن الكريم في عصر النبوة تيسيراً على القبائل العربية المختلفة في لهجاتها، وقد وردت في أحاديث نبوية صحيحة. أما القراءات السبع فهي اختيار علمي قام به الإمام ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري لسبع قراءات متواترة من بين القراءات الكثيرة المنتشرة في الأمصار الإسلامية، بناء على شروط دقيقة في الضبط والإتقان والشهرة. والخلط بينهما خطأ شائع ناشئ من اتفاق العدد فقط، فالأحرف السبعة أوسع وأشمل من القراءات السبع، ولو كانا شيئاً واحداً لتوقف العمل بأحاديث الأحرف السبعة حتى مجيء ابن مجاهد، وهذا باطل قطعاً.
٢. ما هي الشروط الثلاثة لقبول القراءة؟
وضع علماء القراءات ثلاثة شروط يجب توفرها مجتمعة لقبول أي قراءة قرآنية، وهي: أولاً موافقة العربية ولو بوجه من وجوه النحو حتى لو كان مختلفاً فيه بين النحويين اختلافاً لا يضر، وثانياً موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً أو تقديراً لأن الرسم العثماني له خصائص تسمح بقراءته على أوجه متعددة، وثالثاً صحة السند بأن تروى القراءة بسلسلة متصلة من الرواة الثقات الضابطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها مشهورة متلقاة بالقبول عند أئمة القراء. وإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الثلاثة فالقراءة شاذة غير مقبولة.
٣. كم عدد القراءات المتواترة وما هي؟
القراءات المتواترة عشر قراءات، سبع منها اشتهرت باسم القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد وهي قراءات: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبي عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم الكوفي، وحمزة الكوفي، والكسائي الكوفي. ثم أضيف إليها ثلاث قراءات أخرى متواترة فأصبح المجموع عشراً، وهذه الثلاث هي قراءات: أبي جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي البصري، وخلف بن هشام. وقد استقر الاعتماد العلمي على هذه القراءات العشر باعتبارها المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة متصلة.
٤. ما معنى التواتر في القراءات القرآنية؟
التواتر في القراءات يعني نقل جمع كثير من القراء لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم في كل طبقة من طبقات السند حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل عقلاً اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. وقد ثبت تواتر القراءات العشر بأدلة قاطعة منها أن القراءة المنسوبة لإمام ما كان يقرأ بها جميع أهل مصره وليس هو وحده، وأن من شروط قبول القراءة أن تكون مشهورة متلقاة بالقبول، ولو انفرد بها واحد لرفضت. والتواتر يفيد العلم اليقيني بصحة القراءة وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٥. لماذا نسبت القراءات إلى أئمة معينين؟
نسبة القراءات إلى أئمة معينين كقولنا قراءة نافع أو قراءة عاصم هي نسبة اصطلاحية وليست حقيقية، فهؤلاء الأئمة لم يخترعوا هذه القراءات ولم يبتدعوها، وإنما كانت منتشرة في أمصارهم يقرأ بها جميع أهل المصر أمماً عن أمم متلقين لها من الصحابة والتابعين. ولكن لما تصدى هؤلاء الأئمة لضبط القراءة وإتقانها والتفرغ لتعليمها، واشتهروا بغاية الإتقان والأمانة، وأجمع أهل عصرهم على الأخذ عنهم، نسبت القراءة إليهم تمييزاً وتيسيراً. ولذلك كره بعض السلف نسبة القراءة إلى الأشخاص خوفاً من توهم أنها اجتهاد شخصي، بينما الحقيقة أنها متواترة من قبلهم.
٦. ما هي القراءة الشاذة وما حكمها؟
القراءة الشاذة هي كل قراءة لم يتوفر فيها شرط واحد أو أكثر من شروط القراءة الصحيحة الثلاثة، سواء خالفت رسم المصحف أو خالفت وجهاً من أوجه العربية أو ضعف سندها أو لم تكن مشهورة متلقاة بالقبول. وحكم القراءة الشاذة أنها ليست قرآناً فيحرم القراءة بها ولا تجوز الصلاة بها، ويعاقب من يقرأ بها ويستتاب، فإن كانت مختلقة بلا سند كفر متعمدها. أما الاحتجاج بالقراءات الشاذة في اللغة العربية فجائز عند الراجح من أقوال العلماء لأنها لا تقل عن شواهد النحويين واللغويين، ولها قيمة علمية في الدراسات اللغوية.
٧. كيف رد العلماء على شبهات المستشرقين حول القراءات؟
زعم بعض المستشرقين أن القراءات نشأت من اجتهادات فردية بسبب خلو المصاحف من النقط والشكل، ورد العلماء على هذا بأدلة قاطعة منها: أن الصحابة لم يقبلوا أي قراءة إلا بالتلقي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتنازعون عند سماع قراءة لم يسمعوها منه، وأن من شروط القراءة المقبولة صحة السند المتصل، ولو كان مجرد موافقة الرسم كافياً لوجدنا آلاف القراءات المحتملة لكن العلماء رفضوا كل ما لم يثبت بالتلقي حتى لو وافق الرسم، وأن تجريد المصاحف من النقط كان لاستيعاب القراءات الثابتة المروية مسبقاً وليس العكس. وهذا يثبت أن القراءات توقيفية لا اجتهادية.
٨. ما الفوائد المترتبة على تعدد القراءات؟
لتعدد القراءات القرآنية فوائد عظيمة متنوعة، منها التيسير على الأمة في حفظ القرآن وقراءته حيث يجد كل مسلم سهولة في بعض القراءات أكثر من غيرها، وإثراء اللغة العربية بجمع الفصيح من لهجات القبائل العربية وتوحيد اللغة وإماتة اللهجات الضعيفة والمختلطة بالعجمة، وفتح مجالات واسعة للدراسات اللغوية والنحوية التي ألفت فيها مئات الكتب قديماً وحديثاً، والبرهان على إعجاز القرآن وأنه وحي من عند الله إذ رغم تعدد القراءات لم يحدث أي تناقض في المعاني أو الأحكام، وبقاء النظم القرآني في قمة الإعجاز البياني مع كل الأوجه القرائية المختلفة.
٩. هل يجوز لأي شخص أن يقرئ القرآن بالقراءات دون إجازة؟
لا يجوز لأحد أن يقرئ القرآن بالقراءات المختلفة إلا إذا تلقاها مشافهة بالسند المتصل عن شيوخ مجازين، فالمقرئ هو العالم بالقراءات الذي رواها بالتلقي المباشر عن أهلها حتى يبلغ سنده النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حفظ إنسان كتب القراءات نظرياً فليس له أن يقرئ بها ما لم يأخذها بالمشافهة عمن شوفه بها مسلسلاً، لأن في القراءات دقائق صوتية وأحكاماً أدائية لا تحكم إلا بالسماع المباشر والمشافهة الحية. وهذا من دقة حفظ القرآن وضمان عدم التحريف في النطق والأداء، فعلم القراءات علم عملي سماعي لا يكفي فيه التحصيل النظري من الكتب.
١٠. ما علاقة رسم المصحف العثماني بتعدد القراءات؟
رسم المصحف العثماني جاء محتملاً لوجوه القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عثمان بن عفان بكتابة المصاحف مجردة من النقط والشكل بقصد استيعاب الأحرف والقراءات المروية، فيقرأ كل مصر مصحفه على ما يوافق قراءته المتلقاة مع موافقة الرسم. فالرسم العثماني له خصائص تسمح بقراءته على أوجه متعددة، مثل حذف بعض الألفات التي تحتمل الإثبات والحذف في النطق، فكلمة ملك تقرأ ملك ومالك. وليس معنى هذا أن الرسم أنشأ القراءات، بل القراءات كانت موجودة أولاً والرسم جاء ليستوعبها، ولذلك من شروط القراءة الصحيحة موافقة الرسم مع صحة السند.