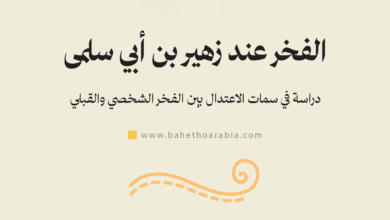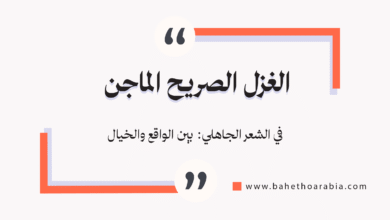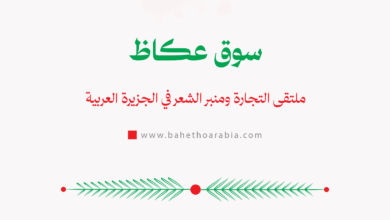الحكمة عند زهير بن أبي سلمى: من مصادرها إلى أسس القضاء وخلاصة معلقته
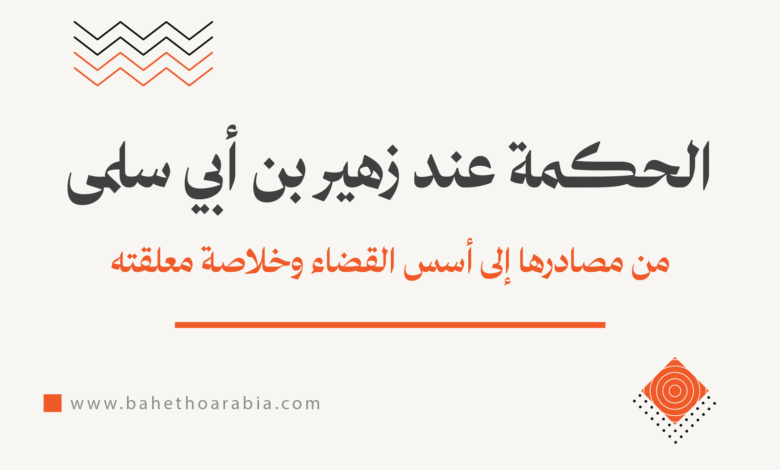
في خضم الصحراء الشاسعة للشعر الجاهلي، حيث تتعالى أصوات الفخر والحماسة والنزاعات القبلية، تبرز واحة هادئة من التأمل والاتزان، تتجسد في أشعار الشاعر الحكيم زهير بن أبي سلمى. إن السمة الأبرز التي خلدت اسمه عبر العصور هي الحكمة عند زهير بن أبي سلمى؛ فهي ليست مجرد أقوال مأثورة أو أمثال عابرة، بل هي منظومة أخلاقية متكاملة ونتاج تجربة حياتية عميقة. يستهدف هذا المقال الغوص في أعماق هذه الظاهرة الفريدة، مستكشفاً المصادر التي نهلت منها الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، ومحللاً أبعادها التي تشمل الحلم والتسامح والحذر والصدق، وصولاً إلى تجلياتها كدستور اجتماعي وقضائي يهدف إلى بناء ضمير إنساني في زمنٍ كان السيف فيه هو الحكم.
مصادر الحكمة عند زهير بن أبي سلمى
يصوغ الشاعر الحكمة عند زهير بن أبي سلمى إما من فلسفة يقوده إليها تأمله في الكون والحياة، وإما من ثقافة يثقفها ممن سبقوه وعايشوه، وإما من تجارب يمر بها وأحداث تؤثر فيه تأثيراً ينطقه بما يميزه من أبناء عصره، لأنه يملك من البيان مالا يملكون.
أما الفلسفة فالعصر الجاهلي كلّه لا شعر زهير، وحده، كاد يخلو منها، والنظرات التي تلقاها لدى زهير وأمثاله لا ترقى إلى أفق الفلسفة. وأمّا الثقافة فلم تكن لزهير ثقافة فكرية يمتاز بها من القوم الذين كان يعيش بين ظهرانيهم. وأما التجارب والظروف، والطباع فإنها أغزر المنابع التي نبعت منها الحكمة عند زهير بن أبي سلمى. فقد يكون لاغتراب الشاعر ونشأته في غير أهله أثر في ميله إلى الوقار والمداراة والمصانعة ومجانبة التهور. فإذا هو يدعو إلى الأناة وتحكيم العقل، ويحرّض الناس على الإحسان، والتزام الفضيلة وحماية اللسان من البذاءة والفحش:
ومَنْ لا يصانِعُ في أمور كثيرة *** يُضَرَسٌ بأنياب ويُوطاً بِمَنْسِم
(حيث إن “يصانع” تعني يجامل ويداري، و”يضرس” تعني يؤذى، و”المنسم” هو طرف خف البعير).
ومَنْ يجعل المعروف مِنْ دُونِ عِرْضِهِ *** يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشَّيْمَ يُشْتَم
(حيث إن “يفره” تعني يصنه).
الحلم والتسامح كجزء من الحكمة عند زهير بن أبي سلمى
قد يكون الحلم، وهو من ركائز الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، فطرة فطر عليها زهير وطبعاً أصيلاً فيه لم يكتسبه من غربة أو تجربة، فقد حدثنا تاريخ العصر الجاهلي عن عدد غير يسير من شعراء فارقوا قبائلهم فنزعوا إلى الصعلكة لا إلى الحكمة. ولو لم يكن في زهير نزوع إلى الخير لما مضى يتغنى بالحلم ويقدر العقل حق قدره ويسفّه جهالة السفهاء، وهذا الموقف يعكس عمق الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، فيقول:
إِذا أَنْتَ لَمْ تُقْصِر عن الجَهْلِ والخنا *** أَصَبْتَ حَلِيماً أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ
(حيث إن “تقصر” تعني تكف، و”الخنا” هو الفحش في الكلام، وينسب هذا البيت أيضاً إلى أوس بن حجر).
كما تهديه الحكمة عند زهير بن أبي سلمى إلى أن التسامح خير من الملاحاة والخصومة، لأن العتاب قد يؤدي إلى تنافر القلوب، أما الإغضاء عن الذنب فقد يدفع المذنب الكريم إلى الندم والتوبة. وتمييز الكرام من اللئام لا يحتاج إلى ترجمان أو برهان، وحسب الذكي أن ينظر في وجوه الناس ليحكم على صديق بالصدق وسلامة الطوية، وعلى آخر بالملق والرياء:
فلا تُكْشِرْ عَلَى ذِي الضَّغَنِ عَتْباً *** ولا ذِكْر التَّجَرُمِ لِلذُّنوبِ
(حيث إن “التجرم” هو الاتهام بالجرم).
وَلا تَسْأَلْهُ عَمَّا سَوْفَ يُبْدِي *** وَلا عَنْ عَيْبِهِ لكَ بالمغيبِ
مَتَى تَكُ في صَدِيقٍ أَوْ عَدُوٍّ *** تُخَبِّرْكَ الوُجُوهُ عَنِ القُلوبِ
الحذر والصدق في منظومة الحكمة عند زهير بن أبي سلمى
لقد أكسبت التجارب الحكمة عند زهير بن أبي سلمى بعد النظر، وألهمته الإحجام عن مضغ الأعراض بألسنة السوء ليصون عرضه من السوء، وجعلته شديد الحذر، لا يخطو خطوة إلا على هدى وبصيرة، فعاش في نجوة من العثار والمزالق:
أبيتُ فلا أَهْجُو الصَّدِيقَ وَمَنْ يَبعُ *** بِعِرْضِ أَبِيهِ في المَعاشِرِ يُنْفِقِ
(حيث إن “من يبع” تعني من يشتر، و”المعاشر” هي الجماعات).
وَمَنْ لا يُقَدِّمْ رِجْلَهُ مُطْمَئِنَّةً *** فَيُثْبِتَها في مُسْتَوَى الأَرْضِ تَزْلَقِ
(حيث إن “تزلق” تعني تزل ولا تثبت).
والحليم السمح لا يخشى الوقوع في الأذى، ولا يتقي الشر بالكذب، لأن الكذب درع الجبان، وهو ما ترفضه تمامًا الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، وسلاح الخائف في مجابهة الحقائق. فالصدق ركن أساسي في منظومة الحكمة عند زهير بن أبي سلمى:
وفي الحِلْمِ إِدْهَانٌ وفي العَفْوِ دُرْبَةٌ *** وفي الصِّدْقِ مَنْجَاةٌ مِنَ الشَّرِّ فَاصْدُقِ
(حيث إن “الإدهان” يعني المصانعة، و”الدربة” تعني العادة واللجاجة).
الحكمة عند زهير بن أبي سلمى في السياق القبلي
ولم تكن الحكمة عند زهير بن أبي سلمى سبحات تحمله إلى أفق مثالي لا يدرك، وإنما كانت مستمدة من الواقع القبلي، داعية إلى التكافل وبذل المعروف للقريب قبل الغريب:
وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ *** عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ
وربما التقى زهير في هذا الرأي الداعين إلى ارتباط الفرد بالقبيلة، لكنهم دعوا إلى نصرة القبيلة وهم يتميزون غيظاً وغضباً على أعدائها، وهنا تتجلى خصوصية الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، حيث دعا إليها بدافع الحب الذي يمحو العصبية والحمية ويؤثر السلام. على أن موقفه هذا لا يعني الضعف والجبن، ففي الحكمة عند زهير بن أبي سلمى تمجيد للقوة، ودعوة إلى الحفاظ على الشرف، ورفض للخنوع، شأنه في ذلك شأن كل عربي يحمي الذمار ويستعذب الموت الذي لا مفر منه:
ومَنْ لا يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ *** يُهَدَّمْ، ومَنْ لا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ
(حيث إن “حوضه” يعني قومه).
ومَنْ هابَ أَسْبابَ المَنايا يَنَلْنَهُ *** وَلَوْ نالَ أَسْبابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ
(حيث إن “أسباب السماء” تعني أبوابها).
نظرة الموت والخلود في إطار الحكمة عند زهير بن أبي سلمى
ولا تخلو نظرة زهير إلى الموت، وهي جزء من الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، من عفوية وسطحية، فالموت – عنده – نهاية الحياة المحتومة، والبقاء مستحيل، فإن امتنع خلود الجسد فخلود الذكر ممكن:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّاسَ يُخْلِدُ بَعْدَهُمْ *** أَحاديثُهُمْ، والمَرْءُ لَيسَ بِخالِدِ
وأبقى من هذا الخلود حياة البشر في العالم الآخر، فقد آمن زهير بأن الموت سبيل إلى هذه الحياة، وهذا الإيمان بالحساب بعد الموت يرتقي بمفهوم الحكمة عند زهير بن أبي سلمى. ولهذا نصح للناس بالصدق والإخلاص لله المطلع على السرائر، عالم الغيب والشهادة، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحاسبهم حساباً عادلاً دقيقاً، لا يغفل ثواب محسن ولا عقاب مسيء:
فَلا تَكْتُمُنَّ اللهَ ما في قُلوبِكُمْ *** لِيَخْفَى، ومَهْما يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ
يُؤَخَّرْ، فَيُوضَعْ في كِتابٍ، فَيُدَّخَرْ *** لِيَوْمِ الحِسابِ، أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ
وفي هذه الفكرة ما يؤكد عمق الحكمة عند زهير بن أبي سلمى ويظهره – إذا قيس بشعراء عصره – ثاقب الرأي ناضج الفكر، صادق الحس.
أسس القضاء والعدالة في تجليات الحكمة عند زهير بن أبي سلمى
ومن تجليات الحكمة عند زهير بن أبي سلمى الدالة على نضجه، بيتاه اللذان ضمنهما أصول الفصل بين الخصمين في المحاكمات. وهذه الأصول ثلاثة: حلف اليمين، أو بسط القضية أمام حكم عدل، أو انكشاف الحقيقة التي تقمع الخلاف. فهذه الأمور الثلاثة مفاصل الحق، وشفاء النفوس من الريبة:
فَإِنَّ الحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلاثٌ *** يَمينٌ، أَوْ نِفارٌ، أَوْ جَلاءُ
(حيث إن “الحق مقطعه ثلاث” تعني ثلاث خصال ينفذ بكل واحدة منها، و”نفار” تعني تحاكم إلى حكيم، و”جلاء” تعني انكشاف حقيقة الأمر).
لَكُمْ مَقاطِعُ كُلِّ حَقٍّ ثَلاثٌ *** كُلُّهُنَّ لَكُمْ شِفاءُ
ولا يضير زهيراً أن يشكك طه حسين في صحة بيتيه السابقين، فهما عندنا من صحيح الشعر لارتباطهما بهجاء بني عُليم، ولأن رجاحة العقل التي أنتجت الحكمة عند زهير بن أبي سلمى قد تقود الشاعر الملهم المتمرس بتجارب كثيرة إلى اكتشاف أفكار عميقة، وأصل من أصول القضاء. وأي دستور أو قانون يخلو من أصول وتشريعات لخصت تجارب البشر؟
خلاصة الحكمة عند زهير بن أبي سلمى في معلقته
وفي معلقته، تتكثف خلاصة الحكمة عند زهير بن أبي سلمى في بضعة عشر بيتاً لخص فيها الشاعر آراءه في الموت والحياة، وفي السلوك الإنساني، ودعا إلى التزام القيم والمثل وإلى السلام والفضائل، وندد بالخصومة والمنافرة، وأخضع العلاقات الإنسانية في المجتمع القبلي لمفاهيم متحضرة راقية.
ولا يؤخذ على هذه التجليات من الحكمة عند زهير بن أبي سلمى إلا عرضها بأسلوب الناصح الواعظ، وفتور مشاعرها، وتفكك أفكارها، وحاجتها إلى الترابط والالتحام بموضوع المعلقة، لكنها – على تفككها – تشكل دستوراً عاماً يهذب ويوجه، ويرسم أقوم السبل في المسلك والعلاقات الاجتماعية، وهذا هو جوهر الحكمة عند زهير بن أبي سلمى. كما أنها تقتلع من نفوس الجاهليين جفوة البداوة والحمية الرعناء، وتلقنهم حسن التصرف وأصول التعامل، وتحبب إليهم العفة، وحسن الجوار، ونبذ العصبية، وتستل منهم الأهواء العنيفة الصاخبة، وتبث فيهم نمطاً غامضاً من الإيمان بالله والبعث، ليكبح جموحهم إلى الغزو والشر، وليبسط عليهم ظلال الأمن والحب والخير والمساواة. إنه – باختصار شديد – يحاول أن يصنع لهم ضميراً يحتكمون إليه، بعد أن طال احتكامهم للسيف، وهذا أسمى ما تهدف إليه الحكمة عند زهير بن أبي سلمى.
خاتمة
وفي الختام، يتضح أن الحكمة عند زهير بن أبي سلمى تتجاوز كونها مجرد غرض شعري لتصبح مشروعًا فكريًا وأخلاقيًا متكاملاً. لقد استطاع زهير، من خلال تجاربه العميقة ونظرته الثاقبة، أن ينحت دستورًا سلوكيًا لمجتمعه، متنقلاً بالحكمة من حيز القول النظري إلى حيز التطبيق العملي. لقد حلل هذا المقال كيف أن الحكمة عند زهير بن أبي سلمى ارتكزت على الواقعية، داعيةً إلى السلم والتسامح والصدق، وصولًا إلى تقديم رؤية قضائية وإيمانية سبقت عصرها. لذلك، تظل الحكمة عند زهير بن أبي سلمى شاهدة على أن الشعر لم يكن ديوان العرب لتسجيل أيامهم فحسب، بل كان أيضًا منارة لصناعة ضمائرهم، تاركًا إرثًا خالدًا يجسد انتصار العقل والفضيلة على الحمية والعصبية.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هي المصادر الأساسية التي استقى منها زهير بن أبي سلمى حكمته الشعرية؟
الإجابة: تستند الحكمة عند زهير بن أبي سلمى بشكل أساسي إلى ثلاثة مصادر، مع تفاوت واضح في تأثير كل منها. المصدر الأول هو التأمل الفلسفي، والذي كان محدود التأثير نظرًا لأن العصر الجاهلي لم يكن عصر فلسفة منهجية. المصدر الثاني هو الثقافة المكتسبة، والتي لم تكن لزهير ميزة خاصة بها تميزه عن معاصريه. أما المصدر الثالث والأكثر أهمية وغزارة، فهو التجارب الحياتية والظروف الشخصية. فقد أثر اغترابه ونشأته بعيدًا عن أهله في صقل طباعه، مما دفعه إلى الوقار، والمداراة، وتجنب التهور، وهي السمات التي انعكست بشكل مباشر في دعوته إلى تحكيم العقل والصبر والتزام الفضيلة.
٢ – كيف تختلف حكمة زهير عن النزعات السائدة لدى شعراء عصره، خاصة الصعاليك؟
الإجابة: تختلف الحكمة عند زهير بن أبي سلمى جوهريًا عن نزعات شعراء عصره. ففي حين أن تجربة الاغتراب والابتعاد عن القبيلة دفعت شعراء آخرين إلى الصعلكة والتمرد العنيف، فإنها قادت زهيرًا إلى الحكمة والتروي. لقد كان نزوعه الأصيل نحو الخير هو ما جعله يتغنى بالحلم ويقدر العقل، بينما اتجه غيره إلى العنف. علاوة على ذلك، كانت دعوته إلى التكافل القبلي نابعة من “الحب” والرغبة في السلام، وليس من “العصبية” والحمية العمياء التي ميزت دعوات معاصريه لنصرة قبائلهم، مما يضفي على حكمته بعدًا إنسانيًا وأخلاقيًا رفيعًا.
٣ – هل كانت حكمة زهير مثالية ومنفصلة عن الواقع، أم أنها كانت عملية وواقعية؟
الإجابة: لم تكن الحكمة عند زهير بن أبي سلمى سباحة في أفق مثالي بعيد المنال، بل كانت متجذرة بعمق في “الواقع القبلي”. كانت حكمته عملية تهدف إلى معالجة قضايا اجتماعية حقيقية، مثل ضرورة التكافل بين أفراد القبيلة، وتقديم المعروف، وحل النزاعات. فدعواته إلى الصدق، والحذر، وتجنب الكذب، وتمجيده للقوة كوسيلة للدفاع عن الحقوق وليست للعدوان، كلها تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الحياة البدوية القاسية ومتطلباتها، مما يجعل حكمته دستورًا عمليًا للسلوك الاجتماعي وليس مجرد تنظير فلسفي.
٤ – ما هو الدور الذي يلعبه الإيمان بالله واليوم الآخر في منظومة الحكمة عند زهير؟
الإجابة: يلعب الإيمان بالله والبعث دورًا محوريًا في الارتقاء بمفهوم الحكمة عند زهير بن أبي سلمى من مجرد نصائح دنيوية إلى منظومة أخلاقية ذات بعد روحي. إيمانه بأن الله مُطلع على السرائر، وأنه يسجل أعمال البشر في كتاب ليحاسبهم عليها يوم القيامة، شكل رادعًا أخلاقيًا قويًا. هذه الفكرة لم تكن شائعة بهذا الوضوح بين شعراء عصره، وقد استخدمها زهير كأداة لترسيخ الصدق والأمانة، وكبح جماح الشر والعدوان، وإضفاء عمق يتجاوز السطحية على نظرته للحياة والموت.
٥ – كيف وازن زهير في حكمته بين الدعوة إلى السلام والحلم، وبين تمجيد القوة ورفض الظلم؟
الإجابة: يكمن أحد أبرز جوانب نضج الحكمة عند زهير بن أبي سلمى في قدرته على الموازنة بين قيمتين تبدوان متعارضتين: الحلم والقوة. لم تكن دعوته إلى التسامح والعفو دعوة إلى الضعف أو الخنوع. لقد أدرك ببراعة أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بحماية القوة. ففي قوله “ومَنْ لا يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ يُهَدَّمْ”، يؤكد أن القوة ضرورية لحماية الحقوق والمكتسبات. بالتالي، فإن حكمته تقدم رؤية متكاملة: السلام هو الهدف الأسمى، ولكن القوة هي السياج الذي يحميه من العدوان والظلم، وهذا توازن واقعي يعكس فهمًا عميقًا للطبيعة البشرية والمجتمعية.
٦ – ما هي أبرز المآخذ النقدية التي وُجّهت إلى طريقة عرض الحكمة في شعر زهير؟
الإجابة: على الرغم من عمقها، فإن طريقة عرض الحكمة عند زهير بن أبي سلمى لم تسلم من النقد. أبرز المآخذ عليها هي أنها تُقدَّم بأسلوب “الناصح الواعظ” المباشر، مما قد يضعف الأثر الفني والشعوري. كما يؤخذ عليها “فتور المشاعر” المصاحبة لها، حيث يطغى العقل والمنطق على العاطفة. والنقد الأهم هو “تفكك أفكارها” وحاجتها إلى ترابط عضوي أكبر مع الموضوع الرئيسي للمعلقة، إذ تبدو في بعض الأحيان كفقرات مستقلة مدرجة في القصيدة وليست جزءًا لا يتجزأ من نسيجها.
٧ – كيف تجلت عبقرية زهير في وضع أسس تشبه القوانين القضائية الحديثة؟
الإجابة: تتجلى عبقرية زهير وقدرته على التفكير المنهجي في بيتين لخص فيهما أصول فض النزاعات، مما يجعل الحكمة عند زهير بن أبي سلمى ذات بعد قضائي وتشريعي. فقد حدد ثلاثة مسارات واضحة وحاسمة لإنهاء أي خصومة، وهي: “يَمينٌ، أَوْ نِفارٌ، أَوْ جَلاءُ”. هذه المسارات الثلاثة (اليمين الحالفة، أو التحاكم إلى حكم عدل، أو ظهور الحقيقة الدامغة) تشكل أساسًا لأي عملية تقاضٍ عادلة، وتدل على نضج فكري فذّ قاده إلى اكتشاف أصل من أصول القضاء الذي لا يزال معتبرًا في جوهره حتى اليوم.
٨ – إلى أي مدى يمكن اعتبار الحكمة عند زهير محاولة لبناء “ضمير” للمجتمع الجاهلي؟
الإجابة: يمكن اعتبار الحكمة عند زهير بن أبي سلمى مشروعًا متكاملاً يهدف إلى “صناعة ضمير” للمجتمع الجاهلي. فبعد أن طال احتكام العرب إلى السيف والحمية القبلية، جاء زهير ليقدم بديلاً قائمًا على العقل والأخلاق. حكمته لم تكن مجرد نصائح فردية، بل كانت دستورًا اجتماعيًا يهدف إلى تهذيب السلوك العام، ونبذ العصبية، وترسيخ قيم العفة وحسن الجوار، وبث الإيمان ككابح للنزعات العدوانية. وبهذا، كان يحاول تأسيس مرجعية داخلية (ضمير) يحتكم إليها الناس بدلاً من المرجعية الخارجية المتمثلة في القوة وحدها.
٩ – ما هي النظرة التي قدمها زهير عن الموت والخلود، وكيف ترتبط بحكمته العامة؟
الإجابة: قدم زهير نظرة مزدوجة للموت والخلود. في المستوى الأول، نظرته تبدو عفوية وسطحية، حيث يرى الموت نهاية حتمية للحياة الجسدية، لكنه يرى أن الخلود الحقيقي يكمن في الذكر الحسن والأحاديث الطيبة التي يخلفها المرء بعده. وفي المستوى الثاني الأكثر عمقًا، والذي يمثل جوهر الحكمة عند زهير بن أبي سلمى، فإنه يرى الموت كبوابة إلى حياة أخرى فيها حساب وعقاب. هذا الربط بين الفناء الجسدي والخلود الروحي أو خلود السيرة، يدفعه إلى الحث على فعل الخير والصدق لضمان كلا النوعين من الخلود.
١٠- هل يمكن القول بأن زهير كان فيلسوفًا أم حكيمًا مجرّبًا؟ وما الفرق بينهما في سياقه؟
الإجابة: بناءً على النص، كان زهير حكيمًا مجرّبًا أكثر من كونه فيلسوفًا بالمعنى المنهجي. الفلسفة تتطلب بناء نظريات مجردة ومتكاملة حول الكون والوجود، وهو ما لم يكن سمة من سمات العصر الجاهلي أو شعر زهير. أما الحكمة، فهي نتاج التأمل في التجارب العملية واستخلاص العبر منها. الحكمة عند زهير بن أبي سلمى نبعت مباشرة من معاناته في الاغتراب، ومراقبته للسلوك البشري، وفهمه العميق لمتطلبات الحياة القبلية. لذلك، حكمته تطبيقية وعملية، بينما الفلسفة نظرية وتأملية، وهذا هو الفارق الجوهري في سياقه التاريخي.