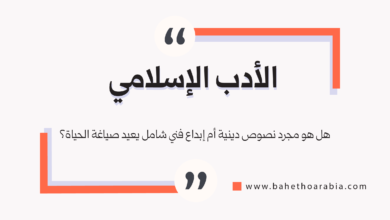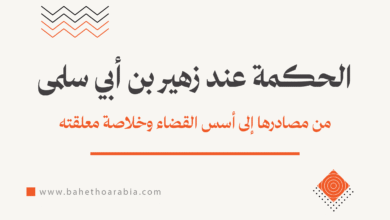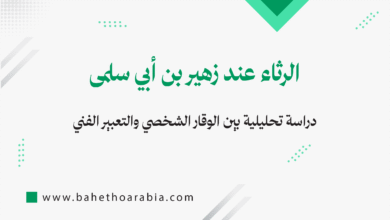الهجاء في الشعر الجاهلي: تعريفه ودوافعه وتأثيره وأنواعه وخصائصه

لم تكن السيوف وحدها سلاح العرب في جاهليتهم، بل كانت الكلمة أشد وقعاً واللسان أمضى من السنان. وفي هذا السياق، يبرز الهجاء في الشعر الجاهلي كسلاح اجتماعي فتاك، وغرض شعري يعكس بصدق وواقعية طبيعة الحياة القبلية بما فيها من صراعات ونزاعات وحرص على الشرف والمكانة. لم يكن الهجاء في الشعر الجاهلي مجرد شتم عابر، بل كان فناً له أصوله، وقوة لها تأثيرها السحري الذي تخشاه القبائل وترتعد منه فرائص الأشراف. تسعى هذه المقالة الأكاديمية إلى الغوص في أعماق ظاهرة الهجاء في الشعر الجاهلي، متجاوزة النظرة السطحية التي تحصره في مجرد القذف. سنستعرض تعريفه لغةً واصطلاحاً، ونحلل دوافعه النفسية والاجتماعية، ونكشف عن أنواعه المختلفة من القبلي إلى الشخصي، ونستجلي أبرز خصائصه الفنية والأخلاقية التي ميزته كأداة نقد وردع في آن واحد.
تعريف الهجاء لغة واصطلاحاً
يُعرّف الهجاء في الشعر الجاهلي في اللغة بأنه الشتم بالشعر. جاء في لسان العرب: «هجاه يهجوه هجواً وهجاء وتهجاء ممدود شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح. قال الليث: هو الوقيعة في الأشعار. وهم يتهاجون: يهجو بعضهم بعضاً، وبينهم أهجوه وأهجية ومهاجاة
يتهاجون بها.»
أما الهجاء في الشعر الجاهلي في الاصطلاح، فهو غرض من أغراض الشعر، يتناول فيه الشاعر بالذم والتشهير عيوب خصمه المعنوية والجسمية. وهو نقيض المدح، لأن المدح يذكر الفضائل، والهجاء في الشعر الجاهلي يذكر الرذائل.
دوافع الهجاء في الشعر الجاهلي وتأثيره
حفلت الحياة القبلية في العصر الجاهلي بأنماط مختلفة من الصراع والخصومة والتنافس تجاوبت أصداؤها في الشعر، وعبّر عنها الشعراء مرة بالفخر والمدح وثانية بالوعيد والتهديد، وثالثة بالسخر والهجاء في الشعر الجاهلي. وفي هذه الأغراض كلّها كان الشعراء يفرغون ما تتركه في نفوسهم تجارب الحياة من عواطف الحب والكره والإعجاب والنفور والرضى والغضب.
ويُخيل إلينا أن عواطفهم في الهجاء في الشعر الجاهلي كانت أقرب إلى العنف والصدق، والحرارة والتوهج من عواطفهم في المديح، لأن سوق التكسب من خلال الهجاء في الشعر الجاهلي كانت قليلة الحظ من الرواج، وغاية ما يفعله الشاعر المتكسب – إذا كان التكسب بفن الهجاء في الشعر الجاهلي ممكناً ـ أن يهدد من عدا على
حق له فيرده إليه وأن يشوب مدح الممدوح بشيء من التعريض بخصومه، ليكون شعره أفعل في نفس الممدوح، فيزيد في جائزته. غير أنّ هذا المقدار اليسير من ممالأة الممدوح ومظاهرته على خصمه لا ينزل بدوافع الهجاء في الشعر الجاهلي إلى الكذب والادعاء إلا في أحوال قليلة.
وإذا كان لنا أن نشك في الباعث الأوّل الذي يبعث على المديح، وهو الإعجاب، فإننا نجد صعوبة في إنكار الباعث الأول الذي يبعث على الهجاء في الشعر الجاهلي وهو البغضاء، لأنّ افتتان الشاعر بنفسه وبفنه يجعل أدنى انتقاص أو نيل من نفس الشاعر أو فنّه مدعاة للامتعاض والغضب. ولاسبيل لإراحة النفس من هاتين العاطفتين الممضتين إلا بالتعريض الخفي أو الهجاء في الشعر الجاهلي الصراح.
وربما كان الهجاء في الشعر الجاهلي أعنف من المدح وأصدق، لأن الأوّل أقرب إلى الانفعال النابع من الذات، والثاني أقرب إلى الانفعال الطارئ على الذات. وتأويل المسألة أن الدافع إلى الهجاء في الشعر الجاهلي – وهو الغضب – تشتعل جذوته في نفس الشاعر أوّل الأمر، ثم تزيدها الأحداث تسعرًا، حتى يضيق بها صدره، فتنطلق لتثأر ممن أثارها، وأن الدافع إلى المدح إعجاب بأعمال ومآثر لاحظ للشاعر منها إلا أن يذكر غيره. فمصدر الهجاء في الشعر الجاهلي هو الشاعر، ومصدر المدح سواه، فهو – أي الدافع إلى المدح – فاتر الأثر في حسّ الشاعر، ضئيل التعلّق
بنفسه، يُشعره بضآلة الجرم أمام العظماء. والشاعر ـ كما ذكرنا ـ إلى الاختيال والغرور أقرب، وعلى الإدلال بمزاياه وسجاياه أحرص يدلّك على ذلك أن أشدّ الشعراء وقاراً لا يملكون أنفسهم عند الغضب. وأنت تعرف من حكمة زهير ورزانته، ومن نبله
وفضله، ومن حلمه وسعة صدره مالا تعرف لغيره من الشعراء، وتعرف كذلك أن هذا الشاعر حينما أثاره بنو الصيداء، ثار وخلع ثوب الوقار وهجا الحارث بن ورقاء عبر الهجاء في الشعر الجاهلي هجاءً أزرى بالهاجي إزراءه بالمهجو.
وربّما كان الهجاء في الشعر الجاهلي أعنف من المدح لأن طبيعة العاطفة التي يصدر عنها الهجاء في الشعر الجاهلي متفجرة متنمرة، والمجتمع البدوي المتنمر بصورة دائمة للهراش والمصاولة يتلقى هذه العاطفة كما يتلقى الهشيم اليابس الشرارة فيحترق بها، ويحرق غيره.
ويبدو أن خوف العرب من الهجاء في الشعر الجاهلي كان أظهر من ارتياحهم للمدح، وأنهم كانوا من ألسنة الشعراء الحداد على حذر، فهم يعايشونهم ويحاذرونهم كما يعايش سكان المناطق البركانية براكينهم المخوفة وكما يحاذر أهل الغابات الكواسر والضواري. ولم يغفل
الشعراء عن سلاحهم هذا، فراحوا يتوعدون به الناس ويقرنون به سلاحاً خفياً أشدّ ما يخشاه عامة العرب هو قوة الشعر الشيطانية وأثره السحري الرهيب، فإذا هم الشاعر بفن الهجاء في الشعر الجاهلي استعان شيطانه، فقذف الشيطان في صدره ولسانه من قوة السحر تأثيراً فيما يصعق المهجو.
انظر إلى الأعشى كيف قابل خصومه حين ائتمروا به، وأبدوا له النواجذ، وتنمروا لافتراسه. لقد حرك عصاه السحرية، فلبّاه شيطانه مسحل)، وقذف الرعب في قلوب الخصوم، وضرب بعصاه صدر الأعشى، فانفجر منه سيل يغرق وبركان يحرق، فإذا غريمه جهنام مصعوق، بسحره، أو غريق في بحره.
فلما رأيتُ الناسَ للشَّر أقبلوا *** وثابوا إلينا من فصيح وأعجمِ
دعوت خليلي مسحلاً، ودعوا له *** جهنام، جدعاً للهجين المذمّمِ
حباني أخي الجنّي، نفسي فداؤه *** بأفيخَ جياشٍ من الصدر خضرمِ
وللدكتور يحيى الجبوري رأي يظاهر ما ذكرنا فهو يرى أنه لصلة الشعر هذه بالسحر نسبوا القوة الخفية في الشعر إلى الشر، فقالوا: شيطان الشعر، ولم ينسبوها للخير». ويرى أن هذه الصلة الشيطانية بين السحر والشعر كانت تدفع الشعراء إلى مسلك غريب، وهو أن يلبسوا حينما ينشدون قصائد الهجاء في الشعر الجاهلي ملابس غريبة، وأن يمسخوا هيئاتهم، ليوقعوا الرعب في نفوس الخصوم، ويشفع رأيه بما فعله لبيد حين هاجى الربيع ابن زياد في مجلس النعمان، ثم يقول: ويقول المرتضى: وكذلك كانت الشعراء تفعل في الجاهلية إذا أرادت ممارسة الهجاء في الشعر الجاهلي».
وسواء أكان هذا المسلك الغريب ظاهرة عامة لدى شعراء العصر الجاهلي أم بدعة ابتدعها بعضهم ولم تشيع فقد كانت العرب تخشى الهجاء في الشعر الجاهلي، وتفرق منه، وبخاصة الأشراف، فقد كانوا يبكون بالدموع الغزار من وقع الهجاء في الشعر الجاهلي، كما بكى مخارق بن شهاب وعلقمة بن علاثة وكذلك عبد الله بن جدعان. وكان الهجاء في الشعر الجاهلي الذي تعرض له من خداش بن زهير. وقد كان من خوفهم من الهجاء في الشعر الجاهلي وأثره في نفوسهم أنهم إذا هجاهم شاعر بسوءة – ولو كانت مفتراة – فإنهم يتوارون خجلاً.
وليس من المستغرب أن تنفر نفوس العرب من الهجاء في الشعر الجاهلي، وأن يتحول نفورها إلى ما عليه العرب من قيم ومثل عليا. قال ابن الأثير: يستحب في الهجاء في الشعر الجاهلي ألا يكون في ظاهره فحش يتحاماه ذوو الدين والمروءة، ولا يقبح إيراده في المحافل، ولا يخشى غائلة الهجو
به.. ومتى أتى الشاعر في شعره بالقذف والإفحاش والسباب دلّ ذلك على لوم الشاعر وشماتته. ومن يصدر ذلك عنه من الشعراء فقد هجا نفسه قبل المهجوّ..
وقال أبو عمرو بن العلاء وخير الهجاء في الشعر الجاهلي ما تنشده العذراء في خدرها، فلا يقبح بمثلها. نحو قول أوس:
إذا ناقة شدت برحل ونمرقٍ *** إلى حيكم بعدي فضلّ ضلالُها
وقال ابن رشيق: وأجود ما في الهجاء في الشعر الجاهلي أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية، وما تركب من بعضها مع بعض. فأما ما كان من الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء به دون ما تقدم، وقدامة لا يراه هجواً. البتة وكذلك ما جاء من قبل الآباء والأمهات من
النقص والفساد لا يراه عيباً، ولا يعد الهجو به صواباً.. والذي أراه أنا على كل حال أن أشد الهجاء في الشعر الجاهلي ما أصاب الغرض، ووقع على النكتة. ومن يستعرض آراء القدماء في معاني الهجاء في الشعر الجاهلي يجد فيها ما يشبه الإجماع على استنكار القذف والسب واستجادة التعريض العفيف قال خلف الأحمر: «أشد الهجاء في الشعر الجاهلي أعفه وأصدقه» وقال صاحب الوساطة: «فأما الهجاء في الشعر الجاهلي فأبلغه ما خرج مخرج التهزل
والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض وما قربت معانيه، وسهل لفظه، وأسرع علوقه بالقلب، ولصوقه بالنفس فأما القذف والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن.
أنواع الهجاء في الشعر الجاهلي
من كلام النقاد على معاني الهجاء ومن تفضيلهم بعض المعاني على بعض يستطيع الدارس بشيء من الملاطفة والتسمح أن يزعم أن الهجاء في الشعر الجاهلي لم يكن من نمط واحد، بل كان من أنماط متعددة. غير أن القليل الذي بلغنا من أشعارهم لا يتيح لنا أن نمضي في تقسيم الهجاء في الشعر الجاهلي مضي الواثق المطمئن القادر على إفراد كل قسم بسمات يتفرد بها.
ويبدو أن النفس العربية لم تكن تولي الزراية بالرذائل اهتماماً يعدل العناية بالفضائل، فقل هجوها، وكثر فخرها ولو نظرنا في المعلقات التي تمثل أصفى ما نفذ إلينا من الشعر الجاهلي لتحقق لنا أنها تُلم بالفخر والغزل والوصف والخمرة وما أشبه.
ولكنها تكاد لا تنصرف إلى الهجاء إلا لماماً في فلذات مبتسرة، وكذلك الأمر في سائر
القصائد الجاهلية، فإنّ نزعتي الوصف والفخر أوشكتا أن تستنفداها.
وهكذا نستطيع – على قلة ما بين أيدينا من نصوص – أن نخضع هجو الجاهليين إلى شكل من التقسيم يقفنا على أربعة أضرب هي: الهجاء القبلي، والهجاء الشخصي، والردّ على الخصوم ونقد الرذائل.
الهجاء القبلي
إذا كان الصراع القبلي في العصر الجاهلي يتجلّى في الحروب التي عرفت بأيام العرب فإن السلاح في هذا الصراع لم يكن في ميادينه كلها بيض السيوف وسمر الرماح، وإنما كان في بعض ميادينه صراعاً فكريا تشهر فيه الألسنة، وتقدح القرائح، وتُرمي
سهام الكلام. وكانت المعركة بوجهيها الدموي والفكري ترمي إلى مرمى واحد هو النيل من الخصم أو الإجهاز عليه بعد جرحه في حلبة النزاع على البقاء. وللوجه الفكري في هذه الملحمة قسمات مشرقة يرسمها الفخر وقسمات غائمة يرسمها الهجاء في الشعر الجاهلي وفي هذه القسمات الغائمة يتراءى لك التشاؤم والبغض والعداوة والحقد والقسم، وكل ما يسوء وينوء من أفكار الشعراء وعواطفهم. فالمرقش الأكبر هجا قوماً من العرب هجواً موجعاً، فزعم أنهم لا يكسبون أقواتهم إلا بالفساد وانتهاك المحرمات، وأنهم إذا أخصبوا أطغاهم الخصب، وإذا أملقوا كشف الإملاق لؤمهم:
لسنا كأقوام مطاعمهم *** كسب الخنا، ونهكة المحرم
إن يخصبوا يعـيـوا بخصبهم *** أو يجدبوا فهم به الأم
وحمل امرؤ القيس على بعض القبائل حملة منكرة، فقبح وعفر، وجدع الأنوف وعزا إلى الرجال أسوأ ما تعير به النساء، ورماهم بتضييع الجار، والتفريط بالحقوق:
ألا قبّح اللهُ البراجمَ كلّها *** وجدّع يربوعاً، وعفّر دارما
وآثر بالملحاة آل مجاشع *** رقاب إماء يقتنين المفارما
فيا قاتلوا عن ربهم وربيبهم *** ولا آذنوا جاراً، فيظعن سالما
وإذا كانت العرب تفاخر بالشجاعة، فأهجى ما تهجو به التخنث والضعف وترك القتال والاستكانة للعدو كما تستكين الحمر لمن يسوقها والصراخ من الذعر كما تصرخ المعزى وتثغو الشاء. وأوجع ما يكون الهجو بهذه الرذائل أن تكون شاملة، تعير به قبيلة أو مجموعة من القبائل. قال بشر بن أبي خازم:
وليس الحي حي بني كلاب *** بمنجيهم وإن هربوا الفرارُ
وقد ضمزت بجرتها سليم *** فخافتنا كما ضمز الحمارُ
وأما أشجعُ الخنثى فولت *** تيوساً بالشظي لهم يعارُ
ويبدو أن الشعراء كانوا ينزهون هجومهم القبلي عن بذيء القول وفاحشه، لأن عاره – كما ذكر النقاد – يلحق الهاجي قبل المهجو، ويذهب بهيبة المتكلم قبل هيبة السامع. هجا بشر بن عليق الطائي بني عاملة، فكان أول ماهجاهم به بذاءة ألسنتهم
في الشعر، ثم أضاف إليها خفر الذمم، وانحطاط أقدارهم عن أقدار الناس وقلة مواليهم والعبيد، وقصورهم عن شنّ الإغارة واغتنام الفيء. قال بشر بن عُليق:
أعامل ما بال الخني تقذفونه *** من الغور مسدى بالقوافي ومُلحما
وما تمنعون الجar منكم بذمة *** تحوط ولا توفي دماؤكم دما
قُبَيَّلةٌ دقَّتْ، وقلّ عبيدُها *** وذلّتْ فما كنتم تُفيئون مغنما
وربّما كان هذا الهجاء – على ما فيه من إيذاء – أهون على القبيلة من السخر القاتل، والتهكم اللاذع والهزء الذي يغشي الفكرة المعروضة بغشاوة من الحيرة المذهلة. لقد فكر زهير في كنه بني حصن، فلم يهده تفكيره إلى حقيقتهم، أهم من الذكور أم من الإناث؟ فإن كانوا ذكوراً ففيم ضعفهم وخوفهم، وإن كانوا إناثاً، فمن حق كل امرأة أن تكون ذات بعل، وهو على تزويج العوانس والأيامى حريص:
وما أدري وسوف إخالُ أدري *** أقوم آل حصن أم نساء
فإن تكن النساء محجّبات *** فحقّ لكلّ محصنة هِداءُ
وعلل بعض النقاد إيثار العرب التعريض على التصريح بأن التعريض يثير الشوق إلى التأويل، ويقدح في الفكر شرارة التفسير ويدفع السامع إلى الكشف عما وراء الكنايات من حقائق فقال: التعريض في الهجو أبلغ من التصريح لاتباع الظن في التعريض.
الهجاء الشخصي
قد يكون هذا الضرب من الهجاء في الشعر الجاهلي أعنفه وأشده، وأحفله بالعيوب. وعنفه ناجم عن الدوافع إلى نظمه كإغضاب الشاعر والائتمار به. ولم يكن الخوض فيه قاصراً على الشعراء، بل شاركت فيه الشواعر بقدر فالخرنق أخت طرفة بن العبد هجت عبد عمرو بن بشر بعد أن وشى بأخيها، ودختنوس هجت النعمان بن قهوس التميمي، والخنساء هجت في جاهليتها دريد بن الصمه حين خطبها، فردته، وأرسلت إليه تقول: «ماكنت لأدع بني عمي، وهم مثل عوالي الرماح، وأتزوج شيخاً، وقالت:
معاذ الله ينكحني حبركَى *** يقال: أبوه من جُشم بن بكرِ
ولو أصبحت في جشم هديا *** إذاً أصبحتُ في دنس ٍوفقرِ
وربما اختلطت في هذا الضرب من الهجاء عيوب الفرد بعيوب القبيلة، فقد رأيت كيف بدأت الخنساء بهجو دريد ثم انتقلت إلى هجو قومه. وسلك سبرة بن عمرو الفقعسي هذا المسلك حينما هجا ضمرة بن ضمرة النهشلي، إذ غيره بضعفه، وبضعف
قومه الذين تفرقوا عن نسائهم، فاضطرت النساء إلى التشبه بالإماء ليدفعن عن أنفسهن ذلّ السباء، لأن العرب لاتسبى غير الحرائر:
اتنسى دفاعي عنك إذ أنت مُسْلَم *** وقد سال من ذل عليك فراق
ونسوتكم في الروع باد وجوهها *** يخلن إماءً، والإماءُ حرائرُ
ومن أشنع العيوب التي كان الشاعر الجاهلي يرمي بها خصمه الجبن والعجز عن حماية الجار، وهذا يعني أن الهجاء في الشعر الجاهلي ذي الطابع الشخصي لا يختلف في جوهره عن الهجاء القبلي. هجا أبو ثمامة بن عازب الضبي رجلا اسمه محرز فوصمه بالهوان المعدي الذي ينتقل منه
إلى من يقاربه، وإذا كان محرز عاجزا عن مدافعة الذلّ عن نفسه فكيف يدفعه عمّن يلوذ به؟
وقلت لمحرزٍ لما التقينا *** تنكب لا يقطّرك الزِّحامُ
أتسألني السَّوية وسط زيد *** ألا إن السّوية أن تضاموا
فجارك عند بيتك لحمُ ظبيٍ *** وجاري عند بيتي لا يرام
وحق الجارة – عند العرب – فوق حق الجar، فإذا عدا العربي على حرمة جارته، أو سعى إليها بريبة رماه الناس بالتعهر والفسوق، فكيف إذا جمع إذلال الجار إلى مراودة الجارة؟ هجا ثرملة بن شعاث الأجئيُّ عمرو بن المنذر بن ماء السماء أو عمرو بن هند،
لأنه غدر بجيرانه من بني طيّء، فجر على رجالهم الذلّ، وعلى نسائهم العار، إذ كان يتودد إليهن بالهدايا والعطايا لعلّه يقضي منهن، وطراً، أو يظفر بوصال. قال ثرملة:
والله لو كان ابن جفنة جاركم *** لكسا الوجوهَ غضاضة وهوانا
وسلاسلاً يثنين في أعناقكم *** وإذاً لقطع تلكم الأقرانا
ولكان عادته على جاراته *** مسكاً وريطاً دارعاً وجفانا
وللنسب في هذا الضرب من الهجو موضع، لأنّ أشدّ النقائص على العربي أن ينتقص أصله، أو يُشك في انتمائه إلى أهله أو يتهم بأنه من غير العرب، هجا بشر بن عليق الطائي ابن الرقاع فجعله ساقطة مالها لاقطة و «فقعة في قاع» أي: نكرة لا يعرف نسبه، وأنكر أن يكون له في المجد سابقة أو لاحقة، وحرّم عليه الكلام في نَدِي السراة، فقال:
بُنيَّ الرّقاع ما لقولك ينتمي *** وكنت أحق الناس ألا تكلّما
عهدتك عبداً لست من أصل معشرٍ *** عن المجد مقطوع السواعد أجذما
وهل كنت إلا فقع قاعٍ بقـرقــرٍ *** وساقطةً بين القبائل مُسْلَما
الرد على الخصوم
قد يتهاجي شاعران، فيغدو الهجاء في الشعر الجاهلي شكلاً من أشكال الترافع والمنافرة، يختلط فيه الفخر والذم، وهجو الفرد بهجو القبيلة. وربّما كان هذا الضرب بداية لفن النقائض الذي ازدهر في العصر الأموي. ومن هذا الهجاء ما كان بين امرىء القيس وبعض
الشعراء بعد مقتل أبيه كعبيد بن الأبرص وسبيع بن عوف وأمية بن خلف الخزاعي وحسان بن ثابت، وتأبط شراً، وحاجز الأسدي.
جاء في أخبار امرئ القيس أنه كان بينه وبين سبيع بن عوف بن حنظلة قرابة، فأتى سبيع امرأ القيس يسأله، فلم يعطه شيئاً، فقال سبيع أبياتاً يعرض بامرئ القيس فيها، ويذمّه فقال امرؤ القيس مجيباً له على ذلك:
أبلغ سبيعاً إن عرضت رسالة *** أنّي كهمّك إن عشوت أحامي
أقصر إليك من الـوعـيـد فإنني *** ممّا ألاقي لا أشدُّ حزامي
وفي هذا النوع من الهجاء في الشعر الجاهلي أدب واحتشام وترفع عن الإفحاش، ودفاع عن النفس، وزجر مهذب عن التهديد وتنمر للمصاولة.
ومن هذا النمط ما كان بين عامر بن الطفيل ونابغة بني ذبيان. وعامر كان البادئ إذ قال في هجو النابغة – واسم النابغة زياد -:
ألا مَنْ مبلغٌ عنّي زياداً *** غداةَ القاعِ، إذ أزِفَ الضِّرابُ
«فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا هجاءه، وائتمروا له، فقال لهم النابغة: إنَّ عامراً له نجدة وشعر ولسنا بقادرين على الانتصار منه. ولكن دعوني أجبه وأصغر إليه نفسه وأفضل إليه أباه وعمه فإنه يرى أنه أفضل منهما، وأعيره بالجهل» وردّ النابغة على عامر فلم يفحش، ولم يسف واكتفى برميه بالرعونة، وجعله دون أبيه وعمّه في الحكمة والرشاد وسخر من كبريائه وأيأسه من اكتمال العقل فقال:
فإن يك عامرٌ قد قال جهلاً *** فإن مظنة الجهل الشبابِ
فكن كأبيك أو كأبي براء *** توافقك الحكومة والصواب
ولا تذهب بحلمك طاميات *** من الخيلاء ليس لهن باب
فإنك سوف تحلم أو تناهى *** إذا ما شبتَ أو شاب الغرابُ
ومن يستعرض نقائض الجاهليين يجد فيها سمة جامعة، وهي ارتفاعها عن الإسفاف وفكرة شائعة وهي إنذار الخصم قبل إطلاق اللسان فيه. وقعت بين قيس ابن مسعود الشيباني وراشد بن شهاب اليشكري مهاجاة، فزجر راشد قيساً، وحذره من شتم الناس، وذكره ما كان بينهما من حسن جوار وهدّده وتوعده، لم يهدده بلسانه الذي برأه من الشتم بل توعده بسيفه الذي تكسر من مقارعة الخصوم، فقال:
فمهلاً أبا الخنساء لا تشتمنّني *** فتقرع بعد اليوم سنك من ندم
ولا توعدي إنني إن تلاقني *** معي مشرقي في مضاربه قضم
ثم هدده بأن يهجوه بقصيدة أخرى، يلقيها في سوق عكاظ حيث يجتمع الشعراء تحت قبة الجلد، وفي ظل شجرة كانوا يفيئون إليها:
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد *** أمُوفٍ بأدراع ابن طيبة أم تُذمْ
بدم يغشي المرء خزياً ورهطه *** لدى السّرحة العشاء في ظلّها الأدمْ
وقد نجد في هذه النقائض نوعاً من التصوير الساخر، لكنه لا يقارف الفحش والولغ في الأعراض. هجا يزيد بن الصعق قوم أوس بن غلفاء التميمي، فرد أوس على يزيد بأبيات يعيره فيها بضعف الرأي، وجبن الأتباع، واضطراب القيادة، وينهاه عن أن
يعود إلى هجو قومه بني تميم، ويبين له أنّه لم يجن من بغيه عليهم إلا الشر، وحسبه خزياً أنه غدا – بعد أن هجاهم – مروّعا شريدا، يخافهم ويفرّ منهم كما تخاف القطاة النسر، وكما يفرّ الظليم من الصياد:
وجدنا من يقود يزيد منهم *** ضعاف الأمر غير ذوي نظام
كأنك عير سالئةٍ ضروطٍ *** كثير الجهل شتام الكرام
وإنك من هجاء بني تميم *** کمزداد الغرام إلى الغرام
وهم تركوك أسلحَ من حُبارى *** رأت صفراً وأشرد من نعام
وأبرز المعاني التي تشيع في تهاجي الجاهليين التحذير والتهديد، ورمي الشاعر خصمه بالرعونة، والصلف ودعوته إلى تحكيم العقل في الخصومة، فإذا انتبذ المهجو حكومة العقل احتكم الهاجي إلى السيف. وفي هذه المعاني رجولة وأنفة ورفعة، تحفظ أعراض الشعراء، وتربأ بشعرهم عن السقوط في السّباب، وتجعله أرقى من نقائض جرير والأخطل والفرزدق الذين تهاوشوا وتهارشوا، ومزقوا أنسابهم وأعراضهم بألسنتهم الحداد.
التنديد بالرذائل كشكل من أشكال الهجاء في الشعر الجاهلي
ربما كان هذا الضرب من الهجاء أرقى من الأضرب السابقة وأعف، لأنه إلى النقد التربوي أقرب وبالتوجيه الخلقي أشبه فيه نصح وإرشاد، وتقويم وإصلاح. وفيه يضع الشعراء من ذوي الحكمة خلاصة تجاربهم في الحياة بين أيدي الأغرار
فينصح كبار النفوس لصغارها، ويؤنّب الأعزّة الأذلّة، ويثقف السوي الغوي. هجا عروة بن الورد – وهو أمير الصعاليك – الصعلوك الخامل الذي يأوي في الليل إلى بيوت الأغنياء ليصيب من فتات الموائد فطفق يسخر من ضؤولته وفسولته ورضاه باليسير من القوت وغيّره باللؤم والأثرة، فهو إذا ظفر بالزاد لم يكن لغيره فيه نصيب، وإذا عزّ عليه أخدم نفسه نساء القبيلة، فكان أذلّ من عبد، وأعيا من بعير منتبذ:
لحى اللّه صعلوكاً إذا جنّ ليله *** مضى في المشـــاش آلـفــاً كل مجزرِ
يعدّ الغنى من دهره كلّ ليلة *** أصاب قراها من صديق ميسّرِ
قليل التماس المال إلا لنفسه *** إذا هو أضحى كالعريش المجـّورِ
يعين نساء الحي ما يستعنه *** فيضحي طليحاً كالبعير المحسّرِ
وأرقى ما في هذا الهجاء التجرّد من الهوى والإخلاص للقيم، لأن قائله لا ينال به إنساناً يبغضه، بل يرسله غُفْلاً غير مقرون بخصم، وعاماً غير مخصوص بمهجو ذميم. ولذلك يمكن أن نحمل عليه كثيراً من الحكم التي لخص بها زهير وطرفة وأمثالهما
النظرات العميقة في الحياة، كقول زهير في نقد الشح والأثرة:
ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله *** على قومه يُستغنَ عنه ويُذْمَمِ
وكتنديد طرفة بالذليل المضعوف البطيء عن المكارم السريع إلى الفواحش الذي يدفعه الناس عنهم اشمئزازا من دناءته وقراءته:
ولا تجعليني كامرىء ليس همّه *** كهمّي، ولا يغني غنائي ومشهدي
بطيء عن الجلّى سريع إلى الخـنــا *** ذلول بأجماع الرجال ملهّد
وهو باب واسع لو فتحناه على الهجاء لانتقل إليه كثير من شعر الحكمة والنقد الاجتماعي والتوجيه الخلقي.
خصائص الهجاء في الشعر الجاهلي
لما كان الهجاء بعض الشعر الجاهلي فإنَّ خصائصه الفكرية والفنية لا تخالف خصائص هذا الشعر، بل تتشعب منها.
ضآلة حجمه وقصر مقطعاته
وأولى هذه الخصائص ضآلة الهجاء، وقصر مقطّعاته، وانضواؤه في الأغراض الأخرى. وربما كان قصر مقطعاته سبباً من أسباب رواجه وسيرورته وعلوقه بالحافظة.
وربما كان انضواؤه تحت الأغراض الأخرى ناجماً عن الاعتقاد بأنه وسيلة للدفاع عن النفس والقبيلة، لا غاية يرمي إليها الشعراء، ولذلك لم يفرده الشعراء بقصائد خاصة.
مجانبة الإقذاع والتهاتر
تنبع هذه الخاصة من صفاء النفس العربية الأعرابية، وصدقها، وصراحتها والتزامها القيم وبغضها النفاق فقد عرضنا أنواع الهجاء ولم نجد فيها ذكراً لعورة، أو هتكاً لستر أو وَلْغاً في عرض وإن ورد في غير ما أوردنا معنى متعهر، أو لفظ بذيء تلقاه القوم بالإعراض، وحكموا على من قاله لا على من قيل فيه بالسقوط والمجانة. وهذه الخاصة جعلتنا نفضل هجاء الجاهليين على هجاء الأمويين والعباسيين، وكادت تقنعنا أنه لم يكن خلف هذا الهجاء بغض حاقد، أو نفوس شريرة. وإنما كان خلفه تنافر قبلي وحماسة سريعة التوهج، سريعة الانطفاء.
الواقعية والصدق
لم يكن الجاهليون يسرفون في الهجو، ولا يفترون على الخصوم ما ليس فيهم، بل يعيبون الخصم بما فيه، ويذكرون عيوبه بلغة واضحة بسيطة. فإذا صوّروا لم يبالغوا في التصوير، ولم يضخموا المثالب، ولم يهدفوا الى الإيلام والتشفي، بل هدفوا إلى الزجر، فمتى ازدجر المهجو أمسكوا. ولولا ذلك لاحتدمت بين الشعراء معارك لا تنتهي كالمعارك التي احتدمت بين جرير وخصومه ولقيلت في هذه المعارك قصائد لاغرض لها غير المهاترة والحرص على إفحام الخصم وإسكاته بالباطل والعدوان.
الهجاء بالمخازي لا بالعاهات
لما كان القصد من الهجاء كف الأذى، فالعاهات الجسدية لا موضع لها في هذا الهجاء. إن الشاعر لم يكن يهجو ليسخر ويتندر ويضحك الناس على المهجو، كما فعل ابن الرومي في العصر العباسي حينما فتك بأصحاب
العاهات، فلم يغفل مغنّياً أجش الصوت، ولا حامل أنف طويل، ولم يسلم من لسانه أصلع أو أحدب وفي ذلك الصنيع مافيه من وقاحة واستطالة على الخالق والمخلوق. لقد كان الشاعر الجاهلي يهجو ليصلح فاسداً، ويقوم منحرفاً، ويدفع عن نفسه البغي وعن قبيلته الهوان، لذلك حرص على نقد المخازي الخلقية من غدر ولؤم وشح وجبن، لأنّ هذه المخازي منابت الأذى، وجذور الشر، وإذا ورد في هجائه شيء من عيوب الجسد أورده مقروناً بما يدلّ عليه من نقص في النفس.
خاتمة
وفي ختام هذه الدراسة التحليلية، يتضح أن الهجاء في الشعر الجاهلي لم يكن مجرد غرض شعري للتعبير عن البغضاء الشخصية، بل كان ظاهرة اجتماعية وأدبية مركبة، تعكس بمرآة صافية منظومة القيم والأعراف التي حكمت المجتمع القبلي. لقد كشفنا عن دوافعه العميقة المتجذرة في العصبية والدفاع عن الشرف، وتتبعنا أنواعه المتعددة التي تراوحت بين الصراع الجماعي والخصومة الفردية، وأبرزنا خصائصه الفريدة التي اتسمت بالواقعية والصدق، وارتفعت به عن فاحش القول، مركزةً على المخازي الأخلاقية لا العاهات الجسدية. إن الهجاء في الشعر الجاهلي، بهذا الفهم، يغدو وثيقة تاريخية ونفسية لا تقدر بثمن؛ فهو لم يكن أداة هدم فحسب، بل كان أداة لترسيم الحدود الأخلاقية والاجتماعية، وسلاحاً للردع وحفظ الهيبة. وبذلك، تظل دراسته ضرورية لفهم العقلية العربية في ذلك العصر، وإدراك مدى قوة الكلمة وتأثيرها في صياغة الوعي وتوجيه السلوك.
الأسئلة الشائعة
١- ما الفرق الجوهري بين تعريف الهجاء لغةً واصطلاحاً في سياق الشعر الجاهلي؟
الإجابة: لغةً، الهجاء هو الشتم بالشعر بشكل عام. أما اصطلاحاً، فهو غرض شعري منظم يتناول فيه الشاعر بالذم والتشهير عيوب خصمه المعنوية والخلقية، وهو بذلك نقيض المدح الذي يعدد الفضائل.
٢- لماذا كان العرب يخشون الهجاء في العصر الجاهلي إلى هذا الحد؟
الإجابة: بسبب أثره العميق والمستمر في تشويه سمعة الفرد والقبيلة، وارتباطه في أذهانهم بقوى خارقة كالسحر وشياطين الشعر، مما يجعله سلاحاً نفسياً يصعب محو أثره عبر الأجيال.
٣- هل اقتصر الهجاء الجاهلي على السباب والقذف فقط؟
الإجابة: لا، بل تميز الهجاء الجاهلي بارتفاعه عن الإقذاع والسباب المباشر في معظمه. حيث ركز أكاديمياً على نقد الرذائل الأخلاقية مثل الجبن والبخل والغدر، وتضمن أشكالاً راقية من النقد الاجتماعي والتوجيه الخلقي.
٤- ما الذي يميز الهجاء في الشعر الجاهلي عن نقائض العصر الأموي؟
الإجابة: تميز الهجاء الجاهلي بصدقه، وتركيزه على المخازي العامة، وتجنبه الفحش وهتك الأعراض. بينما انحدرت نقائض العصر الأموي في كثير من الأحيان إلى السباب الشخصي، والتهاتر، والولغ في الأنساب والأعراض بشكل أكثر حدة.
٥- ما هي الدوافع الرئيسية التي كانت تحرك الشاعر الجاهلي لنظم قصائد الهجاء؟
الإجابة: الدوافع الرئيسية كانت الغضب الشخصي الناتج عن إهانة، والصراعات القبلية للدفاع عن شرف القبيلة، والتنافس بين الشعراء، بالإضافة إلى استخدامه كوسيلة للردع والتهديد لاسترداد حق أو منع عدوان.
٦- ما الفرق بين “الهجاء القبلي” و”الهجاء الشخصي” في الشعر الجاهلي؟
الإجابة: الهجاء القبلي يستهدف جماعة أو قبيلة بأكملها، ويركز على صفات جماعية سلبية كالهزيمة في الحرب أو خفر الذمم. أما الهجاء الشخصي فيستهدف فرداً بعينه، ويركز على عيوبه الشخصية كنسبه أو جبنه أو بخله، وإن كان قد يمتد أحياناً ليشمل أسرته أو قومه.
٧- لماذا لم يركز الهجاء الجاهلي على العيوب الجسدية (العاهات)؟
الإجابة: لأن القصد من الهجاء كان إصلاحياً أو رادعاً، ويهدف إلى كف الأذى ونقد المخازي الخلقية التي تعد مصدر الشر. أما السخرية من العاهات الجسدية فكانت تعتبر ضعفاً واستطالة على خلق الله، ولا تحقق الغاية الأخلاقية من الهجاء.
٨- ما هو دور “الرد على الخصوم” كنوع من أنواع الهجاء؟
الإجابة: كان هذا النوع بمثابة بداية لفن “النقائض”، حيث يمثل ترافعاً شعرياً بين شاعرين، يختلط فيه الفخر بالذم. ولم يكن الهدف منه الإفحام بقدر ما كان يهدف إلى الدفاع عن النفس والقبيلة، وزجر الخصم ودعوته للاحتكام إلى العقل أو السيف.
٩- هل كان الهجاء يأتي في قصائد طويلة مستقلة؟
الإجابة: غالباً لا. من خصائص الهجاء الجاهلي أنه كان يأتي في مقطوعات قصيرة، أو ينضوي ضمن أغراض أخرى في القصيدة كالفخر. هذا القصر ساهم في سهولة رواجه وسرعة انتشاره بين الناس.
١٠- كيف يمكن اعتبار الهجاء مصدراً لدراسة القيم الأخلاقية في العصر الجاهلي؟
الإجابة: يعتبر الهجاء مرآة عكسية للقيم المثلى؛ فمن خلال معرفة ما كان يُذم به (كالبخل، الجبن، الغدر، إهانة الجار)، يمكننا أن نستنتج بدقة ما كان يُمدح ويُعتبر قيمة عليا (الكرم، الشجاعة، الوفاء، حماية الجار).