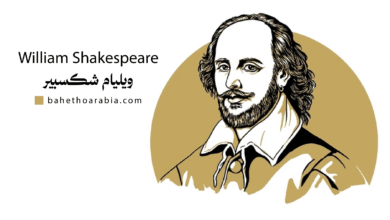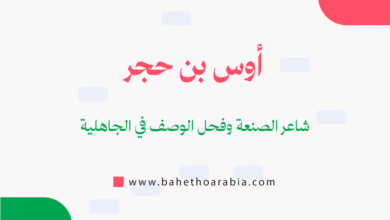ابن الأعرابي: شيخ اللغة وإمام الرواية وحافظ النوادر
دراسة أكاديمية في سيرة وحياة الإمام اللغوي محمد بن زياد وأثره في علوم العربية

يُعد أبو عبد الله محمد بن زياد، المعروف بلقب ابن الأعرابي، أحد أبرز الأعلام في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، وشخصية محورية في علوم اللغة والأدب خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. لقد كان ابن الأعرابي جبلاً من جبال الحفظ، وبحراً من بحور العلم، وإماماً لا يُشق له غبار في معرفة لغة العرب وأشعارها وأنسابها وأيامها.
إن الحديث عن ابن الأعرابي هو حديث عن ذاكرة أمة بأكملها، وعن مرحلة تاريخية فريدة شهدت نضوج العلوم اللغوية وتدوينها على أوسع نطاق. لقد ترك ابن الأعرابي بصمة لا تُمحى في مسيرة اللغة العربية، فكان شيخاً لتلامذة أصبحوا نجوماً في سماء العلم، مثل الإمام أبي العباس ثعلب، الذي لازمه لسنوات طوال ونهل من علمه الغزير. هذه المقالة تسعى إلى تقديم صورة أكاديمية شاملة عن حياة هذا الإمام الجليل، وتتبع مسيرته العلمية، ومنهجه في الرواية، ومكانته بين علماء عصره، وإرثه الذي لا يزال حياً حتى يومنا هذا.
مقدمة في حياة ابن الأعرابي
هو أبو عبد الله محمد بن زياد، مولى بني هاشم، وقد عُرف واشتهر بلقب “ابن الأعرابي”. وُلد في مدينة الكوفة عام ١٥٠ للهجرة (٧٦٧م)، وهي آنذاك أحد أهم المراكز العلمية والثقافية في العالم الإسلامي. نشأ ابن الأعرابي في بيئة علمية خصبة، حيث كانت الكوفة تعج بحلقات العلماء واللغويين والمحدثين. كان والده عبداً من السند، مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي، وقد نال حريته لاحقاً. بعد وفاة والده، تزوجت أمه من اللغوي الشهير المفضل الضبي، صاحب “المفضليات”، فأصبح ابن الأعرابي ربيباً له، مما أتاح له فرصة نادرة للنهل من علمه منذ نعومة أظفاره.
لقد تميز عصر ابن الأعرابي بنشاط علمي لا مثيل له، حيث كانت الدولة العباسية في أوج قوتها وازدهارها، وكان الخلفاء، مثل المأمون، يولون اهتماماً كبيراً بالعلماء ويشجعون حركة الترجمة والتأليف. في هذا الجو المشحون بحب العلم، وجد ابن الأعرابي ضالته، فأقبل على حلقات الدرس بشغف لا يعرف الكلل، متنقلاً بين الشيوخ، يجمع اللغة من أفواه الأعراب الفصحاء، ويحفظ الأشعار، ويدون الأخبار والأنساب. كانت شخصيته الفذة وقوة ذاكرته الأسطورية عاملين حاسمين في تكوينه العلمي، فقد عُرف عنه أنه لم يكن يحمل كتاباً في مجلسه قط، بل كان يملي على تلاميذه من حفظه ما يملأ كتباً وأسفاراً.
إن المكانة التي تبوأها ابن الأعرابي لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتاج رحلة طويلة من الكد والاجتهاد، وسيرة حافلة بالعطاء العلمي. وصفه الإمام الذهبي بأنه “إمام اللغة”، وقال عنه تلميذه النجيب ثعلب: “انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي”. هذه الشهادات وغيرها تبرهن على العمق العلمي والتأثير الكبير الذي أحدثه ابن الأعرابي في مجاله، فهو لم يكن مجرد ناقل للعلم، بل كان إماماً محققاً، وناقداً بصيراً، ومرجعاً موثوقاً في أدق مسائل اللغة والشعر. لقد كانت حياة ابن الأعرابي مثالاً للعالم الموسوعي الذي جمع بين علوم متعددة، فكان لغوياً، وراوية للشعر، وعالماً بالأنساب وأيام العرب، ومحدثاً ثقة، مما جعله أحد أهم ركائز المدرسة الكوفية في اللغة.
النشأة والرحلة في طلب العلم
وُلد ابن الأعرابي في الكوفة عام ١٥٠هـ، ونشأ في كنف أسرة متصلة بالعلم والأدب. كانت طفولته المبكرة تحت رعاية المفضل الضبي، زوج أمه، الذي كان من كبار رواة الشعر وعلماء اللغة، وقد أتاح له هذا الجو العائلي الفريد أن يتشرب حب اللغة والشعر منذ صغره. لقد قرأ على المفضل وسمع منه دواوين الشعراء وصححها عليه، فكانت هذه المرحلة بمثابة التأسيس المتين لمسيرته العلمية اللاحقة. لم يكتفِ ابن الأعرابي بما تلقاه في بيته، بل كان شغوفاً بالبحث عن المعرفة أينما كانت، فجاب البوادي والقفار للقاء الأعراب الفصحاء، والمشافهة عنهم، والأخذ من منابع اللغة الصافية.
كانت رحلات ابن الأعرابي العلمية جزءاً لا يتجزأ من تكوينه، فقد فهم بفطرته أن اللغة لا تُؤخذ من بطون الكتب فحسب، بل هي كائن حي ينبض في ألسنة أهلها. لهذا السبب، لازم قبائل بني أسد وبني عقيل وغيرهم من القبائل العربية الأصيلة، وسمع منهم واستكثر، فجمع من الغرائب والنوادر اللغوية ما لم يحفظه غيره. هذه التجربة الميدانية منحته ثقة كبيرة في علمه، وجعلته لا يتردد في نقد كبار معاصريه من اللغويين مثل الأصمعي وأبي عبيدة، حيث كان يرى أن علمهما سطحي مقارنة بما سمعه مباشرة من الأعراب. وقد نُقل عنه قوله في كلمة رواها الأصمعي: “سمعتها من ألف أعرابي بخلاف هذا”، مما يدل على مدى اعتداده بروايته المباشرة.
لم تقتصر رحلة ابن الأعرابي على طلب اللغة من البادية، بل شملت أيضاً التتلمذ على أيدي كبار علماء عصره في المراكز الحضرية. ففي الكوفة وبغداد، لازم شيوخاً أجلاء في مختلف الفنون، من اللغة والنحو إلى الحديث والفقه. هذا التنوع في مصادر المعرفة صقل شخصيته العلمية وجعل منه عالماً موسوعياً يجمع بين الرواية والدراية. وقد اتصل بالخليفة المأمون ونال حظوة لديه، مما فتح له أبواباً أوسع لنشر علمه وعقد مجالسه التي كان يحضرها المئات من طلاب العلم. إن سيرة ابن الأعرابي في طلب العلم هي قصة مثابرة وشغف، وتجسيد حي لروح العصر الذي كان يقدّر المعرفة ويحتفي بالعلماء، وقد أثمرت هذه الرحلة الشاقة إماماً فذاً أصبح هو نفسه منارة يهتدي بها طلاب العلم من بعده.
شيوخه ومصادر علمه
استقى ابن الأعرابي علمه الغزير من معين لا ينضب من الشيوخ والعلماء، الذين كانوا يمثلون قمم الفكر والمعرفة في زمانهم. لقد كان حريصاً على التنوع في الأخذ، فلم يقصر نفسه على فن واحد أو شيخ بعينه، بل كان كالنحلة التي تجمع الرحيق من أزهار مختلفة لتنتج عسلاً مصفى. ويمكن تقسيم مصادر علمه إلى قسمين رئيسيين: الأخذ المباشر من الأعراب في البوادي، والتلقي عن الشيوخ العلماء في الحواضر. هذا المنهج المزدوج هو ما أعطى علم ابن الأعرابي عمقاً وأصالة لا تضاهى.
كانت رعاية المفضل الضبي له في صغره هي الانطلاقة الحقيقية لمسيرة ابن الأعرابي العلمية. فالمفضل لم يكن مجرد زوج لأمه، بل كان معلماً ومربياً فتح عينيه على كنوز الشعر العربي القديم وأسرار اللغة. وقد أخذ عنه الكثير، وصحح عليه دواوين الشعراء، مما أكسبه أساساً متيناً في الرواية الشعرية. بالإضافة إلى المفضل، تتلمذ ابن الأعرابي على يد مجموعة من كبار الأئمة الذين شكلوا عقله وصقلوا معارفه، فكان لكل منهم أثر بارز في جانب من جوانب شخصيته العلمية.
من أبرز الشيوخ الذين نهل منهم ابن الأعرابي العلم، والذين كانوا نجوماً في سماء المعرفة آنذاك:
المفضل الضبي (توفي نحو ١٧٠هـ): كان زوج أمه وراعيه الأول، وهو صاحب “المفضليات” الشهيرة. أخذ عنه ابن الأعرابي الشعر القديم وروايته، وتعتبر هذه الصحبة من أهم مراحل تكوينه المبكر.
القاسم بن مَعْن الكوفي (توفي ١٧٥هـ): كان قاضياً ومحدثاً ولغوياً كبيراً، وهو حفيد الصحابي عبد الله بن مسعود. أخذ عنه ابن الأعرابي اللغة والحديث والفقه، وتأثر بمنهجه الذي يجمع بين العلم والورع.
أبو الحسن الكسائي (توفي ١٨٩هـ): وهو أحد القراء السبعة وإمام المدرسة الكوفية في النحو. صحب ابن الأعرابي الكسائي وأخذ عنه النحو والنوادر اللغوية، مما أثرى جانبه النحوي وجعله ملماً بأصول الصناعة الإعرابية على مذهب أهل الكوفة.
أبو معاوية الضرير (توفي ١٩٥هـ): هو محمد بن خازم، كان من كبار المحدثين الثقات. روى عنه ابن الأعرابي الحديث النبوي، وكان هذا الأخذ مصدراً مهماً لتوثيقه في علم الحديث، حيث اعتبره العلماء صدوقاً في روايته.
منهجه في الرواية اللغوية
تميز ابن الأعرابي بمنهج فريد في الرواية اللغوية، يقوم على ركائز متينة من الحفظ الدقيق، والتحري المباشر، والثقة المطلقة بالنفس. لم يكن ابن الأعرابي مجرد ناقل سلبي للمادة اللغوية، بل كان محققاً ومدققاً، يعتمد على ذاكرته الاستثنائية التي كانت مضرب الأمثال. وقد شهد له تلميذه ثعلب بأنه لازمه لسنوات طويلة لم يره يحمل فيها كتاباً قط، بل كان يجيب عن كل ما يُسأل عنه من حفظه، وقد أملى على الناس من علمه ما يحتاج لحمله إلى جمال. هذه القدرة الفائقة على الحفظ جعلت من صدره خزانة للغة العرب وأشعارهم وأخبارهم.
كان أساس منهج ابن الأعرابي هو الأخذ المباشر من الأعراب الفصحاء في البادية. لقد رأى أن اللغة الحقيقية هي تلك التي تُسمع من أهلها دون وسائط، ولذلك كان يكثر من الترحال والسماع من القبائل العربية الأصيلة. هذا المنهج الميداني (Fieldwork) منحه مادة لغوية غنية وأصيلة، وجعله يثق برواياته ثقة عمياء، إلى درجة أنه كان يتحدى كبار أئمة اللغة في عصره كالأصمعي وأبي عبيدة، ويزعم أنهما لا يحسنان من اللغة إلا القليل. لم يكن هذا التحدي نابعاً من الغرور بقدر ما كان نابعاً من إيمانه الراسخ بأن ما سمعه بنفسه من آلاف الأعراب هو الحجة القاطعة التي لا تقبل الجدال.
من السمات البارزة الأخرى في منهج ابن الأعرابي، أنه كان يجمع بين الرواية والنقد. لم يكن يقبل كل ما يسمع دون تمحيص، بل كان يقارن بين الروايات ويستدرك على سابقيه ويصحح الأخطاء. ومع ذلك، فإن اعتماده الكلي على الذاكرة وعدم تدوينه لعلمه في كتب منظمة بنفسه جعل بعض العلماء يلاحظون أن كتبه التي جُمعت عنه بعد وفاته كانت عبارة عن رقاق وأوراق متفرقة. ورغم ذلك، أجمعوا على أنه كان من أوثق الناس في الرواية الشفهية. لقد كان ابن الأعرابي يمثل ذروة عصر الرواية الشفهية، حيث كان العالم هو الكتاب، وذاكرته هي المكتبة، وقد انتهى إليه الحفظ وعلم اللغة في زمانه بشهادة معاصريه.
ابن الأعرابي راوياً للشعر العربي
احتل الشعر العربي مكانة مركزية في المنظومة المعرفية لدى ابن الأعرابي، فلم يكن الشعر بالنسبة له مجرد فن للتسلية، بل كان “ديوان العرب” الحقيقي، والمصدر الأسمى لتوثيق اللغة، وفهم غريبها، ومعرفة أيام العرب وأنسابهم. لقد ورث هذا الشغف بالشعر عن ربيبه المفضل الضبي، الذي غرس فيه حب الشعر القديم وأصول روايته. وبفضل ذاكرته الجبارة، استطاع ابن الأعرابي أن يحفظ كماً هائلاً من القصائد والدواوين، حتى قيل إنه لم يُرَ أحد في علم الشعر أغزر منه.
لم تقتصر علاقة ابن الأعرابي بالشعر على الحفظ والرواية فحسب، بل امتدت إلى الشرح والتفسير واستخراج المعاني الدقيقة. فمن بين مصنفاته التي وصلتنا أسماؤها كتب مثل “معاني الشعر” و”أبيات المعاني” و”شعر الأخطل”، وهي تدل على اهتمامه العميق بتحليل النصوص الشعرية وفك مغاليقها. كان منهجه في التعامل مع الشعر يقوم على اعتباره حجة لغوية، فكان يستشهد بالأبيات لإثبات قاعدة نحوية أو تأصيل لفظة غريبة. هذه النظرة إلى الشعر كمصدر تشريعي للغة كانت سمة بارزة للمدرسة اللغوية في عصره، وكان ابن الأعرابي أحد أبرز ممثليها.
كان مجلس ابن الأعرابي حافلاً برواية الشعر وإنشاده، وكان تلاميذه، وعلى رأسهم ثعلب، يتلقون عنه دواوين الفحول من الشعراء الجاهليين والإسلاميين. وقد أملى عليهم من محفوظه الشعري ما لا يحصى، وكان يتمتع بقدرة عجيبة على استحضار الشواهد الشعرية المناسبة لكل سياق. إن الدور الذي لعبه ابن الأعرابي في الحفاظ على التراث الشعري العربي لا يقدر بثمن، ففي عصر سبق التدوين الواسع، كانت صدور الحفاظ أمثال ابن الأعرابي هي المكتبات التي حفظت لنا هذا الإرث العظيم من الضياع، وقد انتقل هذا التراث عبر تلاميذه إلى الأجيال اللاحقة، ليكون أساساً قامت عليه دراسات الأدب والنقد فيما بعد.
مكانته في رواية الحديث النبوي
على الرغم من أن شهرة ابن الأعرابي الطاغية كانت في مجال اللغة والشعر والأدب، إلا أنه كان له أيضاً إسهام معتبر في علم الحديث النبوي، وقد حظي بثقة علماء الجرح والتعديل. لم يكن ابن الأعرابي من المكثرين في رواية الحديث كالمحدثين المتخصصين، ولكنه كان يروي ما سمعه عن شيوخه بإتقان وأمانة، مما جعله يحتل مرتبة “الصدوق” في ميزان النقد الحديثي. هذه المكانة تضفي على شخصيته العلمية بعداً آخر، وتوضح أنه كان ينهج نهج العلماء الشموليين الذين لا يحصرون أنفسهم في تخصص واحد.
روى ابن الأعرابي الحديث عن شيوخ ثقات، أبرزهم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وهو من كبار رواة الحديث في عصره. كما روى عن القاسم بن معن وغيرهم. وبالمقابل، روى عنه الحديث تلامذة أجلاء أصبحوا فيما بعد منارات في العلم، مثل إبراهيم الحربي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو شعيب الحراني، بالإضافة إلى تلميذه اللغوي الشهير ثعلب. إن وجود أسماء هؤلاء الأئمة في سلسلة الرواة عنه وعن شيوخه يدل على أن ابن الأعرابي كان جزءاً من شبكة الإسناد المعتبرة في عصره.
وصفه العلماء بأوصاف تدل على مكانته في هذا الجانب، فقال عنه الأزهري: “كان رجلاً صالحاً، ورعاً، زاهداً، صدوقاً”. وقال عنه الذهبي: “كان صاحب سنة واتباع”. هذه الشهادات تؤكد على ديانته وورعه والتزامه بمنهج أهل السنة، وهي صفات أساسية لقبول رواية المحدث. كما أن منهجه العلمي الصارم في تحري اللغة ودقتها انعكس على تعامله مع نصوص الحديث، فكان حريصاً على نقلها كما سمعها. وقد جمع ابن الأعرابي بين علوم اللغة والحديث، فكانت طرائقه في التعليم تشبه طرائق الفقهاء وجلة شيوخ المحدثين، مما أكسب مجلسه هيبة ووقاراً.
تلاميذه والنجوم التي أضاءت سماء علمه
كان مجلس ابن الأعرابي بمثابة جامعة مفتوحة، يقصدها طلاب العلم من كل حدب وصوب، وقد ذكر تلميذه ثعلب أن مجلسه كان يحضره زهاء مئة إنسان. لقد تخرج على يديه جيل من العلماء الذين حملوا لواء المعرفة من بعده، وأصبحوا نجوماً ساطعة في سماء الثقافة العربية. لم يكن ابن الأعرابي مجرد معلم يلقن المعلومات، بل كان مربياًملهماً، يغرس في تلاميذه حب التحقيق، والثقة بالنفس، والشغف باللغة العربية. إن عظمة الأستاذ تتجلى في عظمة تلاميذه، وبهذا المقياس، فإن ابن الأعرابي يعد من أعظم الأساتذة في تاريخنا.
كان تأثير ابن الأعرابي على تلاميذه عميقاً ودائماً، فقد نقل إليهم منهجه في الرواية، وحبه للشعر، ودقته في اللغة. وقد أصبح العديد منهم أئمة يقتدى بهم، وواصلوا مسيرة شيخهم في خدمة علوم العربية. ومن أشهر هؤلاء التلاميذ الذين لازموه ونهلوا من علمه الغزير:
أبو العباس ثعلب (توفي ٢٩١هـ): هو أحمد بن يحيى الشيباني، أشهر تلاميذ ابن الأعرابي على الإطلاق وإمام الكوفيين في النحو واللغة بعد شيخه. لازم ثعلب شيخه ابن الأعرابي تسع عشرة سنة، أو بضع عشرة سنة كما في رواية أخرى، وكان شديد الإعجاب به. وقد كان ابن الأعرابي نفسه يثق في حفظ تلميذه ثعلب، فإذا شك في شيء قال له: “ما تقول يا أبا العباس في هذا؟”.
يعقوب بن السكيت (توفي ٢٤٤هـ): وهو لغوي شهير وصاحب كتاب “إصلاح المنطق”. أخذ عن ابن الأعرابي اللغة والشعر، وكان من أبرز علماء عصره.
إبراهيم الحربي (توفي ٢٨٥هـ): الإمام الفقيه المحدث اللغوي، كان من كبار العلماء في بغداد، وقد روى عن ابن الأعرابي اللغة والحديث.
شمر بن حمدويه الهروي: كان من الملازمين لابن الأعرابي، وجالس مجالسه دهراً طويلاً، وسمع منه دواوين الشعر وتفسير غريبها.
أبو عكرمة الضبي: من رواة اللغة والأدب، وهو ممن أخذ عن ابن الأعرابي.
عثمان بن سعيد الدارمي (توفي ٢٨٠هـ): الإمام المحدث، صاحب السنن، روى عن ابن الأعرابي.
مؤلفاته وآثاره الخالدة
على الرغم من أن ابن الأعرابي كان يعتمد بشكل أساسي على ذاكرته الهائلة في التعليم والإملاء، ولم يكن من عادته حمل الكتب أو التأليف المنظم، إلا أن غزارة علمه الذي أملاه على تلاميذه شكل مادة علمية ضخمة جُمعت بعد وفاته في مصنفات ورسائل عديدة تحمل اسمه. هذه المؤلفات، التي وصلتنا أسماؤها وبعضها وصلتنا نصوصه، تعكس الطبيعة الموسوعية لمعارف ابن الأعرابي واهتماماته المتشعبة التي غطت مختلف جوانب اللغة والأدب والتاريخ الطبيعي.
لقد كانت مؤلفات ابن الأعرابي بمثابة كنوز معرفية، كل منها يضيء جانباً من جوانب الثقافة العربية. فعندما نتأمل قائمة كتبه، نجد أنها تتناول موضوعات متنوعة من أسماء الخيل إلى تاريخ القبائل، ومن تفسير الأمثال إلى نوادر اللغة. هذا التنوع يدل على سعة أفق ابن الأعرابي وقدرته على الخوض في ميادين معرفية مختلفة بنفس الكفاءة والاقتدار.
تُنسب إلى ابن الأعرابي مجموعة كبيرة من التصانيف، التي تمثل إرثه العلمي المكتوب. ومن أبرز هذه المؤلفات التي ذكرتها المصادر:
كتاب النوادر: وهو من أشهر كتبه، وقد جمع فيه الغرائب والطرائف اللغوية والأدبية. ويوجد مخطوط باسم “نوادر ابن الأعرابي” لا يزال محفوظاً.
تاريخ القبائل: كتاب يعنى بأنساب العرب وأخبارهم، وهو يعكس معرفته العميقة بهذا العلم.
أسماء الخيل وفرسانها: وهو كتاب متخصص في موضوع الخيل، أسمائها وأنسابها وأخبار فرسانها، وقد طُبع هذا الكتاب بتحقيقات متعددة.
تفسير الأمثال (أو تنسيق الأمثال): كتاب يتناول الأمثال العربية بالشرح والتفسير، وهو ميدان برع فيه ابن الأعرابي.
معاني الشعر: يدل على منهجه في تحليل النصوص الشعرية واستخراج معانيها.
شعر الأخطل: جمع وتحقيق لديوان الشاعر الأموي الشهير الأخطل.
كتب ورسائل متخصصة: مثل كتاب “الأنواء”، و”النخل”، و”صفة الزرع”، و”النباتات”، و”البئر”، و”الذباب”، وهي تدل على اهتمامه بالتاريخ الطبيعي والمصطلحات المتعلقة بالبيئة والحياة اليومية للعرب.
الثناء عليه: شهادات أهل العلم
حظي ابن الأعرابي بتقدير واحترام كبيرين من قبل العلماء في عصره وبعده، وتواترت شهاداتهم التي تشيد بعلمه الغزير، وحفظه النادر، ومكانته الرفيعة في علوم اللغة والأدب. هذه الشهادات، التي جاءت من تلاميذه وأقرانه ومؤرخي العلم، ترسم صورة مشرقة لهذا الإمام الجليل، وتؤكد على الدور المحوري الذي لعبه في تاريخ الثقافة العربية. إن إجماع كلمة العلماء على فضله هو أكبر دليل على عظيم أثره ورسوخ قدمه في العلم.
لعل أبرز الشهادات وأكثرها قيمة هي تلك التي جاءت من تلميذه النجيب أبي العباس ثعلب، الذي لازمه قرابة عقدين من الزمن وكان أعرف الناس بفضل شيخه. قال ثعلب، وهو نفسه إمام في اللغة: “انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي”. وفي شهادة أخرى تفصيلية، يصف ثعلب مجلس شيخه قائلاً: “شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مئة إنسان، كان يسأل ويقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه”. هذه الصورة الحية التي ينقلها ثعلب تبرز قوة ذاكرة ابن الأعرابي الخارقة ومكانته كمرجع علمي لا يضاهى.
ولم يقتصر الثناء على تلاميذه، بل جاء أيضاً من كبار العلماء والمؤرخين. فالإمام الذهبي، في كتابه “سير أعلام النبلاء”، يصفه بـ “إمام اللغة” ويؤكد على سعة علمه. أما الأزهري، صاحب “تهذيب اللغة”، فيثني على جانبه الشخصي والأخلاقي إلى جانب علمه، فيقول: “كان أبو عبد الله بن الأعرابي كوفي الأصل، رجلاً صالحاً، ورعاً، زاهداً، صدوقاً، وحفظ من الغرائب ما لم يحفظه غيره”. ويضيف أبو جعفر الأصبهاني النحوي بعداً آخر لهذه الشخصية، فيقول إن طرائق ابن الأعرابي كانت “طرائق الفقهاء والعلماء ومذاهب جلة شيوخ المحدثين”، ويصفه بأنه كان “أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب”. هذه الشهادات المتضافرة تجعل من ابن الأعرابي شخصية علمية فذة، جمعت بين سعة المعرفة، وقوة الحافظة، والورع، والمنهجية الرصينة.
الجانب النقدي في شخصيته العلمية
لم يكن ابن الأعرابي مجرد وعاء حافظ للعلم، بل كان يمتلك شخصية علمية نقدية قوية، وروحاً وثابة لا تتردد في مقارعة الحجة بالحجة وتحدي كبار أئمة عصره. هذا الجانب النقدي هو الذي منحه تفرده وميزه عن غيره من الرواة والنقلة. كانت ثقته بنفسه، المستمدة من أخذه المباشر عن الأعراب، هي سلاحه الذي يشهره في وجه من يخالفه، حتى لو كان بحجم الأصمعي أو أبي عبيدة، وهما من هما في عالم اللغة والأدب آنذاك.
كان ابن الأعرابي يرى أن كثيراً مما يرويه هؤلاء الأئمة يخالف ما سمعه هو بأذنه من منابع اللغة الصافية. وقد نُقل عنه زعمه بأن “الأصمعي، وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا كثيرا”. بل إنه قال مرة في لفظة رواها الأصمعي: “سمعتها من ألف أعرابي بخلاف هذا”. قد تبدو هذه الأقوال حادة، لكنها في جوهرها تعبر عن منهج علمي صارم يؤمن بأن المشافهة المباشرة من الأعرابي الفصيح هي أعلى درجات التوثيق اللغوي، وأنها مقدمة على الرواية بالوسائط. لقد كان ابن الأعرابي يمثل المدرسة الميدانية في البحث اللغوي بأصدق صورها.
هذه الروح النقدية لم تكن موجهة للخارج فقط، بل كانت جزءاً من منهجه العقدي أيضاً. فعندما سُئل عن معنى “استوى” في قوله تعالى “الرحمن على العرش استوى”، وفسرها أحدهم بمعنى “استولى”، رفض ابن الأعرابي هذا التفسير رفضاً قاطعاً من منطلق لغوي دقيق، قائلاً إن العرب لا تستعمل “استولى” إلا في حال وجود مضاد ومغالبة، والله لا مضاد له. هذا الموقف يظهر كيف كان يوظف علمه اللغوي العميق للدفاع عن عقيدة أهل السنة وتفنيد تأويلات الفرق الأخرى، مما يؤكد شهادة الذهبي بأنه كان “صاحب سنة واتباع”. إن شخصية ابن الأعرابي النقدية هي التي جعلته إماماً مجتهداً وليس مجرد ناقل مقلد.
نوادره وأخباره: لمحات من حياته الشخصية
تزخر كتب التراجم والأدب بالعديد من النوادر والأخبار التي تروي جوانب من شخصية ابن الأعرابي وحياته اليومية، وهي تقدم لنا لمحات طريفة ومعبرة عن هذا العالم الجليل خارج إطار مجلس العلم الصارم. هذه النوادر، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى التوثيق التاريخي الدقيق، إلا أنها تكشف عن سرعة بديهته، وحضوره الذهني، وطبيعته الإنسانية. لقد كان ابن الأعرابي، برغم هيبته العلمية، شخصية محبوبة، وكان مجلسه لا يخلو من الطرائف التي تكسر رتابة الدرس وتزيد من إقبال الطلاب عليه.
من الأخبار التي تبرز مكانته وقوة ذاكرته، ما رواه تلميذه ثعلب حين قال له ابن الأعرابي: “أمللت عليهم قبل أن تجيئني يا أحمد حمل جمل”. هذه العبارة البسيطة تصور لنا غزارة علمه الذي كان يتدفق من صدره كالنهر، وتوضح حجم المادة العلمية التي كان يمليها في جلسة واحدة. كما أن خبر ذهاب تلاميذه لشراء كتبه بعد وفاته، ووجدانهم أنها مجرد “رقاقا، وأوراقا، ورقاعا”، يؤكد على الصورة التي رسمها له معاصروه: عالم كتابه في صدره، لا في أوراقه.
لم تكن حياة ابن الأعرابي خالية من بعض السمات الشخصية التي لاحظها من حوله، فقد ذكرت المصادر أنه كان “أحول”. وهذه التفصيلات الصغيرة، التي قد تبدو غير مهمة، تضفي على سيرته بعداً إنسانياً وتقربنا من شخصيته. كما أن زهده وورعه كانا من أبرز صفاته، فقد وصفه الأزهري بأنه كان “صالحاً زاهداً ورعاً”. هذه الأخلاق العالية، المقترنة بالعلم الغزير، هي التي صنعت من ابن الأعرابي قدوة تحتذى، وجعلت سيرته مصدراً للإلهام ليس فقط في مجال العلم، بل في مجال السلوك والأخلاق أيضاً.
وفاته وإرثه اللغوي
بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، امتدت لأكثر من ثمانين عاماً، رحل إمام اللغة وحافظها ابن الأعرابي عن الدنيا، تاركاً وراءه إرثاً علمياً ضخماً وتلاميذ نجباء حملوا علمه ونشروه في الآفاق. توفي ابن الأعرابي في مدينة “سُرَّ من رأى” (سامراء) عام ٢٣١هـ (٨٤٥م)، وقيل أيضاً عام ٢٣٢هـ. كانت وفاته في خلافة الواثق بن المعتصم، وقد بلغ من العمر ثمانين أو إحدى وثمانين سنة. وبوفاته، فقدت الأمة الإسلامية واحداً من أعظم علمائها، وخزانة من كنوز اللغة والشعر لا تعوض.
إن الإرث الحقيقي الذي تركه ابن الأعرابي لا يتمثل فقط في الكتب التي نُسبت إليه، بل يكمن بشكل أساسي في التأثير العميق الذي أحدثه في مسار علوم العربية. لقد كان ابن الأعرابي حلقة وصل حيوية بين عصر الرواية الشفهية وعصر التدوين المنظم. فمن خلال إملائه لمادة لغوية وأدبية هائلة على تلاميذه، ساهم بشكل مباشر في حفظ هذه المادة وتدوينها في مصنفاتهم. ويعتبر تلميذه ثعلب، الذي أصبح إمام الكوفيين من بعده، هو الامتداد الطبيعي لمدرسة ابن الأعرابي ومنهجه.
لا يزال اسم ابن الأعرابي يتردد حتى اليوم في كل دراسة جادة تتناول اللغة العربية وتاريخها. فكتب اللغة والمعاجم والأدب مليئة بالنقول عنه، وآراؤه اللغوية لا تزال محط اهتمام الباحثين. لقد كان ابن الأعرابي بحق “شيخ اللغة”، وإماماً انتهت إليه رياستها في زمانه. إن دراسة سيرة هذا العالم الفذ لا تطلعنا على حياة شخصية عظيمة فحسب، بل تفتح لنا نافذة واسعة على عصر من أزهى عصور الحضارة الإسلامية، عصر كان فيه العلم هو المجد، والعلماء هم النجوم التي يهتدي بها السائرون. لقد صدق فيه قول الشاعر: “سَكَت الدَّهرُ زمانًا عنهم، ثم أبكاهم دمًا حين نَطَقْ”.
سؤال وجواب
١. من هو ابن الأعرابي وما هو اسمه الكامل؟ هو أبو عبد الله محمد بن زياد، مولى بني هاشم، وهو لغوي وراوية وشاعر من كبار أئمة اللغة في العصر العباسي. وُلد في الكوفة عام ١٥٠هـ، واشتهر بلقب ابن الأعرابي حتى كاد يطغى على اسمه الأصلي.
٢. بماذا اشتهر ابن الأعرابي بشكل أساسي في تاريخ العلم العربي؟ اشتهر ابن الأعرابي بكونه إماماً في اللغة، وحافظاً لا يُشق له غبار، وراوية للشعر وأيام العرب وأنسابهم. ويُعد من أهم أعمدة المدرسة الكوفية في اللغة، وقد انتهى إليه علم الحفظ والرواية في زمانه بشهادة معاصريه.
٣. ما هي أبرز سمات منهج ابن الأعرابي في الرواية اللغوية؟ كان منهجه يقوم على الحفظ الهائل، والأخذ المباشر من الأعراب الفصحاء في البوادي (المشافهة)، والثقة المطلقة بما يسمعه ويرويه. كان يرى أن السماع المباشر هو الحجة العليا، ولهذا كان ينتقد كبار علماء عصره كالأصمعي وأبي عبيدة.
٤. من هو أبرز تلاميذه وماذا قال عنه؟ أبرز تلاميذه على الإطلاق هو الإمام أبو العباس ثعلب، الذي لازمه لسنوات طويلة. وقد لخص ثعلب مكانة شيخه في عبارة بليغة حين قال: “انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي”.
٥. هل ترك ابن الأعرابي مؤلفات مكتوبة بنفسه؟ لم يكن ابن الأعرابي من المؤلفين الذين يدونون كتبهم بأنفسهم، بل كان يعتمد على ذاكرته في الإملاء على تلاميذه. وما يُنسب إليه من كتب هي في معظمها مجموعات جمعها تلاميذه من إملاءاته ومجالسه العلمية.
٦. ما هي مكانة ابن الأعرابي في علم الحديث النبوي؟ رغم أن شهرته الأساسية كانت في اللغة، إلا أنه كان له إسهام في رواية الحديث، وقد وثقه علماء الجرح والتعديل ومنحوه مرتبة “صدوق”. روى الحديث عن شيوخ ثقات مثل أبي معاوية الضرير، وروى عنه أئمة كإبراهيم الحربي.
٧. كيف كانت علاقته بالعلماء المعاصرين له مثل الأصمعي؟ كانت علاقته بهم تتسم بالنقد والتحدي العلمي، حيث كان شديد الثقة بعلمه المأخوذ مباشرة من البادية، وكثيراً ما كان يخطّئ الأصمعي وأبا عبيدة، ويرى أن علمهما سطحي مقارنة بما حصله هو بالمشافهة.
٨. من هم أبرز الشيوخ الذين أثروا في تكوينه العلمي؟ تأثر ابن الأعرابي بشيوخ كبار، أهمهم ربيبه المفضل الضبي الذي غرس فيه حب الشعر، وإمام النحو الكوفي أبو الحسن الكسائي، والمحدث اللغوي القاسم بن معن.
٩. ما هو الدور الذي لعبه ابن الأعرابي في الحفاظ على الشعر العربي القديم؟ لعب دوراً محورياً في الحفاظ على الشعر العربي بفضل ذاكرته الاستثنائية. ففي عصر سبق التدوين الواسع، كان صدره بمثابة خزانة حفظت كماً هائلاً من دواوين الشعر التي أملاها على تلاميذه، مما ساهم في وصولها إلينا.
١٠. متى وأين توفي ابن الأعرابي وما هو إرثه الأبرز؟ توفي في مدينة “سُرَّ من رأى” (سامراء) عام ٢٣١هـ. ويتمثل إرثه الأبرز في كونه حلقة وصل حيوية بين عصر الرواية الشفهية وعصر التدوين، حيث حفظت ذاكرته وإملاءاته مادة لغوية وأدبية ضخمة شكلت أساساً لكتب اللغة والأدب التي أُلفت بعده.