أركان التشبيه الأربعة: تحليل للمشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة
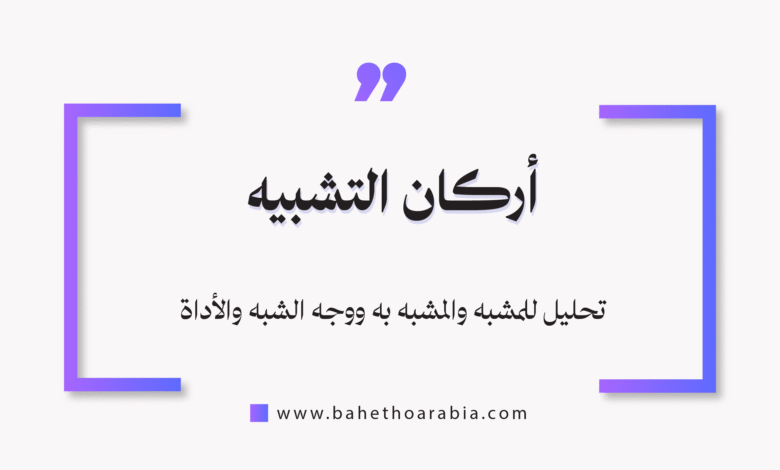
يُعد التشبيه أحد أعرق الفنون البلاغية وأكثرها رسوخًا في اللغة العربية، فهو الأداة التي تمنح المعاني وضوحًا وتأثيرًا من خلال عقد مماثلة بين أمرين يشتركان في صفة معينة. ولكي يقوم هذا البناء البياني على أسس سليمة، فإنه يرتكز على أربعة عناصر جوهرية تُعرف بـ أركان التشبيه. إن فهم أركان التشبيه هذه لا يمثل مدخلاً لدراسة التشبيه فحسب، بل هو المفتاح لإدراك عمق الصورة البلاغية وكيفية تشكيلها. تتألف أركان التشبيه من: المشبه، والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه، ويشكل تفاعلها معًا النسيج الفني الذي يميز هذا الأسلوب البياني الرفيع، والذي لا يكتمل إلا بحضور كافة أركان التشبيه الأساسية.
المشبّه
يُعرَّف المشبّه بأنه الطرف الأساسي في عملية التشبيه، وهو العنصر الذي يقصد المتكلم توضيح حاله أو إثبات صفة معينة له. إنه النقطة المحورية التي تُبنى عليها الصورة بأكملها ضمن منظومة أركان التشبيه، حيث يُجلب الطرف الثاني (المشبه به) لخدمته وإبراز إحدى سماته. لا يكتمل بناء التشبيه أو تتحقق أركان التشبيه مكتملة دون وجود هذا الركن، سواء كان مذكورًا صراحة أو مفهومًا من سياق الكلام.
أمثلة توضيحية:
١ – في قول الشاعر:
أنتَ نجمٌ في رفعةٍ وضياءٍ *** تجتليكَ العيونُ شرقًا وغربًا
شرح المثال: المشبّه هنا هو ضمير المخاطب “أنتَ”، وهو الممدوح الذي أراد الشاعر أن يثبت له صفة العلو والمكانة الرفيعة، فكان هو محور الصورة البيانية التي تعتمد على اكتمال أركان التشبيه.
٢ – وفي قول المتنبي:
وما أنا منهمْ بالعيشِ فيهمْ *** ولكنْ معدنُ الذهبِ الرَّغامُ
شرح المثال: المشبّه هو حال الشاعر “أنا” مع قومه، حيث يقيم بينهم لكنه لا يشعر بالانتماء إليهم لتميزه عنهم. هذه الحالة المعنوية هي التي أراد الشاعر توضيحها وإثبات إمكانها، وهي أساس هذا الركن من أركان التشبيه.
المشبّه به
المشبّه به هو الركن الثاني والطرف المقابل للمشبه في هيكل أركان التشبيه، ويُعرف بأنه الأمر الذي يُلحق به المشبه. يتميز المشبه به بكون الصفة المشتركة (وجه الشبه) فيه أكثر قوة ووضوحًا وشهرة، مما يجعله بمثابة المقياس أو النموذج الذي يُحتذى به لتوضيح حال المشبه. ويُطلق على المشبه والمشبه به معًا “طرفا التشبيه”، وهما عماد الصورة البلاغية، فلا يمكن تصور قيام أركان التشبيه دونهما.
أمثلة توضيحية:
١ – في قول أبي تمام:
يا صاحبيَّ تقصَّيا نظريكما *** تريا وجوهَ الأرضِ كيفَ تُصوَّرُ
تريا نهارًا مشمسًا قد شابَهُ *** زهرُ الرُّبى فكأنما هو مقمرُ
شرح المثال: المشبّه به في هذا البيت هو “الليل المقمر” (مفهوم من قوله: مقمر)، وهو جزء لا يتجزأ من أركان التشبيه في هذا السياق. وقد استُخدم لتوضيح هيئة النهار المشمس الذي خالطه زهر الربيع، فكان الليل المقمر هو الصورة المرجعية التي تتميز بوضوحها في الذهن.
٢ – وفي قول البحتري:
همُ البحورُ عطاءً حينَ تسألهمْ *** وفي اللقاءِ إذا تلقاهمُ بُهُمُ
شرح المثال: المشبّه به هنا هو “البحور”. وقد اختير هذا العنصر الأساسي من أركان التشبيه لأن صفة العطاء الواسع والكرم الفياض متجذرة في صورة البحر، مما يجعله أفضل نموذج لتوضيح كرم الممدوحين.
وجه الشبه
يمثل وجه الشبه المعنى أو الوصف الخاص الذي قصد المتكلم إثبات اشتراك الطرفين فيه، وهو من أدق أركان التشبيه معنىً. إنه الجسر الذي يربط بين المشبه والمشبه به، والعلة المنطقية التي تسوغ عقد المقارنة بينهما. ولكي يكون التشبيه بليغًا، يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى وأعرف منه في المشبه، وإلا فقدت الصورة البيانية قيمتها وفقدت أركان التشبيه غايتها البلاغية.
أمثلة توضيحية:
١ – في قول الشاعر:
العلمُ في الصدرِ مثلُ الشمسِ في الفلكِ *** والعقلُ للمرءِ مثلُ التاجِ للملكِ
شرح المثال: وجه الشبه في الشطر الأول هو “الهداية وكشف الظلمات”، فالعلم يكشف ظلمات الجهل كما تكشف الشمس ظلمات الليل، وهو رابط دقيق يبرز أهمية هذا الركن من أركان التشبيه. وفي الشطر الثاني، وجه الشبه هو “الزينة والرفعة”، فالعقل يزين الإنسان ويرفع قدره كما يزين التاج الملك.
٢ – وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: “مثلُ الذي يعلمُ الخيرَ ولا يعملُ بهِ مثلُ السراجِ يُضيءُ للناسِ ويحرقُ نفسَهُ”.
شرح المثال: وجه الشبه هنا هو هيئة مركبة تتمثل في “نفع الآخرين مع إلحاق الضرر بالنفس”. هذه الهيئة المركبة، التي تمثل وجه الشبه، هي التي أكملت أركان التشبيه بربطها بين العالم الذي لا يعمل بعلمه وبين السراج الذي ينير للغير ويحترق هو.
أداة التشبيه
أداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل صراحة على معنى المماثلة ويربط بين طرفي التشبيه. ويعد هذا العنصر من أركان التشبيه الأكثر مرونة من حيث الحضور والغياب، إذ إن ذكرها أو حذفها يؤثر مباشرة في تصنيف التشبيه وقوته البلاغية، مما يبرز أهمية دراسة جميع أركان التشبيه. وتأتي الأداة على هيئة:
- حرف: مثل “الكاف” و “كأنّ”.
- اسم: مثل “مِثل”، “شَبَه”، “نظير”.
- فعل: مثل “يشابه”، “يماثل”، “يحاكي”، “يضارع”.
أمثلة توضيحية:
١ – حرف (الكاف): في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾.
شرح المثال: استُخدم حرف الكاف للربط بين السفن الضخمة “الجوار المنشآت” والجبال “الأعلام” في صفة العظمة والضخامة، وهي أداة ظاهرة تكتمل بها أركان التشبيه.
٢ – حرف (كأنّ): في قول بشار بن برد:
كأنَّ مثارَ النقعِ فوقَ رؤوسِنا *** وأسيافَنا ليلٌ تهاوى كواكبُهْ
شرح المثال: استخدمت “كأنّ” لربط هيئة الغبار والسيوف (المشبه) بهيئة الليل والكواكب (المشبه به)، وهي تفيد التشبيه مع شيء من الظن أو التخيل، وتُظهر كيف تتفاعل أركان التشبيه لإنتاج معانٍ دقيقة.
٣ – اسم (مِثل): في قول المتنبي:
هذا الذي أبصرتَ منهُ حاضرًا *** مثلُ الذي أبصرتَ منهُ غائبًا
شرح المثال: استُخدم اسم “مثل” للدلالة على التطابق التام بين حالة الممدوح في حضوره وغيابه، مما يؤكد ثبات صفاته، ويعزز حضور أركان التشبيه بشكل صريح.
خلاصة
إن أركان التشبيه الأربعة تمثل معًا وحدة عضوية متكاملة، فالمشبه هو الموضوع، والمشبه به هو المقياس، ووجه الشبه هو الرابط المعنوي، والأداة هي الرابط اللفظي. ولا يمكن الوصول إلى عمق البلاغة الكامنة في أسلوب التشبيه إلا عبر التحليل الدقيق لكل مكون من مكونات أركان التشبيه. ويجب إدراك كيف أن التعامل مع أركان التشبيه، بذكرها أو حذفها أو ترتيبها، هو ما يصنع الفارق بين التعبير المباشر والصورة الفنية البديعة التي تخلب الألباب وتثير الخيال.
الأسئلة الشائعة
١ – هل يمكن الاستغناء عن أحد أركان التشبيه؟ وما هي الأركان الأساسية التي لا يقوم التشبيه إلا بها؟
الإجابة: نعم، يمكن الاستغناء بلاغيًا عن بعض أركان التشبيه، ولكن ليس جميعها. الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن حذفهما أبداً هما طرفا التشبيه: المشبه والمشبه به، إذ لا يمكن تصور قيام علاقة تشبيه دون وجود طرفين تُعقد بينهما المقارنة. أما الركنان اللذان يمكن حذفهما لأغراض بلاغية فهما أداة التشبيه ووجه الشبه. حذف الأداة يرفع التشبيه إلى مرتبة “التشبيه المؤكد”، وحذف وجه الشبه يجعله “تشبيهًا مجملًا”، وحذفهما معًا ينقل التعبير إلى أعلى درجات التشبيه وهو “التشبيه البليغ”، حيث يُدَّعى فيه اتحاد المشبه والمشبه به.
٢ – ما التأثير البلاغي لحذف أداة التشبيه ووجه الشبه؟
الإجابة: لحذف هذين الركنين تأثير بليغ وعميق في قوة الصورة البيانية. حذف أداة التشبيه يزيل الرابط الصريح بين الطرفين، مما يوهم السامع بأن المشبه هو عين المشبه به، وهذا يعزز قوة المماثلة ويحولها من مجرد مقارنة إلى تأكيد ومبالغة مقبولة. أما حذف وجه الشبه، فإنه يفتح المجال لخيال المتلقي ليتأمل في جميع الصفات المشتركة الممكنة بين الطرفين، وهذا يمنح التشبيه عمقًا واتساعًا دلاليًا، حيث لا يتم تقييد الصفة في جانب واحد، بل يُترك العقل يستدعي كل ما يربط بينهما. وعندما يُحذفان معًا في “التشبيه البليغ” (مثل: العلم نور)، يصل التعبير إلى ذروته البلاغية من خلال الإيجاز وقوة الادعاء باتحاد الطرفين.
٣ – ما هو الشرط الأساسي في “وجه الشبه” ليكون التشبيه بليغًا ومقبولًا؟
الإجابة: الشرط الأساسي الذي أجمع عليه البلاغيون هو أن تكون الصفة المشتركة (وجه الشبه) في المشبه به أقوى وأظهر وأشهر منها في المشبه. هذا الشرط هو جوهر عملية التشبيه وغايتها؛ فنحن نأتي بالمشبه به كنموذج مثالي لتوضيح صفة في المشبه لم تكن بنفس درجة الوضوح. على سبيل المثال، في قولنا “زيد كالأسد في الشجاعة”، فإن صفة الشجاعة متحققة في الأسد على نحو أصلي ومشهور ومعروف، بينما هي في زيد صفة تحتاج إلى إثبات وتوضيح. لو كانت الصفة أضعف في المشبه به، لفقد التشبيه قيمته البلاغية وأصبح معيبًا.
٤ – ما الفرق الدقيق في المعنى بين استخدام “الكاف” و”كأنّ” كأداتي تشبيه؟
الإجابة: على الرغم من أن كلتيهما أداتا تشبيه، إلا أن هناك فرقًا دلاليًا دقيقًا بينهما. الكاف تفيد معنى المماثلة المباشرة والمحققة، وهي تدخل على المشبه به مباشرة (مثل: وجهه كالقمر). أما كأنّ، فهي حرف مركب من كاف التشبيه و”أنّ” التي تفيد التوكيد، ولكنها في سياق التشبيه غالبًا ما تفيد الشك أو الظن أو التخيل، خاصة إذا كان وجه الشبه نادرًا أو غريبًا. كما أنها تدخل على المشبه (مثل: كأن وجهه قمر)، مما يجعل التشبيه بها جملة اسمية كاملة، وهذا يمنحها قوة تركيبية تفوق الكاف. لذلك، تُستخدم “كأن” غالبًا في الصور التي تتطلب تأملًا وتخيلاً، بينما تُستخدم الكاف في التشبيهات الأكثر وضوحًا ومباشرة.
٥ – كيف يتم تحديد أركان التشبيه في “التشبيه التمثيلي” الذي يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد؟
الإجابة: في التشبيه التمثيلي، لا تكون الأركان عناصر مفردة، بل هيئات وصور مركبة. المشبه يكون هيئة أو حالة مركبة من عدة أجزاء، والمشبه به يكون كذلك هيئة مركبة أخرى. أما وجه الشبه، فهو الرابط الأهم والأكثر تعقيدًا، حيث لا يكون صفة مفردة (كالشجاعة أو الجمال)، بل يكون “صورة منتزعة من متعدد”، أي الهيئة العقلية المشتركة الناتجة عن تفاعل أجزاء كلتا الصورتين. على سبيل المثال، في بيت بشار بن برد: “كأنَّ مثارَ النقعِ فوقَ رؤوسِنا *** وأسيافَنا ليلٌ تهاوى كواكبُهْ”، المشبه هو هيئة الغبار المتصاعد والسيوف اللامعة المتحركة فيه، والمشبه به هو هيئة الليل المظلم الذي تتساقط فيه الكواكب اللامعة، ووجه الشبه هو الصورة المنتزعة من وجود أجسام لامعة تتحرك بسرعة وعشوائية وسط محيط مظلم.
٦ – ما العلاقة بين حذف بعض أركان التشبيه ومفهوم “الاستعارة”؟
الإجابة: العلاقة وثيقة جدًا، حيث يعتبر البلاغيون أن الاستعارة هي في أصلها تشبيه بليغ حُذف أحد طرفيه. فإذا كان التشبيه البليغ يتكون من مشبه ومشبه به فقط (مثل: العلم نور)، فإن الاستعارة تقوم على حذف أحد هذين الطرفين الأساسيين مع ترك قرينة تدل على المحذوف. فإذا صرّحنا بالمشبه به وحذفنا المشبه، كانت الاستعارة “تصريحية” (مثل: رأيت أسدًا يحارب، والأصل: رأيت جنديًا كالأسد). وإذا حذفنا المشبه به وأبقينا على المشبه مع ذكر صفة من لوازم المشبه به المحذوف، كانت الاستعارة “مكنية” (مثل: حدثني التاريخ، حيث شُبّه التاريخ بإنسان يتكلم، ثم حُذف المشبه به “الإنسان” وأُبقي على لازمة من لوازمه وهي “التكلم”).
٧ – هل لترتيب أركان التشبيه في الجملة العربية أهمية بلاغية؟
الإجابة: نعم، لترتيب الأركان أهمية بلاغية تؤثر في المعنى والتركيز. الأصل في الترتيب هو أن يتقدم المشبه، ثم الأداة، ثم المشبه به، ثم وجه الشبه. ولكن يمكن الخروج عن هذا الأصل لأغراض بلاغية، كأن يتقدم المشبه به على المشبه للاهتمام به أو لتعظيم شأنه، كما في قول الشاعر “نجمٌ أنتَ في رفعةٍ وضياءٍ”، حيث قُدّم المشبه به “نجمٌ” على المشبه “أنت” لتعظيم الممدوح من بداية الكلام. كما يمكن تقديم وجه الشبه للاهتمام به أو لبيان أنه الصفة المحورية في المقارنة. هذا التقديم والتأخير يمنح المتكلم مرونة أسلوبية للتأكيد على الجانب الذي يريد إبرازه في الصورة البيانية.
٨ – ما هي الأغراض البلاغية الرئيسية التي يحققها استخدام التشبيه بأركانه الكاملة؟
الإجابة: يحقق التشبيه بأركانه الكاملة عدة أغراض بلاغية جوهرية، أهمها:
- توضيح المعنى: تقريب المعاني المجردة أو الغامضة إلى الذهن من خلال ربطها بصورة حسية مألوفة (مثل تشبيه العلم بالنور).
- تزيين المشبه أو تقبيحه: إضفاء صفة جمالية على المشبه بإلحاقه بشيء جميل (وجه كالقمر)، أو صفة قبيحة بإلحاقه بشيء قبيح (وجه كالشيطان).
- بيان حال المشبه ومقداره: تحديد مقدار الصفة في المشبه، كبيان إمكان حدوث أمر غريب (كما في بيت المتنبي عن بقائه في قوم لا يشبههم).
- تجسيد المعنويات: تحويل الأمور المعنوية غير المحسوسة إلى صور مادية محسوسة لتسهيل إدراكها (مثل تشبيه الموت بالوحش الكاسر).
- الإيجاز والاختصار: التعبير عن معنى كبير ومعقد في صورة موجزة ومكثفة، فالصورة التشبيهية الواحدة قد تغني عن عدة جمل وصفية.
٩ – كيف يمكن التمييز بين المشبه والمشبه به إذا لم تكن العلاقة واضحة أو إذا قُدّم أحدهما على الآخر؟
الإجابة: المعيار الأساسي للتمييز هو الغرض من الكلام والسياق. المشبه هو دائمًا الطرف الذي يريد المتكلم إثبات صفة له أو توضيح حاله، وهو محور الحديث. أما المشبه به، فهو الطرف المُستعار الذي يُجلب كدليل أو مقياس لتوضيح تلك الصفة، ويجب أن تكون هذه الصفة فيه أوضح وأقوى. حتى لو تقدم المشبه به لفظًا، يبقى المشبه هو المقصود بالوصف أساسًا. ففي قولنا: “بحرٌ هو في كرمه”، فالممدوح “هو” هو المشبه والمقصود بالوصف، أما “بحر” فهو المشبه به الذي استُعيرت منه صفة الكرم لتوضيح حال الممدوح، على الرغم من تقدمه في اللفظ.
١٠ – هل يأتي وجه الشبه دائمًا كصفة مفردة؟ أم يمكن أن يكون مركبًا؟
الإجابة: لا، لا يأتي وجه الشبه دائمًا كصفة مفردة. يمكن أن يكون مفردًا، حسيًا (مثل: الحمرة في تشبيه الخد بالورد)، أو عقليًا (مثل: الشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد). ولكن في الأنواع البلاغية المتقدمة من التشبيه، كالتشبيه التمثيلي، يكون وجه الشبه مركبًا أو هيئة منتزعة من متعدد. وهو صورة عقلية مجردة لا يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة، بل هي العلاقة القائمة بين عدة عناصر في جانب المشبه وعدة عناصر في جانب المشبه به، كما في تشبيه الثريا بعنقود عنب، فوجه الشبه ليس مجرد اللون أو الشكل، بل هو هيئة “تجمع أجسام صغيرة بيضاء لامعة في شكل عنقودي”.





