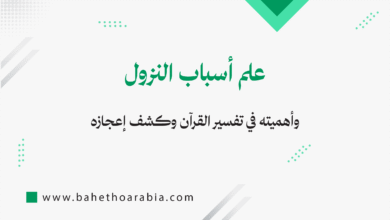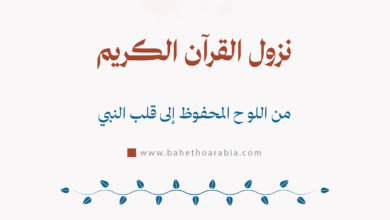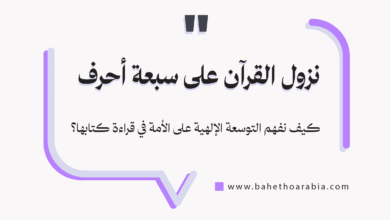إعجاز القرآن: كيف يجمع بين البلاغة والعلم والتشريع؟
هل يمكن لكلام بشري أن يحقق التوازن المثالي بين اللفظ والمعنى ويخاطب العالم والجاهل معاً؟

يقف القرآن الكريم شامخاً في تاريخ الأدب الإنساني بوصفه نصاً فريداً لا نظير له، فقد جمع بين دقة التعبير وعمق المعنى وشمولية الخطاب بطريقة لم يشهدها العقل البشري من قبل. إن دراسة وجوه إعجاز القرآن تكشف عن أبعاد متعددة تتجاوز مجرد البلاغة اللغوية إلى آفاق علمية وتشريعية ومعرفية تثبت مصدره الإلهي.
المقدمة
لقد شغل إعجاز القرآن الكريم العلماء والمفكرين عبر العصور، فهو ليس مجرد نص ديني بل ظاهرة فكرية ولغوية وعلمية متكاملة. إن التأمل في وجوه الإعجاز القرآني يقودنا إلى إدراك أن هذا الكتاب قد تفرد بخصائص لا يمكن أن تجتمع في كلام بشر؛ إذ جمع بين الإيجاز والإطناب في توازن معجز، وخاطب العامة والخاصة بلسان واحد، وأقنع العقل وأمتع الوجدان في آن معاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتمل على علوم ومعارف سبقت عصره، وأخبار غيبية تحققت، وتشريعات محكمة تسامت على كل قانون بشري. فما هي تفاصيل هذه الوجوه الإعجازية التي تجعل القرآن فريداً في بابه؟
كيف يحقق القرآن التوازن بين الإيجاز والإطناب؟
إن من أعظم تحديات البيان البشري هو الجمع بين القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى، فهما نهايتان متضادتان لا يكاد المرء يقبل على إحداهما إلا ويبتعد عن الأخرى. فالبليغ إما أن يؤدي مراده مختصراً مقتصداً في الألفاظ، فلا بد أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراً، وإما أن يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز كل دقائقه، فلا يجد بداً من أن يمد في نفسه مداً طويلاً.
ولئن وفق الكاتب البليغ لتقريب هاتين الغايتين في جملة أو جملتين، فلا يلبث أن يدركه الكلال والإعياء وضعف الطبع الإنساني. لقد أجمع نقاد الشعر والنثر على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة من قصائد معدودة، ثم وراء ذلك الوسط والرديء والغث والمستكره. على النقيض من ذلك، جاء البيان في القرآن الكريم مقدراً أحسن تقدير، فلا تحس فيه بالإسراف ولا بالتقتير؛ إذ يؤدي لك الصورة وافية نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها، ولا يشذ عنها شيء من عناصرها وكمالها، كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه.
هل يمكن لخطاب واحد أن يناسب العالم والجاهل؟
من وجوه إعجاز القرآن الكريم قدرته الفريدة على خطاب العامة وخطاب الخاصة في آن واحد، وهاتان غايتان متباعدتان عند البشر. فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به البسطاء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب، ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم بما لا تطيقه عقولهم. فما الحل إذاً؟
لا غنى لك – إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حقها كاملاً من بيانك – عن أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى، كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. بينما القرآن الكريم يقدم جملة واحدة تُلقى إلى العلماء والجهلاء، وإلى الأذكياء والبسطاء، وإلى العامة والملوك، فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته. إن هذا الإعجاز القرآني يجعله قراءة واحدة يراها البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراها العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم. فهل سمعت بنص آخر يحقق هذا التوازن المدهش؟
كيف يجمع القرآن بين إقناع العقل وإمتاع القلب؟
في النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير وقوة وجدان (Intellect and Emotion)، وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً.
لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء، وعرفنا كلام الأدباء والشعراء، فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلواً في جانب وقصوراً في جانب. فأما الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك، ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء قلبك واختلاب عاطفتك، فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع. على النقيض من ذلك، الشعراء إنما يسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك أوتار الشعور في نفسك، فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غياً أو رشداً، وأن يكون حقيقة أو تخيلاً. كما أن كل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير، وكل امرئ حين يحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير، ولا تعمل هذه القوى في النفس إلا متناوبة في حال بعد حال.
ما معنى تآلف الألفاظ والمعاني في القرآن؟
إن التآلف في الألفاظ هو ألا تكون بينها ثغرة في المخارج ولا في النغم، بل تتآلف وتتآخى في نسق واحد منسجم. يقول الإمام أبو بكر الباقلاني في هذا الشأن: “واعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان، قليل الطلاب، ضعيف الأصحاب”. فإن أداء اللفظتين قد ينفر في موضع ويزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه وتضرب بجرانها، وتراها في مكانها، وتجدها غير منازعة في أوطانها.
أما التآلف في المعاني فهو ألا يكون معنى لفظ نافراً من المعنى الذي يليه، وأن تتآلف الألفاظ والمعاني وما تثيره من الصور والأخيلة، وما تستدعيه من معان يستلزم بعضها بعضاً. وهذه الخصوصية مستوفاة في جميع القرآن وفي كل آية منه؛ إذ لا يحتاج الدارس والباحث إلى اختيار وانتقاء. بالإضافة إلى ذلك، تجد أسلوب القرآن ينفذ من كافة أقطار النفس ويتغلغل في أعماق الأفئدة، فيحملها على الخشوع والإخبات لما في طياته من قوة وهيمنة تدل على تنزله من علو وصدوره عن عظمة الألوهية. إذاً، القرآن بنفسه يدل على قدر متكلمه ويخبر عن مقام منزله عز وجل.
ما هي العلوم التي اشتمل عليها القرآن؟
اشتمل القرآن الكريم على معارف كثيرة متنوعة تتناول العقائد والعبادات والمعاملات والحياة والأحياء والكون والطبيعة والأخلاق والفضائل وغير ذلك مما يطول سرده. إن هذا التنوع المعرفي في حد ذاته وجه من وجوه الإعجاز القرآني؛ إذ يثير الدهشة في نفس كل قارئ مهما كان عليه من العلم. حتى إن الدكتور موريس بوكاي (Maurice Bucaille) عبر عن دهشته قائلاً: “إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه القرآن لأول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة”.
لقد جاء حديث القرآن عن هذه الموضوعات شاهداً بإعجازه من عدة أوجه نذكر منها:
١. الأمية النبوية: أن النبي الكريم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتردد على أحد من أهل العلم بهذه الشؤون، ومع ذلك فقد جاء بعلوم ومعارف لا ينهض بها عالم مهما كان عليه من العلم والإحاطة.
٢. الموافقة العلمية: أن ما ذكره من القضايا عن الكون والطبيعة والحيوان والنبات والخلق يتفق مع المعارف العلمية الحديثة، كما تشهد بذلك المؤلفات الكثيرة التي كتبها العلماء المعاصرون من مسلمين وغيرهم.
٣. الخلو من الأخطاء: جانب قد يستغربه القارئ وهو أن ما لا يحتويه القرآن مهم أيضاً ومعجز. فإن القرآن لا يحتوي على ذكر النظريات السائدة في عصر تنزيله عن تنظيم العالم السماوي مثلاً، تلك النظريات التي أثبت العلم فيما بعد عدم صحتها.
٤. التوافق مع الاكتشافات: وهذا يفسر لنا طرفاً من أسباب التوافق بين الإسلام والعلم حتى لم يعرف التاريخ صراعاً بينهما، وحتى إنك تجد التقدم العلمي الضخم لا يفاجئ أحداً من علماء الإسلام، على عكس ما حدث في أوروبا.
كيف أخبر القرآن عن الغيب؟
القرآن حافل بأنواع الأخبار عن الغيب: غيب المستقبل وغيب الحاضر وغيب الماضي، بما يحتاج تفصيله لتأليف واسع كبير. فما هي أنواع هذا الإخبار الغيبي يا ترى؟
أولاً: الإخبار عن غيب المستقبل: فمن ذلك ما وعد الله نبيه أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: “هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق”، ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح، وكان عمر يفعل ذلك، فلم يزل الفتح يتوالى شرقاً وغرباً براً وبحراً. وكذلك قال تعالى: “لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين”. وقال: “الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون”. هذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين.
ثانياً: الإخبار عن غيب الحاضر: في القرآن أخبار كثيرة عن مغيبات حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مما كان يبيته الأعداء والمنافقون. فقد عنيت سورة التوبة بكشف دخائل المنافقين ودسائسهم وفضح مؤامراتهم حتى سميت الفاضحة. ومن ذلك مؤامرة المشركين في بعض الغزوات على المسلمين أن يعطوهم الهدنة التي اعتادوها لأجل الصلاة ويفاجئوهم بالهجوم عليهم غدراً وهم يصلون، فأنزل الله تعالى بيان كيفية صلاة الحرب وقال فاضحاً نوايا العدو: “ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة”.
ثالثاً: أخبار الغيب الماضي: وذلك كثير جداً في القرآن يتضمن الإخبار عن حوادث قديمة وقعت من قبل وقصص الأنبياء وأممهم. إن علم الماضي قد ذهب واندثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقومه كذلك أميون، ولم ينشأ بين أهل الكتاب ولا كان ثمة مدرسة يتعلم منها هو أو أحد من قومه. فلما جاء بهذه الأخبار ينبئ بها نبأ الأنبياء مع أممهم فيطابق ما كان عند أهل الكتاب صواباً لا يدخله خطأ، ويصحح ما كان عندهم دخله تغيير أو تبديل، ويخبر بوقائع لا يعلمها أهل الكتاب ولا ذكرت في تراثهم، دل ذلك على أنه لا يمكن إلا أن يكون تلقياً من عالم الغيب والشهادة.
هل صدقت الاكتشافات الأثرية القرآن؟
لقد أحال القرآن الكريم الناس من قديم على مخلفات الأمم البائدة وآثارهم من قبل أن يتقدم علم الآثار (Archaeology) ليقرأ فيها الباحثون أخبار الأمم ويستنطقوها أحوالها. تأمل قوله تعالى: “وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل”. وقال عن فرعون: “فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية”. فهل يا ترى صدقت الاكتشافات الحديثة هذه الأخبار؟
أثيرت أسئلة كثيرة حول موسى عليه السلام وعلاقة فرعون بقومه، وزعم بعض الأجانب أنه كان مجرد طاغية كافر ليس بينه وبين قومه علاقة عبادة. وكذلك أثيرت ريبة حول إبراهيم عليه السلام ووجوده؛ إذ أثار المستشرق اليهودي جولد تسيهر (Goldziher) هذه الريبة. لكن تقدم علم الآثار وتفوق العلماء في قراءة الحفريات جاء ليسجل مصداق ما جاء به القرآن الكريم. أذكر أنني حين قرأت لأول مرة عن اكتشاف جثة فرعون وتطابقها مع ما ذكره القرآن شعرت بقشعريرة عجيبة تسري في جسدي؛ إذ كانت تلك اللحظة فارقة في فهمي لعظمة هذا الكتاب المعجز.
أما بشأن فرعون فقد تبين من الآثار أنه كان يقيم نوعاً من علاقة التأليه مع شعبه، كما اكتشفت جثته التي تفرد القرآن بالإخبار عن نجاتها. وقد عقد الدكتور موريس بوكاي فصلاً مهماً حول هذه القضية وهو قد شاهد مومياء (Mummy) فرعون هذا بنفسه في متاحف القاهرة واختتم الفصل بقوله: “أي بيان رائع لآيات القرآن ذلك الذي يهيئه قاعة الموميات الملكية بدار الآثار بالقاهرة لكل من يبحث في معطيات المكتشفات الحديثة عن أدلة على صحة الكتب المقدسة”. بينما أما بشأن إبراهيم الخليل عليه السلام فقد جاءت الحفريات لتثبت أخبار القرآن عنه وعن قومه تلك التي قام بدراستها ليوناردو وولي (Leonard Woolley) وألف بناء عليها كتابه عن إبراهيم.
ما وجه الإعجاز في التشريع القرآني؟
إن القرآن قد جاء بتشريع معجز يثبت أنه تنزيل من الله ووحي منه تبارك وتعالى، وذلك من أوجه كثيرة. فكيف يمكن لأمي لم يقرأ ولا يكتب أن يأتي بتشريع محكم يفوق كل القوانين البشرية؟
إن الإعجاز التشريعي يتجلى في جوانب متعددة:
أولاً: أنه جاء على لسان رجل أمي وفي أمة أمية تعيش الحياة القبلية بكل كيان أفرادها، لا يخطر على بال أحد منهم انتظام أو التزام بقانون عام أو نظام حضاري.
ثانياً: أنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق وصيانة مصالح الناس في جميع شؤونهم المالية والاجتماعية والأسرية والدولية.
ثالثاً: أنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم قديمها وحديثها، حتى أقرت المجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً تقتبس منه القوانين.
رابعاً: أن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من الفقه الإسلامي، وليس العكس.
يقول العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: “وقد كتبنا بحثاً وازنا فيه بين شريعة القرآن وقانون الرومان في الملكية بالخلافة وذكرنا أن قانون الرومان قد تكون في نحو ثلاثة عشر قرناً ومع ذلك هو في الملكية بالخلافة لا يوازن بشريعة القرآن إلا إذا وازنا بين عصا هشة وسيف بتار”. وبالتالي، فإن الأوروبيين القانونيين يرون في قانون الميراث في القرآن أن العقل البشري لم يصل إلى الآن إلى خير منه.
لماذا يُعَدُّ الإعجاز القرآني دليلاً قاطعاً على مصدره الإلهي؟
إن تجميع كل هذه الوجوه الإعجازية في كتاب واحد يستحيل أن يكون من عمل بشر. فالجمع بين القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى في كل آية، وخطاب العامة والخاصة بكلام واحد، وإقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً، وتآلف الألفاظ والمعاني على أكمل وجه، هذا كله في نص واحد يتجاوز قدرة البشر. انظر إلى أعظم الشعراء والبلغاء، هل تجدهم يحققون هذا التوازن في كل كلامهم؟ الإجابة هي: كلا، بل لا يبلغون ذلك إلا في أبيات محدودة ثم يعتريهم الضعف والنقص.
من جهة ثانية، فإن المضمون القرآني يشهد بالإعجاز من خلال العلوم المتنوعة التي اشتمل عليها، والأخبار الغيبية الدقيقة التي تحققت، والتشريعات المحكمة التي تفوقت على كل القوانين البشرية. وكذلك فإن توافق القرآن مع الاكتشافات العلمية والأثرية الحديثة يؤكد أنه ليس من كلام بشر يخطئ ويصيب، بل هو من عند الله العليم الخبير. فكيف لأمي في القرن السابع الميلادي أن يأتي بمعلومات علمية لم تكتشف إلا في القرن العشرين؟ وكيف له أن يخبر عن أحداث ماضية بدقة لم تثبت إلا بالحفريات الحديثة؟
الخاتمة
لقد تبين لنا من خلال هذا العرض أن إعجاز القرآن الكريم ليس وجهاً واحداً بل وجوه متعددة متكاملة تشهد جميعها بأنه كلام الله تعالى. فمن الإعجاز البياني الذي يجمع بين القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى، إلى القدرة على خطاب العامة والخاصة معاً، إلى الجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة، إلى تآلف الألفاظ والمعاني على أكمل وجه، كل ذلك يثبت استحالة صدوره عن بشر. وبالمقابل، فإن الإعجاز المضموني يتجلى في العلوم المتنوعة والأخبار الغيبية والتشريعات المحكمة التي جاء بها القرآن.
الجدير بالذكر أن هذه الوجوه الإعجازية لا تنفصل عن بعضها بل تتكامل لتشكل بناء محكماً لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله الحكيم الخبير. ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن القرآن تحدى العرب – وهم أهل البلاغة والفصاحة – أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فعجزوا عن ذلك رغم شدة عداوتهم للإسلام وحرصهم على إبطاله. إن هذا العجز المستمر عبر ١٤ قرناً يشهد بأن القرآن معجزة خالدة تتجدد دلائلها مع كل عصر ومع كل اكتشاف علمي جديد.
والآن، بعد أن تعرفت على هذه الوجوه الإعجازية المتعددة، ألا يدفعك ذلك إلى تدبر القرآن الكريم وقراءته بعين البصيرة لتكتشف بنفسك المزيد من أسرار هذا الكتاب العظيم؟
الأسئلة الشائعة
١. ما الفرق بين الإعجاز البياني والإعجاز العلمي في القرآن؟
الإعجاز البياني يتعلق بالأسلوب اللغوي والبلاغي للقرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وتآلف الألفاظ والمعاني وقدرته على خطاب جميع المستويات العقلية، بينما الإعجاز العلمي يتعلق بالمضمون والمعلومات العلمية التي وردت في القرآن عن الكون والطبيعة والتي ثبتت صحتها بالاكتشافات الحديثة رغم أنها نزلت قبل أربعة عشر قرناً على رجل أمي في مجتمع أمي.
٢. لماذا يُعَدُّ الجمع بين الإيجاز والإطناب في القرآن معجزاً؟
لأن البشر عادة يميلون إما إلى الإيجاز فيحيفون على المعنى، وإما إلى الإطناب فيسرفون في اللفظ، ولا يستطيعون الجمع بينهما في كل كلامهم بل في مواضع محدودة فقط. أما القرآن فقد جاء بالتوازن المثالي بين القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى في جميع آياته دون استثناء، فلا تستطيع أن تحذف كلمة منه أو تبدلها بأخرى دون إخلال بالمعنى أو الجمال البياني.
٣. كيف يخاطب القرآن العالم والجاهل بنص واحد؟
يحقق القرآن ذلك من خلال أسلوب فريد يجمع بين الوضوح والعمق معاً، فالعامة يفهمون المعنى الظاهر المباشر دون التواء أو غموض، بينما الخاصة والعلماء يكتشفون في نفس النص طبقات أعمق من المعاني واللطائف البيانية والحكم الدقيقة. فكل فئة تأخذ من القرآن على قدر عقلها وعلمها، وهذا ما لا يتحقق في كلام البشر الذي يكون إما موجهاً للعامة فيمل منه الخاصة، وإما موجهاً للخاصة فلا يفهمه العامة.
٤. ما المقصود بإقناع العقل وإمتاع العاطفة في القرآن؟
المقصود أن القرآن يجمع بين تقديم الحقائق العقلية والبراهين المنطقية التي تقنع العقل وترضيه، وبين الأساليب الوجدانية المؤثرة التي تحرك العاطفة وتستثير المشاعر من تشويق وترهيب وتبشير وتحذير. فهو ليس كلام الفلاسفة الجاف الذي يخاطب العقل فقط، وليس كلام الشعراء العاطفي الذي يخاطب الوجدان فقط، بل يجمع بينهما في توازن معجز لا يتحقق في كلام البشر.
٥. لماذا يُعَدُّ إخبار القرآن عن الغيب دليلاً على إعجازه؟
لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم من أحد، ومع ذلك أخبر بدقة عن أحداث ماضية لم تكن معروفة إلا لقلة من أهل الكتاب، وعن أحداث مستقبلية تحققت كما أخبر، وعن مؤامرات حاضرة كان يدبرها الأعداء سراً. فهذا الإخبار الدقيق عن الغيب بأنواعه الثلاثة لا يمكن أن يكون إلا بوحي من عالم الغيب والشهادة.
٦. كيف صدقت الاكتشافات الأثرية الحديثة أخبار القرآن؟
أثبتت الحفريات والاكتشافات الأثرية صحة ما ذكره القرآن عن الأمم السابقة، فقد اكتُشفت جثة فرعون محفوظة كما أخبر القرآن في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، وأثبتت الحفريات في بابل صحة قصة إبراهيم عليه السلام وعبادة قومه للنجوم كما ذكر القرآن، وأثبتت الآثار أن فرعون كان يقيم علاقة تأليه مع شعبه كما ذكر القرآن. هذه الاكتشافات لم تتم إلا في القرن التاسع عشر والعشرين، فكيف علم بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرناً؟
٧. ما وجه الإعجاز في خلو القرآن من النظريات الخاطئة؟
من الإعجاز أن القرآن لم يذكر النظريات العلمية الخاطئة التي كانت سائدة في عصر نزوله عن تنظيم الكون والسماء والأرض، رغم أنها كانت معتقدات راسخة عند الناس آنذاك. فلو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لذكر تلك المعتقدات التي كان يؤمن بها الناس في زمانه، لكنه تجنبها تماماً وذكر فقط حقائق علمية ثبتت صحتها لاحقاً، وهذا يفسر عدم وجود صراع بين الإسلام والعلم كما حدث في الحضارات الأخرى.
٨. لماذا تُعَدُّ التشريعات القرآنية معجزة؟
لأنها جاءت على لسان رجل أمي في أمة أمية قبلية لا تعرف النظام ولا القانون، ومع ذلك جاءت هذه التشريعات شاملة لجميع جوانب الحياة ومحكمة في دقتها ومتفوقة على كل القوانين البشرية القديمة والحديثة. حتى إن قانون الرومان الذي تطور عبر ثلاثة عشر قرناً لا يساوي شيئاً أمام تشريعات القرآن في الميراث والمعاملات، كما أن المجامع القانونية الدولية اعترفت بالفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
٩. ما المقصود بتآلف الألفاظ والمعاني في القرآن؟
تآلف الألفاظ يعني أن كلمات القرآن منسجمة في مخارجها الصوتية وفي نغمها بحيث لا تنفر الأذن من سماعها، وتآلف المعاني يعني أن المعنى في كل آية لا ينفر من المعنى الذي يليه بل تتكامل المعاني وتتسلسل بطريقة منطقية بديعة. وقد وصف الإمام ابن عطية القرآن بأنه لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد، فكل كلمة في مكانها الأمثل لا يمكن استبدالها بغيرها.
١٠. لماذا عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن رغم فصاحتهم؟
لأن التحدي القرآني لم يكن في جانب واحد بل في جوانب متعددة يستحيل اجتماعها في كلام بشر، فهو يجمع بين الإيجاز والإطناب معاً، وبين خطاب العامة والخاصة معاً، وبين إقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً، وبين تآلف الألفاظ وتآلف المعاني معاً، كل ذلك في جميع الآيات دون استثناء. والعرب رغم براعتهم في البلاغة لا يستطيعون تحقيق هذا التوازن إلا في أبيات محدودة ثم يعتريهم الضعف، أما القرآن فمستواه واحد في كل آياته.