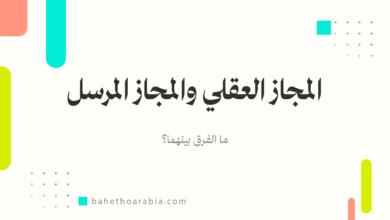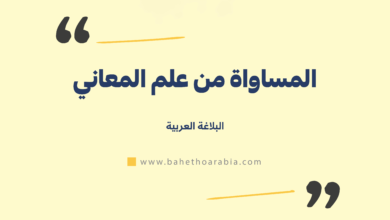التشبيه البليغ: تعريفه وصوره وأسرار قوته البلاغية
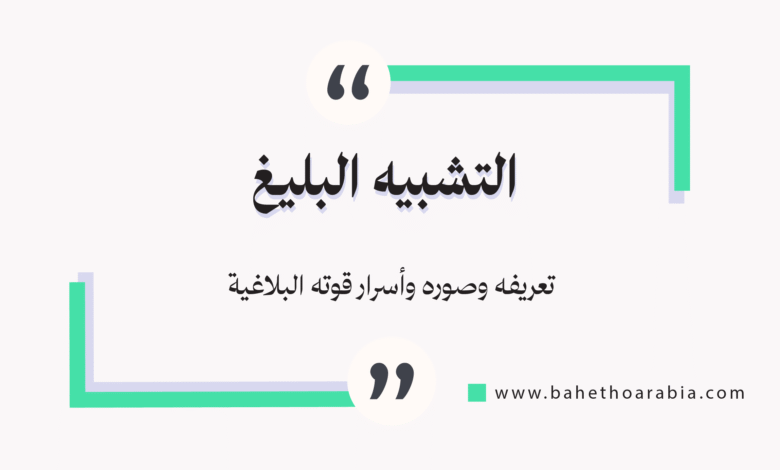
يُعد التشبيه أحد أعمدة علم البيان وأوسع فنونه نطاقاً، فهو الأداة التي تكشف الخفي وتوضح المعاني وتكسوها جمالاً ورفعة. ويقوم التشبيه في أبسط صوره على أربعة أركان هي: المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. وتتفاوت مراتب التشبيه البلاغية قوةً وتأثيراً بناءً على ما يُذكر أو يُحذف من هذه الأركان، ويتربع على عرش هذه المراتب وأعلاها قدراً ما يُعرف باسم التشبيه البليغ.
ما هو التشبيه البليغ؟
يُعرَّف التشبيه البليغ اصطلاحاً بأنه ذلك النوع من التشبيه الذي حُذف منه ركنان أساسيان هما: أداة التشبيه ووجه الشبه، واقتُصر فيه على ذكر الطرفين الأساسيين فقط، وهما المشبه والمشبه به. إن سبب تسمية التشبيه البليغ بهذا الاسم يكمن في القوة البلاغية التي يكتسبها من هذا الحذف؛ إذ يوهم المتلقي باتحاد المشبه والمشبه به، وكأنهما شيء واحد لا مجرد شيئين متشابهين، مما يرتقي بالمعنى إلى أعلى درجات المبالغة المقبولة والبيان المؤثر.
على سبيل المثال، عند قولنا “خالد أسد”، نكون قد قدمنا صورة من صور التشبيه البليغ، حيث أُلغيت الأداة “الكاف” ووجه الشبه “الشجاعة”، فصار خالد والأسد في الصورة البيانية كياناً واحداً، وهذه هي غاية البلاغة التي يسعى إليها التشبيه البليغ.
أركان التشبيه البليغ وصوره النحوية
يقتصر بناء التشبيه البليغ على ركنين فقط هما المشبه والمشبه به، مما يمنحه إيجازاً وقوة. وتتعدد الصور النحوية التي يأتي عليها التشبيه البليغ في الكلام، ومن أبرزها:
١ – صورة المبتدأ والخبر:
وهي الصورة الأكثر شيوعاً، حيث يكون المشبه مبتدأ والمشبه به خبراً له، مما يؤكد دعوى الاتحاد بينهما.
- مثال: قول الشاعر:عزماتهم قضبٌ وفيض أكفهم *** سُحُبٌ وبيضُ وجوههم أقمار
- الشرح: في هذا البيت ثلاثة أمثلة رائعة للتشبيه البليغ؛ فقد شبه العزمات بالقضب (السيوف)، وفيض الأكف بالسحب، ووجوههم البيضاء بالأقمار، وكل ذلك جاء في صورة المبتدأ والخبر ليؤكد قوة هذا التشبيه.
- مثال آخر: قول المتنبي:أين أزمعت أيهذا الهمامُ *** نحن نبتُ الربا وأنت الغمامُ
- الشرح: هنا جعل المتنبي المشبه “نحن” والمشبه به “نبت الربا”، والمشبه “أنت” والمشبه به “الغمام”، وهو تشبيه بليغ يصور حاجة الناس للممدوح كحاجة النبات للمطر.
٢ – صورة إضافة المشبه به إلى المشبه:
وفي هذه الصورة المتقدمة، يُضاف المشبه به إلى المشبه، فيتحدان في مركب إضافي بليغ.
- مثال: قول الشاعر:والريح تعبث بالغصون وقد جرى *** ذهبُ الأصيل على لُجينِ الماء
- الشرح: الأصل هو “أصيل كالذهب” و”ماء كاللجين (الفضة)”، ولكن الشاعر صاغه في صورة تشبيه بليغ بإضافة المشبه به (ذهب، لجين) إلى المشبه (الأصيل، الماء)، فنتج عن ذلك تركيب “ذهب الأصيل” و “لجين الماء” البديع.
٣ – صورة الحال وصاحبها:
يأتي التشبيه البليغ في هذه الصورة عندما يكون المشبه به حالاً منصوبة وصاحب الحال هو المشبه.
- مثال: قول الشاعر:بدت قمراً ومالت خُوطَ بانٍ *** وفاحت عنبراً ورنت غزالا
- الشرح: المشبه هو الضمير المستتر العائد على المحبوبة، وقد شبهها بالقمر في إشراقها، وبغصن البان في ميلانها، وبالعنبر في رائحتها، وبالغزال في نظرتها، وكل مشبه به (قمراً، خوط بانٍ، عنبراً، غزالا) جاء حالاً منصوبة، مما يجعل هذا التركيب مثالاً متقناً للتشبيه البليغ.
٤ – صورة المصدر المبين للنوع:
هنا يكون المشبه به مصدراً مبيناً لنوع الفعل الذي صدر عن المشبه.
- مثال: قوله تعالى في وصف حركة الجبال يوم القيامة: (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ).
- الشرح: التقدير: تمر مروراً كمرور السحاب. فحُذفت الأداة ووجه الشبه، وجيء بالمصدر “مرَّ” مضافاً إلى “السحاب” لبيان هيئة المرور، وهو تشبيه بليغ يجسد السرعة والخفة في مشهد مهيب.
مراتب التشبيه وموقع التشبيه البليغ منها
يتدرج التشبيه في ثلاث مراتب بلاغية بحسب ما يذكر ويحذف من أركانه، وهذه المراتب توضح مكانة التشبيه البليغ السامية:
- المرتبة الدنيا: وهي التي يُذكر فيها جميع الأركان الأربعة، كقولنا: “عليٌ كالأسد في الشجاعة”. وهنا يكون البيان واضحاً ومباشراً ولكنه الأقل في المبالغة.
- المرتبة الوسطى: وهي التي يُحذف فيها أحد الركنين الثانويين (الأداة أو وجه الشبه)، كقولنا: “عليٌ كالأسد” (بحذف وجه الشبه)، أو “عليٌ أسدٌ في الشجاعة” (بحذف الأداة). وهنا ترتقي درجة البلاغة قليلاً.
- المرتبة العليا: وهي المرتبة التي يحتلها التشبيه البليغ، حيث يُحذف كل من الأداة ووجه الشبه معاً، كقولنا: “عليٌ أسد”. وهذا الحذف المزدوج هو ما يمنح التشبيه البليغ مكانته العليا وقوته التعبيرية الفائقة.
أسرار بلاغة التشبيه البليغ وقوته
تكمن القوة الاستثنائية التي يمتلكها التشبيه البليغ في عدة أسرار بلاغية تجعله الأسلوب المفضل لدى كبار الأدباء والشعراء، ومنها:
- المبالغة القائمة على دعوى الاتحاد: إن حذف الأداة ووجه الشبه يزيل الحواجز بين الطرفين، فيتحول المعنى من مجرد المشابهة إلى ادعاء الاتحاد الكامل، وكأن المشبه قد تقمص هوية المشبه به تماماً. هذه المبالغة هي جوهر قوة التشبيه البليغ.
- الإيجاز وتركيز المعنى: بحذفه ركنين، يقدم التشبيه البليغ المعنى بأوجز لفظ وأعمق دلالة، فالكلمتان “العلم نور” تحملان من المعاني ما قد يحتاج شرحه إلى سطور.
- إطلاق عنان الخيال للمتلقي: عندما يُحذف وجه الشبه، لا يتم تقييد المشابهة في صفة واحدة محددة. هذا الإطلاق يفتح الباب أمام خيال المتلقي ليتصور كل أوجه الشبه الممكنة بين الطرفين، مما يجعل التشبيه البليغ أكثر ثراءً وعمقاً.
التشبيه البليغ في نماذج شعرية رائعة
لقد حفلت دواوين الشعر العربي بروائع صيغت بأسلوب التشبيه البليغ، مما يبرهن على قيمته الفنية العالية:
- مثال ١: قول الشاعر:همُ البحورُ عطاءً حين تسألهم *** وفي اللقاء إذا تلقاهم بُهُـمُ
- الشرح: شبه الشاعر الممدوحين بالبحور في العطاء، قائلاً: “هم البحور”، وهو تشبيه بليغ من صورة المبتدأ والخبر، يدل على الكرم الفياض الذي لا حدود له.
- مثال ٢: قول أبي الطيب المتنبي:فاقضوا مآربَكم عِجالاً إنّما *** أعمارُكم سَفَرٌ من الأسفارِ
- الشرح: “أعماركم سفر” هو تشبيه بليغ موجز وعميق، شبه فيه الأعمار بالسفر للدلالة على قصرها وسرعة انقضائها، وحث على استغلالها قبل فوات الأوان. فبلاغة التشبيه البليغ هنا تكمن في قدرته على تكثيف حكمة بالغة في تركيب لغوي بسيط.
وفي الختام، يتضح أن التشبيه البليغ ليس مجرد نوع من أنواع التشبيه، بل هو قمته البلاغية وأداة فنية رفيعة تجمع بين الإيجاز وقوة التأثير وعمق الخيال، مما يجعله عنصراً أساسياً في إبداع أروع النصوص الأدبية وأخلدها.
أمثلة وتمارين عن التشبيه البليغ
١- الشاهد:
قوله تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ}.
- الشرح: هذا تشبيه بليغ جاء على صورة الخبر، والمشبه فيه محذوف دل عليه السياق، والتقدير هو: “هم صمٌ بكمٌ عميٌ”. حيث شُبّه المنافقون بمن فقدوا هذه الحواس لعدم انتفاعهم بها في إدراك الحق.
٢- الشاهد:
قول الشاعر عمران بن حطان:
أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ *** فتخاءُ تنفرُ من صفير الصافرِ
- الشرح: في هذا البيت مثالان للتشبيه البليغ. الأول هو “أسدٌ عليَّ” والتقدير “هو أسدٌ”، حيث شبه المخاطَب بالأسد في القوة والبطش على الشاعر. والثاني “وفي الحروب نعامة” والتقدير “هو في الحروب نعامة”، حيث شبهه بالنعامة في الجبن والهروب من القتال.
٣- الشاهد:
قول الشاعر:
عزماتهم قضبٌ وفيض أكفهم *** سُحُبٌ وبيضُ وجوههم أقمارُ
- الشرح: يحتوي هذا البيت على ثلاثة تشبيهات بليغة جاءت على صورة المبتدأ والخبر. فقد شبه “عزماتهم” بـ “القضب” (السيوف) في الحسم والقطع، وشبه “فيض أكفهم” بـ “السحب” في الكرم والعطاء، وشبه “بيض وجوههم” بـ “الأقمار” في الجمال والإشراق.
٤- الشاهد:
قول الشاعر:
بدت قمراً ومالت خُوطَ بانٍ *** وفاحت عنبراً ورنت غزالا
- الشرح: هذا المثال يوضح صورة التشبيه البليغ الذي يأتي على هيئة الحال وصاحبها. فالمشبه هو الضمير المستتر العائد على المرأة، وقد شُبِّهت بأربعة أشياء: “قمراً” في الإشراق، و”خوط بانٍ” (غصن البان) في التمايل، و”عنبراً” في الرائحة، و”غزالاً” في نظرتها، وكل مشبه به جاء حالاً منصوبة.
٥- الشاهد:
قوله تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ}.
- الشرح: هذا تشبيه بليغ جاء على صورة المصدر المبين للنوع. فالتقدير هو “تمر مروراً كمرور السحاب”، وقد حُذفت الأداة ووجه الشبه (السرعة والخفة)، وجيء بالمصدر “مرَّ” المضاف إلى “السحاب” لبيان هيئة الحركة، مما يجسد المشهد بقوة وإيجاز.
٦- الشاهد:
قول الشاعر:
والريح تعبث بالغصون وقد جرى *** ذهبُ الأصيل على لُجينِ الماء
- الشرح: هنا جاء التشبيه البليغ في صورة إضافة المشبه به إلى المشبه. فالأصل هو تشبيه “الأصيل” (وقت الغروب) بـ “الذهب” في لونه، وتشبيه “الماء” بـ “اللجين” (الفضة) في صفائه، ولكن الشاعر صاغهما في تركيب بليغ هو “ذهب الأصيل” و”لجين الماء”.
٧- الشاهد:
قول الشاعر:
أقحوان معانق لشقيق *** كثغور تعض ورد الخدود
- الشرح: الشاهد على التشبيه البليغ هنا يكمن في التركيب الإضافي “ورد الخدود”. فالشاعر شبه الخدود بالورد في الحمرة والجمال، ثم صاغه في صورة إضافة المشبه به “ورد” إلى المشبه “الخدود”.
٨- الشاهد:
قول الشاعر:
همُ البحورُ عطاءً حين تسألهم *** وفي اللقاء إذا تلقاهم بُهُـمُ
- الشرح: هذا تشبيه بليغ على صورة المبتدأ والخبر، حيث شبه الممدوحين (هم) بالبحور. والغرض من التشبيه هو بيان الكرم والعطاء الفياض الذي لا ينقطع، فجعلهم بحوراً للمبالغة في هذا المعنى.
٩- الشاهد:
قول أبي الطيب المتنبي:
أين أزمعت أيهذا الهمامُ *** نحن نبتُ الربا وأنت الغمامُ
- الشرح: في الشطر الثاني تشبيهان بليغان على صورة المبتدأ والخبر. الأول “نحن نبت الربا”، حيث شبه الشاعر نفسه ومن معه بالنبات. والثاني “أنت الغمام”، حيث شبه الممدوح بالغمام (السحاب الماطر). ووجه الشبه هو الحاجة والافتقار، فكما أن النبات لا حياة له إلا بالمطر، كذلك هم لا غنى لهم عن الممدوح.
١٠- الشاهد:
قول أبي الطيب المتنبي:
فاقضوا مآربَكم عِجالاً إنّما *** أعمارُكم سَفَرٌ من الأسفارِ
- الشرح: التشبيه البليغ هنا هو “أعماركم سفرٌ”. شبه الشاعر الأعمار بالسفر للدلالة على قصرها وسرعة انقضائها وعدم استقرارها، وهو تشبيه عميق يختزل حكمة كبيرة في تركيب موجز وقوي.
السؤالات الشائعة
١- ما هو التعريف الدقيق للتشبيه البليغ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟
الإجابة: التشبيه البليغ هو أرقى أنواع التشبيه وأعلاها مرتبة في علم البيان، ويُعرَّف اصطلاحاً بأنه “ما حُذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه معاً، واقتُصر فيه على ذكر الطرفين الأساسيين: المشبه والمشبه به”. سبب تسميته بـ”البليغ” يكمن في وصوله إلى غاية البلاغة من خلال المبالغة القائمة على ادعاء اتحاد الطرفين، فبدلاً من الإشارة إلى مجرد تشابه بينهما، يوهم التركيب بأنهما صارا شيئاً واحداً متطابقاً. على سبيل المثال، في قولنا “العلم نور”، لم نقل “العلم كالنور في الهداية”، بل ألغينا الأداة ووجه الشبه، فصار العلم هو النور ذاته، وهذه المبالغة المقبولة هي سر بلاغته وقوته التأثيرية.
٢- ما الفرق الجوهري بين التشبيه البليغ والتشبيه المرسل المجمل؟
الإجابة: يكمن الفرق الجوهري في ذكر أداة التشبيه أو حذفها. التشبيه البليغ تُحذف منه الأداة ووجه الشبه معاً (مثل: أنت شمس). أما التشبيه المرسل المجمل، فتُذكر فيه الأداة ويُحذف وجه الشبه (مثل: أنت كالشمس). هذا الفارق له أثر بلاغي عميق؛ فوجود الأداة في التشبيه المرسل “كالكاف” يقر بوجود تفاوت وتباعد بين المشبه والمشبه به، ويعترف بأن الأول ليس هو الثاني وإنما هو مثله في صفة ما. بينما حذف الأداة في التشبيه البليغ يلغي هذا التفاوت ظاهرياً، ويدّعي أن المشبه قد ارتقى ليصبح هو عين المشبه به، وهذا ما يجعله أشد وقعاً في النفس وأقوى في المبالغة والبيان.
٣- لماذا يُعتبر التشبيه البليغ أقوى أنواع التشبيه بلاغياً؟
الإجابة: ترجع قوة التشبيه البليغ إلى عاملين رئيسيين يجتمعان فيه:
- المبالغة في الادعاء: حذفه للأداة ووجه الشبه ينقل المعنى من دائرة المشابهة إلى دائرة الاتحاد والهوية الواحدة، وكأن صفات المشبه به قد تجسدت بالكامل في المشبه. هذا الادعاء القوي يخلق صورة ذهنية أكثر تأثيراً ورسوخاً لدى المتلقي.
- الإيجاز وتكثيف الدلالة: يقدم المعنى بأقل عدد ممكن من الألفاظ، وهذا الإيجاز في حد ذاته ضرب من البلاغة. فجملة “الأرض ياقوتة” تحمل من المعاني والصور ما قد يستغرق شرحه عدة جمل، مما يدل على قدرته على شحن الألفاظ بدلالات واسعة وعميقة.
٤- ما هي أبرز الصور النحوية التي يأتي عليها التشبيه البليغ في الجملة العربية؟
الإجابة: يأتي التشبيه البليغ في تراكيب نحوية متنوعة تزيد من ثرائه الأسلوبي، وأشهر هذه الصور أربع:
- المبتدأ والخبر: وهي الصورة الأساسية، مثل “عزماتهم قُضُبٌ”. (المشبه: عزماتهم، المشبه به: قضب).
- إضافة المشبه به إلى المشبه: وهي صورة متقدمة تُظهر الاتحاد بشكل أقوى، مثل “جرى ذهبُ الأصيل على لجينِ الماء”. (الأصل: أصيل كالذهب، وماء كاللجين).
- الحال وصاحبها: حيث يكون المشبه به حالاً منصوبة، مثل “كرَّ عنترة على الأعداء أسداً”. (المشبه: عنترة، المشبه به: أسداً).
- المصدر المبين للنوع: حيث يكون المشبه به مصدراً، مثل “هرب النومُ هربَ الأمنِ”. (التقدير: هرباً كـهربِ الأمن).
٥- كيف يمكن التفريق بين التشبيه البليغ والاستعارة التصريحية؟
الإجابة: هذا من أدق المواضع في علم البيان، والفيصل بينهما هو ذكر المشبه. في التشبيه البليغ، لا بد من ذكر الطرفين معاً (المشبه والمشبه به)، مثل “خالدٌ أسدٌ”. أما في الاستعارة التصريحية، فيُحذف المشبه ويُصرح بالمشبه به فقط مع وجود قرينة تدل على المحذوف. فإذا قلنا “رأيت أسداً يحمل سيفه في المعركة”، فنحن لا نقصد الأسد الحقيقي، بل رجلاً شجاعاً (المشبه المحذوف)، والقرينة هي “يحمل سيفه”. إذن، وجود المشبه صراحةً يجعل التركيب تشبيهاً بليغاً، بينما حذفه يجعله استعارة تصريحية.
٦- هل يؤثر حذف وجه الشبه في التشبيه البليغ على فهم المعنى؟
الإجابة: على العكس، إن حذف وجه الشبه في التشبيه البليغ غالباً ما يثري المعنى ويوسع دلالته. فبدلاً من حصر التشابه في صفة واحدة محددة (كالشجاعة في “خالد أسد في الشجاعة”)، يفتح الحذف الباب أمام خيال المتلقي لاستدعاء كل الصفات المشتركة الممكنة بين الطرفين، كالقوة والهيبة والزعامة والبطش. هذا الإطلاق يجعل المعنى أعم وأشمل، ويمنح المتلقي دوراً إيجابياً في بناء الصورة البيانية، مما يزيد من جماليات النص وعمقه.
٧- ما هو الأثر النفسي والجمالي الذي يحدثه التشبيه البليغ لدى المتلقي؟
الإجابة: يحدث التشبيه البليغ أثراً جمالياً ونفسياً مركباً لدى المتلقي، فهو ينقل المعنى من الإطار التقريري المباشر إلى فضاء الصورة الحسية المدهشة. إنه يعمل على تجسيد المعاني المجردة وتحويلها إلى كيانات محسوسة (مثل: العمر سفر)، ويضفي على المحسوسات حيوية وعمقاً جديدين (مثل: هي قمر). هذا الانتقال يثير الخيال، ويحرك الوجدان، ويجعل المعنى أرسخ في الذهن وأشد وقعاً في النفس، لما فيه من مفاجأة بيانية تكسر رتابة اللغة العادية.
٨- هل يمكن أن يكون أحد طرفي التشبيه البليغ مقيداً بوصف أو إضافة؟
الإجابة: نعم، يمكن أن يكون أحد طرفي التشبيه البليغ أو كلاهما مقيداً بما يوضح صورته ويزيدها دقة وجمالاً، وهذا لا يخرجه عن كونه بليغاً طالما أن الأداة ووجه الشبه محذوفان. مثال ذلك قول الشاعر: “والريح تعبث بالغصون وقد جرى *** ذهبُ الأصيل على لجينِ الماء”، فالمشبه “الأصيل” والمشبه به “ذهب” وكذلك “الماء” و”لجين” كلها مفردات غير مقيدة. لكن في أمثلة أخرى قد نجد التقييد، كأن نقول “علم بلا عمل شجرة بلا ثمر”، فهنا تشبيه بليغ طرفاه مقيدان، والمقصد هو تشبيه هيئة بهيئة.
٩- هل هناك علاقة بين التشبيه البليغ والتشبيه الضمني؟
الإجابة: نعم، هناك علاقة من حيث قوة الإيحاء وخفاء التركيب، ولكنهما مختلفان جوهرياً. التشبيه البليغ صريح في ذكر طرفيه (العلم نور). أما التشبيه الضمني، فلا يأتي على صورة التشبيه المعروفة، بل يُفهم من سياق الكلام لمحةً وإشارة، ويكون الشطر الثاني غالباً بمثابة برهان على صحة الفكرة في الشطر الأول. مثل قول المتنبي: “من يهُن يسهل الهوانُ عليه *** ما لِجرحٍ بميتٍ إيلامُ”. فهو لم يقل “الذي يهُن كالميت”، بل أتى بقضية وحكم ثم أتبعها بما يؤيدها، فالعلاقة تُفهم ضمناً. كلاهما من الأساليب البيانية الرفيعة التي تعتمد على ذكاء المتلقي.
١٠- كيف يمكن للكاتب أو الشاعر أن يصوغ تشبيهاً بليغاً ومبتكراً؟
الإجابة: لصياغة تشبيه بليغ مبتكر، يمكن اتباع خطوات إبداعية:
- البدء بتشبيه كامل الأركان: تحديد مشبه ومشبه به بينهما علاقة غير مطروقة أو ملاحظة من زاوية جديدة.
- تحديد وجه الشبه الدقيق: استخلاص الصفة الأعمق والأكثر إثارة للدهشة التي تربط بينهما.
- الحذف البلاغي: تجريد التشبيه من أداته ووجه شبهه، وترك الطرفين فقط في تركيب نحوي مناسب (مبتدأ وخبر، إضافة، حال…).
- الابتكار في الطرفين: الابتعاد عن المشبهات بها التقليدية (كالبدر والبحر والأسد) والبحث عن روابط جديدة ومدهشة بين عناصر لم يربطها أحد من قبل، فهذا هو ميدان الإبداع الحقيقي في صياغة التشبيه البليغ.