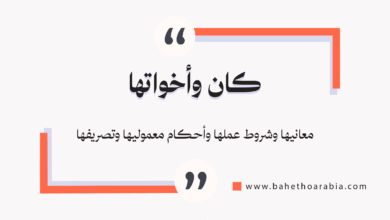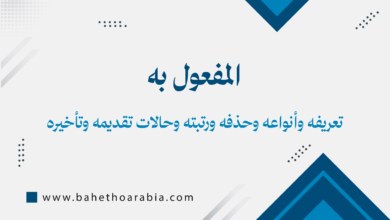الصفة والموصوف: قواعد الاستخدام، الفروق بين الصفة الحقيقية والسببية، وأبرز الأخطاء
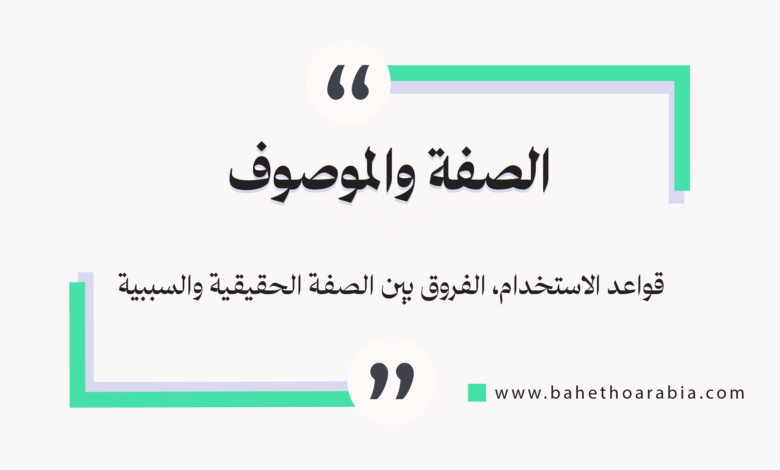
تتجلى قوة اللغة العربية وثرائها في قدرتها الفائقة على التصوير والوصف الدقيق، وتُعد الصفة أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها هذا البناء اللغوي البديع. فهي ليست مجرد تابع يتبع موصوفه في الإعراب، بل هي العدسة التي نرى من خلالها تفاصيل الأشياء، والأداة التي تميز كيانًا عن آخر، وتضفي على الكلام أبعادًا من المدح أو الذم أو التأكيد. في هذا المقال الأكاديمي، سنغوص في أعماق عالم الصفة، مستكشفين تعريفها الدقيق، ومعانيها المتعددة، وأنواعها المختلفة من المفرد إلى الجملة وشبه الجملة، وصولًا إلى أحكامها المعقدة كالمطابقة والقطع والحذف، لنقدم دليلاً شاملاً يوضح الدور الجوهري الذي تلعبه الصفة في إحكام صياغة المعنى وإثرائه.
تعريف الصفة ومعانيها
إن الصفة هي كلمة أو جملة ارتبطت بموصوف، فإن هذه الصفة تحدد معنى فيه، وأضفت عليه أحد المعاني التالية:
التحديد أو التخصيص أو المدح أو الذم أو التأكيد، وكل هذه من وظائف الصفة الأساسية.
ـ التحديد: إذا اشترك شيئان أو أكثر في تسمية واحدة، وأردت الحديث عن واحد من هذه الأشياء المشتركة في التسمية؛ فلا بد من تحديده، والتحديد يكون في أمور كثيرة، منها استخدام الصفة للوصف. تقول: (جاء خالد الطبيب، ونجح خالد الطالب، وسافر خالد الضابط). فالطبيب والطالب والضابط هي كلمات تمثل الصفة التي حددت كل منها الاسم المشترك (خالد) ووضحته، ولولا الصفة لم يدرك السامع من جاء، ومن نجح، ومن سافر؟ وهذا يبرز أهمية الصفة في تحديد المعنى.
ـ التخصيص: ويراد بالتخصيص تضييق نطاق النكرة الشائعة، وتقليل أفرادها. والصفة تقوم بهذه الوظيفة، تقول: (رجلٌ عاملٌ خيرٌ من رجل لاهٍ، ولا ينال النجاح إلا طالبٌ مجدٌ، ولا ينتصر إلا رجلٌ مؤمن بأهدافه). فعامل، ولاه، ومجد، ومؤمن، هي أمثلة على الصفة التي تخصص كل واحدة منها النكرة التي قبلها، وتقلل من شيوعها، فكل صفة من هذه الصفات تقلل من شيوع الموصوف.
ـ المدح والذم: إذا أردنا المدح أو الذم بغير الأسلوب المطّرد في المدح والذم فإن هناك طرقاً كثيرة في العربية، منها استخدام الصفة. تقول: نناضل لينهض وطننا الغالي، وقد روّى شهداؤنا العظام تراب الوطن بدمائهم، ونسعى لتحقيق أهدافنا العظيمة، ولذلك سننتصر على العدو الباغي إسرائيل، وإن أمدتّه أمريكا الغادرة بوسائل الدمار، فشعبنا الأبيُّ قادر على دحر العدوان اللئيم. فالصفات السابقة جاءت لمعنى المدح أو الذم، ولم تأتِ الصفة للتحديد أو التخصيص أو غير ذلك، وهذا يوضح الدور البلاغي الذي تلعبه الصفة.
ـ التوكيد: تأتي الصفة للتوكيد حينما يكون معناها كمعنى الاسم الموصوف، تقول: (أسقطنا للعدوّ طائرتين اثنتين، وحطمنا له دبّابة واحدة، حين حاول الاعتداء على قواتنا).
وقال تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ}. فالموصوف هنا يدل على التثنية، والصفة (اثنين) لم تزد الموصوف تحديداً أو تخصيصاً، ولكنها زادته توضيحاً وتأكيداً.
ومثله قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}. فـالصفة (واحدة) أكدت الموصوف (نفخة) الذي يتضمن المعنى الذي أدّته الصفة، وهو الدلالة على المرّة الواحدة. وهذا يؤكد أن معنى الصفة هنا هو التوكيد اللفظي. وقال الشاعر:
خَبَلَتْ غَزَالَةُ قَلْبَهُ بِفَوَارِسٍ *** تَرَكَتْ مَنَازِلَهُ كَأَمْسِ الدَّابِرِ
فمعنى الصفة (الدابر) هو معنى الموصوف (أمسِ)، وبذلك دلّت الصفة على التوكيد.
أنواع الصفة
تأتي الصفة اسماً مفرداً وجملة وشبه جملة، وتتنوع أشكال الصفة لتشمل هذه الأنواع.
أ ـ الاسم المفرد: معنى الاسم المفرد ألا يكون جملة ولا شبه جملة، وقد تكون الصفة المفردة مفرداً في العدد أو مثنى أو جمعاً. تقول: (خرج الفلاحون المكافحون إلى حقولهم الواسعة). والأسماء المفردة التي يمكن أن تكون بمثابة الصفة هي متنوعة، منها:
١ـ الأسماء المشتقة: وتسمى في كتب الصرف القديمة (الصفات)، لأن الأصل في الصفة أن تدلَّ على معنى في موصوفها، وغالباً ما تكون أحد المشتقات الآتية (اسم الفاعل، واسم المفعول، والمثقف البصير، والسياسيّ الأقدر على النفاذ إلى حقائق الأمور، والمواطن الواعي، هؤلاء جميعاً يشكلون ركائز الشعب الذي يريد التقدم). فواقف اسم فاعل، ومسؤول اسم مفعول، والبصير صفة مشبهة، والأقدر اسم تفضيل، والواعي اسم فاعل. وهذا النوع من الصفة هو الأكثر شيوعاً.
٢ـ أكثر الأسماء الموصولة: لا يوصف بـ (من وما) من الأسماء الموصولة، ويوصف بـ (الذي) وأخواته، حيث يأتي الاسم الموصول ليعمل عمل الصفة. قال الشاعر:
أَنْتَ الإِمَامُ الَّذِي مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ *** أَلْقَى إِلَيْكَ مَقَالِيدَ النُّهَى الْبَشَرُ
فـ (الذي) صفة لـ (الإمام)، وقال جرير:
إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوَرٌ *** قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلَانَا
فـ (التي) صفة لـ (العيون).
٣ـ الاسم المنسوب: وهو الاسم الذي بـ (ياء) مشددة تدل على نسبة، ويُستخدم الاسم المنسوب كـ صفة للدلالة على الانتماء. تقول: (الشعب العربي يأبى الضيم)، وتقول: (الأدب الشعبي يعبّر عن وجدان الأمة).
وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}.
٤ـ العدد: يمكن للعدد أن يقوم بدور الصفة الرقمية. تقول: (سهرنا لياليَ أربعاً، أنجزنا فيها مقالات ثلاثاً).
٥ـ المصدر: يمكن للمصدر أن يأتي بمثابة الصفة إذا كان معناه كالمشتق، تقول: أبو عمروٍ راوٍ ثقةٍ، ومعنى ثقة: موثوق به، وتقول: عمر بن الخطاب حاكم عَدْل. فمعنى عدل: عادل، وتقول: هذه قضيةٌ حقٌ.
٦ـ الاسم الجامد إذا دلّ على تشبيه: تقول: لا ترافق رجلاً ثعلباً، فمعنى ثعلب: ماكر، والمعنى لا ترافق رجلاً يشبه الثعلب في مكره، أو لا ترافق رجلاً ماكراً. وهذا استخدام بلاغي لـالصفة.
رأيتُ عدّاءً غزالاً. فـ (غزالاً) معناها: مسرعاً، أو رأيت عداءً كغزال.
٧ـ (ذو) التي بمعنى صاحب: هذا تراثٌ ذو آثارٍ عظيمة، وهذا قصرٌ ذو ماض عريق، وهذه مدينة ذات أصالة. وتُعد (ذو) ومشتقاتها صفة شائعة.
٨ـ (كل) و(أي): إذا دلتا على الكمال، وتسمى كلّ الكمالية وأيّ الكمالية. وهنا تكتسب (كل) معنى الصفة الكمالية.
تقول: ابن جنِّي نحويٌ كلُّ نحوي، أو أيُّ نحوي، وقد تضاف (ما) الزائدة لـ (أي).
فتقول: سمعت من أخيك قصيدةً أيّما قصيدةٍ، والمعنى قصيدة بلغت الكمال.
٩ـ (ما): وهي نكرة مبهمة، وتدلُّ على معنى التهويل، أو التعظيم، أو التقليل، أو غير ذلك بحسب النص الذي ترد فيه، وتأتي (ما) النكرة المبهمة كـ صفة للتعبير عن التهويل. من أمثاله: (لأمرٍ ما جَدَع قصيرٌ أنفه) والمعنى: لأمر عظيمٍ. وقال الشاعر:
عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ *** لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ
ب ـ الجملة الواقعة صفة: تقع الجملة صفة للنكرة، ومن هنا شاع القول: الجمل بعد النكرات صفات، ويقصدُ بذلك أن الجملة التي ترتبط بالنكرة هي صفة لها. تقول: (ندافع عن أهداف آمنا بها، ونعتزُّ بانتصارات حققناها، ونفخر بنهضة صناعيةٍ وصلنا إليها).
وقال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}. فجملة (ترجعون) في محل نصب صفة للموصوف (يوماً). وهذا يوضح أن الصفة يمكن أن تكون جملة فعلية.
ويجب أن يربط بين جملة الصفة والموصوف رابط، والضمير الذي يعود من جملة الصفة إلى الموصوف رابطٌ يربط بينهما، وقد يُحذف هذا الضمير، فيُقدّر.
قال الشاعر:
وَمَا أَدْرِي أَغَيَّرَهُمْ تَنَاءٍ *** وَطُولُ الدَّهْرِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا
فجملة (أصابوا) في محل رفع صفة للموصوف المرفوع (مال)، والضمير الرابط محذوف، والتقدير: أصابوه.
والجملة الوصفية جملة خبرية، ولا يمكن أن تكون إنشائية، فإن وقعت الجملة الإنشائية موقع الصفة، فـالصفة محذوفة مقدرة، أو يجب أن نحول الجملة الإنشائية إلى جملة خبرية. تقول: أطعمت رجلاً هل ذاق الخبز؟، فجملة (هل ذاق الخبز) إنشائية، وقعت موقع الصفة، فـالصفة محذوفة تقديرها: مقول فيه: هل ذاق الخبز، أو نقول: إن معنى الجملة الإنشائية هو معنى الخبر، والتقدير أطعمت رجلاً لم يذق الخبز.
ج ـ شبه الجملة: يرى أغلب النحويين أن شبه الجملة يتعلق بـصفة محذوفة إذا ارتبط بموصوف نكرة، وقسم منهم يرى أن شبه الجملة هو الصفة. تقول: كتاب في يدك تقرؤه خيرٌ من كتابٍ على رفوف بيتك. فالجار والمجرور في المثال السابق وقع موقع الصفة، فهو متعلق بـصفة محذوفة لـ (كتاب). وتقول: ثورةٌ من غير ثوّارٍ حقيقيين كفريق بين الأمواج. فالجار والمجرور (من غير)، والظرف (بين)، وقعا موقع الصفة، فالتعليق بـصفة محذوفة. ويُعرب شبه الجملة في محل إعراب الصفة المحذوفة.
المطابقة بين الصفة والموصوف
تطابق الصفة موصوفها في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والحركات الإعرابية. وهذه المطابقة من أهم قواعد الصفة الحقيقية. تقول: (الطالب الواعي، والطالبة الواعية، يدركان أن مصلحتهما في كسب علم نافع، ومعرفة جيدة، والطلاب المتفوقون يفيدون أنفسهم وبلادهم).
وإذا كان الموصوف جمعاً مما لا يعقل جاز أن تكون الصفة مفردة وجمعاً، تقول: مررت بحقولٍ مزروعةٍ أو مزروعاتٍ.
إلا إذا كانت الصفة على وزن (أفعل) للمذكر، و(فعلاء) للمؤنث، و(فُعْل) للجمع، فلا بد حينئذ من المطابقة، هذه حقول خضر، يعمل فيها رجال شُقر، لهم عيون زُرْق.
هذه المطابقة تكون فيما يسمى الصفة الحقيقية، وهي التي تتوجه إلى الموصوف بالتحديد أو التخصيص أو المدح أو الذم أو التأكيد، وهناك قسم آخر لـالصفة، لا يتوجه إلى الموصوف، بل إلى ما له ارتباط بالاسم الموصوف، وتسمى هذه الصفة (الصفة السببية). تقول: (نودُّ أن نبني جيلاً سليماً جسمه، كريماً خلقُه، راجحاً عقله، عظيمةُ همتُه، يتحمل الشدائد، ويقوى على الصعاب). فهذه الصفات كلها أمثلة على الصفة السببية، لأنها لا تتجه إلى الاسم الموصوف (جيلاً)، بل إلى ما له ارتباط به، فالجسم هو الموصوف بالسلامة، والخلق هو الموصوف بالكرم، والعقل هو الموصوف بالرجاحة، والهمة هي الموصوف بالعظمة.
وهذا القسم من الصفة يطابق الاسم الموصوف في التعريف والتنكير والحركة الإعرابية، ولا يطابقه في التذكير والتأنيث. ولا في الإفراد والتثنية والجمع، فهما يطابقان ما له ارتباط بالاسم الموصوف في التذكير والتأنيث، وتبقى الصفة مفردة، سواء أكان ما له ارتباط بالاسم الموصوف مفرداً أم مثنى أم جمعاً، تقول: (أخواك الطيّبةُ أخلاقهما ناجحان في عملهما). فكلمة (الطيبة) صفة سببية للمبتدأ (أخوك). ولكنها لا تطابقه في التذكير ولا في التثنية، وتطابقه في التعريف والحركة الإعرابية، ثم هي تطابق ما ارتبط بالاسم الموصوف (أخلاقهما) في التأنيث، ولا تطابقه في الإفراد والتثنية والجمع، فقد كانت الصفة مفردة، وهو مثنى.
تعدد الصفة والموصوف
تتعدد الصفة للموصوف الواحد، تقول: (المرأة الصالحة أمٌّ مخلصة في عملها، مربية لأطفالها، مؤمنة بوطنها، تعمل على تنشئة أولادها تنشئة صالحة، وتضفي على بيتها بهجة وسعادة).
فالكلمات مخلصة، ومربية، ومؤمنةً، وجملة (تعمل)، كلها من صفات الأم. قال الشاعر:
كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبٍ *** وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الْكَوَاكِبِ
فالموصوف (ليل)، وجملة (أقاسيه) صفة، وكلمة (بطيء) صفة.
ويتعدد الموصوف والصفة واحدة، فتثنى الصفة أو تجمع، تقول: أكرمت العامل والفلاح المجدّين، وكرّمت الإدارة أحمد ومحمد وخالداً المتفوقين.
أما إذا كان الموصوف مثنى أو جمعاً، واختلفت الصفتان أو الصفات، فلا بدّ من التفريق والعطف، تقول: مررت برجلين: شاعرٍ وكاتبٍ. قال الشاعر:
بَكَيْتُ وَمَا بُكَاءُ رَجُلٍ حَزِينٍ *** عَلَى رَبْعَيْنِ: مَسْلُوبٍ وَبَالِ؟
الحذف
يحذف الموصوف كثيراً، وتُحذف الصفة قليلاً.
أ ـ حذف الموصوف: إذا حذف الموصوف قامت صفته مقامه، حتى أن بعض الصفات صارت ترادف موصوفاتها، كصفات السيف، والأسد، والناقة، والفرس.
قال تعالى: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ}. والتقدير: وعندهم نساء قاصرات الطرف عين، وقال تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}.
والتقدير: اعمل دروعاً سابغات، وقال الشاعر:
كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا *** فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ
والتقدير: كوعلٍ ناطح.
ب ـ حذف الصفة: حذف الصفة نادر، يحتاج إلى دليل معنوي واضح.
قال الشاعر:
وَرُبَّ أَسِيلَةِ الْخَدَّيْنِ بِكْرٍ *** مُهَفْهَفَةٍ لَهَا فَرْعٌ وَجِيدُ
والتقدير: لها فرع وجيد طويلان، قال تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}. والتقدير: كل سفينة صالحة.
قطع الصفة
هذا أسلوب بلاغي، فلا بدّ له من مسوغات بلاغية فنيّة، حتى يمكن سلوكه، ويتلخص هذا الأسلوب في أن نغيّر الحركة الإعرابية لـالصفة المجرورة إلى الرفع والنصب، ونغير الحركة الإعرابية لـالصفة المرفوعة إلى النصب، وحركة الصفة المنصوبة إلى الرفع، ويتم ذلك إذا أراد المتكلم مدحاً، أو ذماً، أو فخراً، أو ترحماً.
جاء في قراءة الآية الأولى من سورة الفاتحة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. فكلمة (رب) هي في الأصل صفة لكلمة (الله)، ولكن يمكن قطع هذه الصفة، وجعلها مرفوعة، فتعرب خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو).
والهدف من ذلك هو المدح، ويمكن جعلها منصوبة، فتعرب مفعولاً به لفعل محذوف تقديره (أمدح).
وقال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}. فكلمة (حمالة) مقطوعة عن الصفة، وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره (أذمّ).
خاتمة
وهكذا، نصل إلى ختام رحلتنا في استكشاف الصفة كعنصر محوري في بنية الجملة العربية. لقد رأينا كيف أن الصفة تتجاوز كونها مجرد كلمة تصف، لتصبح أداة دلالية وبلاغية قوية تمنح النص أبعاده من تحديد وتخصيص وتوكيد، وتزينه بلمسات من المدح أو الذم. ومن خلال استعراض أنواعها المتعددة، بدءًا من الصفة المفردة ومشتقاتها، مرورًا بالجملة وشبه الجملة، وصولًا إلى الصفة السببية وأحكامها الخاصة، يتضح لنا مدى المرونة والغنى الذي تتمتع به اللغة العربية. إن فهم قواعد الصفة وإتقان استخدامها لا يعزز الدقة النحوية فحسب، بل يفتح الباب واسعًا أمام التعبير الفني والإبداعي، مؤكدًا على أن كل صفة تختارها هي بمثابة ريشة فنان ترسم ملامح المعنى بوضوح وجمال.