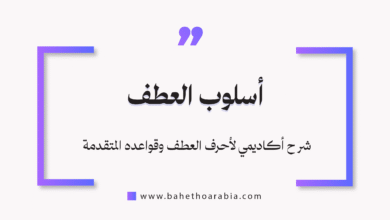معاني رب: وأحكامها ولغاتها وكيف تعمل في الجملة؟
هل تعرف كيف تستخدم رب في التقليل والتكثير وما أحكامها النحوية الدقيقة؟

تُشكل الأدوات النحوية في اللغة العربية منظومة متكاملة من المعاني والدلالات التي تثري التعبير وتمنحه أبعاداً جديدة. لقد احتلت أداة رب مكانة خاصة بين أدوات الجر لما لها من خصائص فريدة وأحكام دقيقة تميزها عن غيرها من الحروف؛ إذ إنها تفتح أمام المتكلم آفاقاً واسعة للتعبير عن التكثير والتقليل بأساليب بلاغية رفيعة المستوى.
المقدمة
إن دراسة رب تقتضي الوقوف عند جوانب متعددة تشمل معانيها المختلفة وأحكامها النحوية وخصائصها التركيبية. فقد اختلف النحويون في تحديد معناها الأصلي، وتباينت آراؤهم حول طبيعتها الإعرابية وموقعها في الجملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن لهذه الأداة أحكاماً خاصة تتعلق بمجرورها وصدارتها وإمكانية كفها عن العمل، فضلاً عن تعدد لغاتها التي بلغت ستة عشر وجهاً في النطق والكتابة.
تتطلب معرفة رب فهماً عميقاً لسياقاتها المختلفة وطرق استعمالها في الكلام المنظوم والمنثور. كما أن الإلمام بتفاصيلها الدقيقة يساعد على استيعاب النصوص العربية القديمة وتذوق جمالياتها البلاغية، ويمكّن الدارس من توظيفها توظيفاً صحيحاً في تعبيراته اللغوية المختلفة.
ما معنى رب بين التكثير والتقليل؟
يُعَدُّ الخلاف في معنى رب من أبرز المسائل النحوية التي شغلت علماء العربية عبر العصور. لقد أشار سيبويه في كتابه إلى أن رب تفيد معنى التكثير، وجعل معناها مماثلاً لمعنى كم الخبرية التي تدل على الكثرة. هذا وقد استند في ذلك إلى استقراء كلام العرب وملاحظة السياقات التي ترد فيها هذه الأداة، فوجد أنها تستخدم كثيراً للدلالة على كثرة وقوع الأمر لا قلته.
على النقيض من ذلك، فقد ذهب المبرد وأغلب النحويين إلى أن رب تفيد معنى التقليل في الأصل. فما هي حججهم في ذلك؟ لقد علل بعضهم هذا الرأي بأن رب لا تعمل إلا في النكرة، والنكرة تدل على الكثرة والشيوع في أصلها؛ إذ إن التقليل لا يكون إلا من الكثرة، فكأن رب تقلل من الكثرة الموجودة في النكرة. كما أن بعضهم رأى أنها نقيضة كم الخبرية في المعنى، فإذا كانت كم للتكثير فرب للتقليل بالضرورة.
بينما اتخذ فريق ثالث من النحويين موقفاً وسطياً يجمع بين الرأيين. فقد ذهبوا إلى أن رب للتقليل في أصل وضعها، لكنها قد تُستعمل للدلالة على التكثير على سبيل المجاز، وذلك في مواضع الافتخار والمباهاة. انظر إلى قول عمر بن البراد: “وذي رحمٍ، ذي حاجةٍ قد وصلتها، إذا رحمُ القطاع نشّت بلالها”، فهو يفتخر بكثرة صلته لذوي الأرحام، فاستعمل رب للدلالة على التكثير مجازاً. وكذلك قول الأعشى: “رب رفدٍ هرقته ذلك اليوم، وأسرى من معشرٍ أقتال”، فهو يفتخر بكثرة عطاياه وأسراه.
ومن الشواهد البليغة على استعمال رب للتكثير المجازي قول امرئ القيس: “ألا رب يومٍ، لك منهن، صالح، ولاسيما يوماً بدارة جلجل”، فالشاعر يتحدث عن كثرة أيامه الصالحة مع النساء. أما التقليل الحقيقي فيظهر جلياً في مجرور رب نفسه، كقول رجل من أزد السراة: “ألا رب مولودٍ، وليس له أبُ، وذي ولدٍ لم يلده أبوان”؛ إذ إن المولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام، وذو الولد الذي لم يلده أبوان هو آدم عليه السلام، وهذان ليس لهما نظير في الوجود، فالتقليل هنا واضح لا لبس فيه.
الجدير بالذكر أن التقليل قد يكون في نظير المجرور لا في المجرور نفسه. فهل يا ترى يمكن أن تدل رب على القلة رغم أن مجرورها ليس قليلاً؟ الإجابة نعم، كما في قول زهير: “وأبيضُ فياضٍ، يداه غمامةٌ، على معتفيه، ما تغب فواضله”، فهذا مثال على التقليل في نظير المجرور؛ إذ أراد الشاعر بالأبيض حصن بن حذيفة فقط، ولم يرد جماعة كثيرة تتصف بهذه الصفات.
وقد ذكر الرضي رأياً مثيراً للاهتمام، فبين أن رب للتقليل أصلاً، ثم كثر استعمالها في معنى التكثير حتى صارت في هذا المعنى كالحقيقة، وفي التقليل كالمجاز المحتاج إلى قرينة تدل عليه. أما ابن مالك فقد خالف الجمهور وتبنى رأي سيبويه، وصرح بأن الصحيح أن معنى رب الغالب هو التكثير لا التقليل، وأن سيبويه قد نص على ذلك صراحة. لقد استدل ابن مالك بشواهد كثيرة من النظم والنثر تدل على التكثير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة”، فالمراد هنا الكثرة لا القلة بلا شك.
بالإضافة إلى ذلك، تابع ابن هشام ما رآه ابن مالك في معنى رب، فذكر أنها ترد للتكثير كثيراً، وللتقليل قليلاً. وقد استشهد على التكثير بقول العرب: “يا رب صائمةٍ لن يصومه، وقائمه لن يقومه”، فالمعنى أن كثيراً من الصائمات في الدنيا لن يصمن يوم القيامة، وكثيراً من القائمات لن يقمن فيه.
ما شروط مجرور رب وأنواعه؟
لقد وضع النحويون شروطاً محددة لمجرور رب تميزه عن مجرورات الحروف الأخرى. إن أول هذه الشروط وأهمها أن مجرور رب لا يكون إلا نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة بأي وجه من وجوه التعريف. فقد شبه النحويون مجرور رب باسم لا النافية للجنس في اشتراط التنكير، فكلاهما يجب أن يكون نكرة حتى يصح العمل فيه. هل سمعت به من قبل أن مجرور رب قد يكون موصوفاً أو غير موصوف؟
أما المجرور الموصوف فتتعدد أنواع صفته وتتنوع صورها. فقد تكون الصفة اسماً صريحاً، نحو: رب رجلٍ صالحٍ، حيث جاءت الصفة نعتاً مفرداً يصف المجرور. وقد تكون الصفة جملة فعلية، نحو: رب رجلٍ يفهم ذاك، فالجملة الفعلية “يفهم ذاك” في محل جر صفة لـ “رجل”. كما أن الصفة قد تكون جملة اسمية حُذف مبتدؤها، كقول ذي الرمة: “ورملٍ، عزيف الجن في عقداته، زيرٌ كتضراب المغنين بالطبل”، فالتقدير: ورب رملٍ هو عزيف الجن، والجملة الاسمية “هو عزيف الجن” صفة لـ “رمل”، لكن المبتدأ “هو” محذوف.
ومما يُستحسن ذكره قول ثابت قطنة: “إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك، ورب قتلٍ، عارُ”، فقد أراد الشاعر: ورب قتل هو عار، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ المحذوف “هو” والخبر “عار” في محل جر صفة لـ “قتل”. بالمقابل، فقد تكون الصفة ظرفاً متعلقاً بصفة محذوفة، نحو: رب رجل عندك، فالظرف “عندك” يتعلق بصفة محذوفة تقديرها “كائن” أو “مستقر”، والتقدير: رب رجل كائن عندك.
أما المجرور غير الموصوف فيأتي مباشرة بعد رب دون أن تلحقه صفة ظاهرة. من ذلك قول أم معاوية: “يا رب قائلةٍ، غداً، يا لهف أم معاوية”؛ إذ جاء “قائلة” مجروراً بـ رب دون صفة ظاهرة. لكن بعض النحويين ذكروا أنه يجوز أن يكون الموصوف محذوفاً في مثل هذا الموضع، فيكون التقدير: يا رب امرأة قائلة، فحُذف الموصوف “امرأة” وأُقيمت الصفة “قائلة” مقامه.
من ناحية أخرى، فقد نقل أبو حيان عن بعض النحويين أنهم أجازوا أن يكون مجرور رب معرفاً بأل، وذلك في حالات نادرة. من جهة ثانية، استشهدوا على ذلك بقول الشاعر: “ربما الجام الموءبل، فيهم، والعناجيج، بينهن المهار”، لكن الجمهور حملوا هذا على زيادة أل إن صحت الرواية؛ إذ إن الأصل في مجرور رب أن يكون نكرة لا معرفة.
وعليه فإن مجرور رب قد يكون نكرة موصولة بـ “مَنْ” أو “ما”. فقد استدل سيبويه والنحويون على مجيء “من وما” نكرتين بجرهما بـ رب، فهما يدلان على شخص مبهم أو شيء مبهم دون تحديد. انظر إلى قول عمرو بن قميئة: “يا رب من يبغض أزوادنا، رحن على بغضائه واعتدين”، فالتقدير: يا رب إنسان يبغض أزوادنا، فـ “من” هنا نكرة موصولة بمعنى “إنسان”. وكذلك قول أمية بن أبي الصلت: “ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال”، فأراد: رب شيء أو أمر تكرهه النفوس، فـ “ما” نكرة موصولة.
بينما قد يكون مجرور رب مضافاً على نية التنكير، رغم أن إضافته قد توهم التعريف. برأيكم ماذا يعني أن يكون المضاف نكرة رغم إضافته؟ الإجابة هي أن المضاف يكون نكرة في المعنى وإن كان ظاهره التعريف. من ذلك قول جرير: “يا رب غابطنا، لو كان يعرفكم، لاقى مباعدةً، منكم، وحرمانا”، فالتقدير: يا رب غابطٍ لنا، فـ “غابطنا” مضاف على نية التنكير. كما قال أبو محجن الثقفي: “يا رب مثلك، في النساء، غريرةٌ، بيضاء، قد متعتها بطلاق”، فأراد: يا رب مثلٍ لك. لقد قال سيبويه في هذا الصدد: ورب لا يقع بعدها إلا نكرة، فذلك يدلك على أن “غابطنا ومثلك” نكرة في المعنى.
كما أن النحويين بينوا أنه قد يعطف على مجرور رب اسم مضاف معناه النكرة، نحو: رب رجل وأخيه منطلقين، أي: رب رجل وأخٍ له منطلقان. لكن هذا الاستعمال نادر في كلام العرب، ولا يُقاس عليه. ومما يثير الانتباه أن مجرور رب قد يكون ضمير النكرة على شريطة التفسير، نحو: ربه رجلاً، حيث جاء الضمير “ه” مجروراً بـ رب، وفُسر بالنكرة “رجلاً” المنصوبة على التمييز.
فقد سمى الكوفيون هذا الضمير “ضمير المجهول”، بينما سماه الزمخشري “ضمير التنكير”، وهو ضمير خاص لا يطابق مميزه في الأصل. لكن حكي عن الفراء والكوفيين وغيرهم أنه قد يطابق المميز، فيقال: ربه رجلاً، وربتها امرأةً، وربتهما رجلين، وربتهم رجالاً، وربتهن نساء. وقد استدل ابن الخشاب على ذلك بقول حمزة بن أبي تمثل: “ماويّ بل ربتها غارةً، شعواء كاللذغة بالميسم”، فطابق بين رب وتمييزها “غارة” في التأنيث.
كيف يتحدد الموقع الإعرابي لمجرور رب؟
تحديد الموقع الإعرابي
ذهب أكثر النحويين إلى أن رب زائدة في الإعراب لا في المعنى، فهي تؤثر في المعنى بدلالتها على التقليل أو التكثير، لكنها لا تؤثر في الإعراب الحقيقي للاسم الذي بعدها. فما الذي يعنيه أن تكون رب زائدة في الإعراب؟ إنه يعني أن الاسم المجرور بها يُعرب بحسب موقعه في الجملة لا بحسب جره الظاهر. لقد ذكر المتأخرون أن رب شبيهة بحرف الجر الزائد، فيُحكم على موضع مجرورها بالرفع أو النصب على حسب العامل الذي بعدها.
إذاً كيف نحدد الموقع الإعرابي لمجرور رب في الجملة؟ إن تحديد ذلك يعتمد على طبيعة العامل الذي يليها. فإذا جاء بعد مجرور رب خبر أو شبه جملة لم يستوف مفعوله، كان موضع المجرور رفعاً على الابتداء. تقول: رب رجلٍ صالحٍ عندي، فيكون موضع “رجل” رفعاً على الابتداء، وشبه الجملة “عندي” خبره، والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. بينما إذا جاء بعد المجرور فعل لم يستوف مفعوله، كان موضع المجرور نصباً على المفعولية.
تقول: رب رجل صالح لقيتُ، فيكون موضع “رجل” النصب على أنه مفعول به لـ “لقيت”؛ إذ إن الفعل “لقيت” لم يستوف مفعوله الظاهر. أما إذا جاء الفعل مستوفياً مفعوله بضمير يعود على المجرور، فيجوز في موضع المجرور وجهان: الرفع على الابتداء، أو النصب على المفعولية بفعل محذوف يفسره المذكور. تقول: رب رجل صالح لقيته، فيجوز أن يكون موضع “رجل” رفعاً على الابتداء، والجملة الفعلية “لقيته” في محل رفع خبر، ويجوز أن يكون موضعه نصباً بفعل محذوف تقديره “لقيت”، والجملة المذكورة مفسرة لا محل لها من الإعراب.
مراعاة المحل في العطف
من جهة ثانية، يجوز مراعاة محل مجرور رب كثيراً في باب العطف، فيُعطف على محله لا على لفظه. لقد استشهد النحويون على ذلك بقول امرئ القيس: “وسنٍ كسنيق سناءً وسنما، ذعرت بمدلاج الهجير نهوضِ”؛ إذ عطف “سناً” بالنصب على موضع “سن” المجرور لفظاً برب، فموضعه النصب على المفعولية لـ “ذعرت”، فجاز العطف على المحل. هذا وقد يُعطف على اللفظ فيُجر المعطوف تبعاً للمجرور الظاهر، لكن العطف على المحل أكثر وأفصح.
الجدير بالذكر أن تحديد موقع مجرور رب يساعد على فهم التركيب النحوي للجملة وإعرابها الصحيح. كما أن معرفة إمكانية العطف على المحل تُسهل فهم كثير من التراكيب الشعرية التي قد تبدو مشكلة للوهلة الأولى. ومما يؤكد أهمية هذه المسألة أن كثيراً من النحويين أفردوا لها مباحث مستقلة في مصنفاتهم، وتناولوها بالشرح والتفصيل.
إن فهم الموقع الإعرابي لمجرور رب يتطلب إدراكاً عميقاً لمفهوم الزيادة في الإعراب دون المعنى. فرب ليست زائدة للتوكيد فقط، بل هي تضيف معنى جديداً للجملة، لكنها لا تؤثر في الإعراب الأصلي للاسم الذي تدخل عليه. وعليه فإن النحوي الماهر يستطيع أن يحدد موضع المجرور بدقة من خلال تحليل السياق والنظر في العوامل المؤثرة في الجملة.
متى تُضمر رب وما أحكام إضمارها؟
تُضمر رب بعد حروف معينة تصير عوضاً منها، وهذا الإضمار لكثرة الاستعمال والتخفيف في الكلام. لقد ذكر النحويون أن رب تُضمر بعد ثلاثة أحرف: الواو، والفاء، وبل، فتنوب هذه الحروف عنها وتصير بمنزلتها في العمل. أما إضمار رب بعد الواو فهو الأكثر شيوعاً في كلام العرب شعراً ونثراً. من ذلك قول الشاعر العنبري: “وجداء ما يُرجى بها ذو قرابة، لعطف، وما يخشى السماة ربيبها”، فأراد: ورب جداء، فحُذفت رب وبقيت الواو عوضاً منها تعمل عملها في جر “جداء”.
كما استشهدوا بقول امرئ القيس: “ومثلك بكراً قد طرقت وثيباً، فألهيتها عن ذي تمائم مغيل”؛ إذ أراد: ورب مثلك، فحذف رب وأبقى الواو عوضاً منها. أما إضمار رب بعد الفاء فقد جاء في قول امرئ القيس نفسه برواية أخرى: “فمثلك بكراً قد طرقت وثيباً”، فالتقدير: فرب مثلك. وأما إضمار رب بعد بل فمن ذلك قول رؤبة: “بل بلدٍ ملء الفجاج فتقه، لا يشترى كتانه وقزه”؛ إذ أراد: بل رب بلد، فحذف رب وأبقى بل عوضاً منها.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر بعض النحويين أن رب قد تُضمر بلا عوض، وإن كان ذلك نادراً في الاستعمال. من ذلك قول جميل: “رسم دارٍ وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله”، فالتقدير: رب رسم دار، فحُذفت رب دون أن يبقى عوض منها. لكن هذا الوجه قليل جداً، والأكثر أن يكون لها عوض من الحروف المذكورة.
لقد أشار سيبويه إلى أن بعض العرب ينصب بالفعل مباشرة إذا أُضمرت رب، دون النظر إلى محل المجرور. وقد استدل على ذلك بقول الشاعر: “ومثلك رهبى قد تركت رزيةً، تقلب عينيها إذا مر طائر”، فنصب “مثلك” بالفعل “تركت” مباشرة. فقد قال سيبويه: سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب، مما يدل على أن هذه لغة قليلة لكنها موجودة.
ومما ذكره ابن مالك أن رب تُضمر بعد الفاء كثيراً، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليلاً، ومع التجرد عن العوض أقل. إذاً فإن كثرة الإضمار تختلف باختلاف الحرف الذي يعوض عن رب، فالواو أكثر استعمالاً من الفاء، والفاء أكثر من بل، والإضمار بلا عوض هو الأقل على الإطلاق.
من ناحية أخرى، فقد اختلف النحويون في عمل هذه الأحرف التي تنوب عن رب المضمرة. فذهب بعضهم إلى أن الجر بهذه الحروف نفسها، لأنها صارت عوضاً من رب فحلت محلها في العمل، فهي كالهمزة وها التنبيه في حروف القسم. وعللوا ذلك بأن حروف العطف لا تقع في أول الكلام، فلما وقعت في الأول دل ذلك على أنها صارت عاملة بنفسها لا عاطفة.
على النقيض من ذلك، رأى بعضهم أن هذه الحروف تبقى على أصلها في العطف، وأن الجر إنما هو بـ رب المضمرة لا بهذه الحروف. لقد استدلوا على ذلك بوقوع الفاء جواباً للشرط وقد أُضمرت بعدها رب، نحو قول تأبط شراً: “فإما تعرضن، أميم، عني، وينزعك الوشاة أولو النياط، فحورٍ قد لهوت بهن عين، نواعم في البرود وفي الرباط”، فالتقدير: فرب حور، والفاء جواب الشرط، فلو كانت الفاء هي الجارة لما صح أن تكون جواباً للشرط. كما استدلوا بجر الاسم بعد بل، ولا يُعلم أن أحداً من النحويين قال بأن بل تجر الأسماء بنفسها.
أين تقع رب في الكلام؟
تقع رب في صدر الكلام غالباً، فهي من الكلمات التي لها حق الصدارة في الجملة. لقد جعل النحويون صدارتها من الأدلة على اسميتها عند من يرى ذلك، ومن خصائصها المميزة عند من يراها حرفاً. إن رب تفتتح بها الجمل الإنشائية والخبرية على السواء، فتقول: رب رجل كريم لقيته، فجاءت رب في صدر الجملة. كما تقول: يا رب رجل صالح عندك، فجاءت في الصدر بعد حرف النداء.
لكن قد تقع رب في غير الصدر في مواضع معينة. من ذلك وقوعها في خبر إن المؤكدة، نحو قول حاتم الطائي: “أماوي إني رب واحد أمه، أخذت، فلا قتل عليه، ولا أسر”؛ إذ وقعت رب في خبر إن، فلم تكن في صدر الكلام بل في وسطه. ومثل ذلك وقوعها في خبر أن المخففة، نحو قول الشاعر: “تيقنت أن رب امرئ خيل خائناً، أمين، وخوان يخال أمينا”، فوقعت رب في خبر أن المخففة من الثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تقع رب في جواب لو الشرطية، نحو قول الشاعر: “ولو علم الأقوام كيف خلقتهم، لرب مفدّ في القبور وحامد”؛ إذ وقعت رب في جواب لو، فجاءت بعد اللام الواقعة في جواب الشرط. هذا وقد وصف أبو حيان هذا الاستعمال بالغريب، مما يدل على قلته وندرته في كلام العرب.
فهل يا ترى يؤثر موقع رب في معناها أو عملها؟ في الحقيقة، إن موقع رب لا يؤثر في عملها الإعرابي، فهي تعمل الجر في النكرة سواء أكانت في الصدر أم في غيره. كما أن معناها من التقليل أو التكثير لا يتغير بتغير موقعها، وإنما يُستفاد من السياق والقرائن المحيطة بها. لكن موقعها قد يؤثر في أسلوب الجملة وبلاغتها، فوقوعها في الصدر يعطي الجملة قوة وتأكيداً، بينما وقوعها في غير الصدر قد يجعلها جزءاً من تركيب أكبر.
كما أن صدارة رب تجعلها من أدوات التشويق والجذب في الكلام، فالمتكلم حين يبدأ بـ رب يشوق السامع إلى معرفة ما بعدها من الكلام. وعليه فإن للصدارة أثراً بلاغياً لا ينبغي إغفاله عند دراسة رب وأحكامها. ومما يدعم هذا المعنى أن كثيراً من الشعراء استخدموا رب في مطالع قصائدهم لجذب الانتباه وتحريك المشاعر، فهي أداة بلاغية رفيعة المستوى.
هل رب حرف أم اسم؟
الخلاف في طبيعة رب
ذهب أكثر النحويين إلى أن رب حرف جر بمنزلة من وغيرها من حروف الجر. لقد استدلوا على ذلك بأنه لا يُخبر عنها، فلا يصح أن نقول: رب قائمٌ، على أن “قائم” خبر رب، بخلاف الأسماء التي يصح الإخبار عنها. كما أن رب تدل على معنى في غيرها لا في نفسها، وهذا من خصائص الحروف، فهي تدل على التقليل أو التكثير في المجرور الذي بعدها لا في ذاتها.
بينما نُقل عن الكسائي والأخفش وآخرين أن بعض العرب يجعلون رب اسماً فيخبرون عنها. فقد كانوا يقولون: رب رجلٍ ظريفٌ، على أن “ظريف” خبر رب، و”رجل” مضاف إليها. وقد استدل الأخفش على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في الآخرة”، فقد روى الحديث برفع “عارية” على أنها خبر رب، و”كاسية” مضافة إليها.
كما استشهدوا بقول ثابت قطنة الذي مر ذكره: “إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك، ورب قتلٍ عارُ”، فـ “رب” مبتدأ، و”قتل” مضاف إليها، و”عار” الخبر مرفوع. لقد استحسن ابن الطراوة مذهب الكسائي وقوّاه، حتى روي عنه أنه قال: ومنذ سمعت هذا القول لم أقدر أن أعرج عنه، وإن كانوا قد احتجوا بأن رب حرف لأن حروف الجر لا تدخل عليها كما تدخل على كم.
فقد قوى الرضي كذلك مذهب الأخفش والكوفيين في اسمية رب، فقال: ويقوى عندي مذهب الأخفش والكوفيين، أعني كونها اسماً، فـ رب مضاف إلى النكرة، فمعنى “رب رجل” في أصل الوضع: قليل من هذا الجنس، فهي اسم بمعنى القليل أو الكثير، وتضاف إلى النكرة فتفيد معناها.
حجج الفريقين
أما البصريون فقد أولوا الشواهد التي استدل بها الكوفيون على إضمار المبتدأ في الجملة. فقالوا في “رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة”: إن التقدير “رب كاسية في الدنيا هي عارية في الآخرة”، فحُذف المبتدأ “هي”، والجملة الاسمية صفة لـ “كاسية”. وكذلك في بيت ثابت قطنة، قالوا: التقدير “رب قتل هو عار”، فالجملة صفة لـ “قتل”، ولا إخبار عن رب.
لقد عدد الأنباري حجج الكوفيين في اسمية رب فحصرها في أربع حجج. الأولى أن رب لا تقع إلا في أول الكلام، وهذا من خصائص الأسماء لا الحروف. والثانية أنها لا تعمل إلا في النكرة، وهذا يشبه عمل المبتدأ في الخبر. والثالثة أن نكرتها موصوفة غالباً، فكأن الصفة خبر عنها. والرابعة أنه لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به، وذلك كله يخالف أحكام حروف الجر.
ومما أورده الأنباري من رد البصريين عليهم أن رب حرف لا اسم، لأنه لا تحسن فيها علامات الأسماء من التنوين والتعريف والإسناد. كما أن معناها في غيرها لا في نفسها، فهي تدل على التقليل أو التكثير في المجرور لا في ذاتها، وهذا من خصائص الحروف. أما وقوعها في أول الكلام فهذا يشبهها بحروف النفي مثل “ما” و”لا”، فكثير من الحروف لها الصدارة. وأما عملها في النكرة فذلك ليصح التقليل بها؛ إذ إن النكرة تدل على الكثرة والشيوع، فرب تقلل من هذه الكثرة.
كيف تُكف رب عن العمل؟
ذكر سيبويه أن ما تكف رب عن العمل، فتهيئها للدخول على الأفعال بعد أن كانت مختصة بالأسماء. فإذا اتصلت ما بـ رب صارتا كلمة واحدة، وبطل عمل رب في الجر، فلا تجر الاسم بعدها، بل يليها الفعل مباشرة. تقول: ربما يقول ذاك، فـ “ما” كفت رب عن العمل، فلم تجر شيئاً، ودخلت على الفعل “يقول” مباشرة.
لقد ذكر ابن السراج أن رب إذا كُفت عن العمل بـ ما لم يلها إلا الفعل الماضي في الأصل. فإذا وقع بعدها الفعل المضارع كان ذلك على إضمار كان، نحو قوله تعالى: “ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين”، فالتقدير: ربما كان يود الذين كفروا، فحُذفت “كان” وبقي المضارع “يود”. هذا هو مذهب جمهور البصريين في تخريج دخول رب المكفوفة على المضارع.
على النقيض من ذلك، حُكي عن الأخفش أن ما ليست كافة لـ رب عن العمل، وإنما هي نكرة تامة بمعنى “شيء”، فالتقدير: رب شيء يود، فـ “ما” مجرورة بـ رب، والفعل بعدها صفة لها. لكن هذا المذهب لم يرتضه الجمهور، وبقي مذهب سيبويه هو المشهور في كف رب بـ ما.
من جهة ثانية، اختلف النحويون في وقوع الجملة الاسمية بعد رب المكفوفة. فبعضهم أجاز ذلك في الشعر خاصة، فيقول الشاعر: ربما زيدٌ قائمٌ، فتدخل رب المكفوفة على الجملة الاسمية. وبعضهم أجاز ذلك في الكلام مطلقاً شعراً ونثراً، فيقال: ربما زيدٌ في الدار. لكن الأكثر أن تدخل رب المكفوفة على الفعل لا على الاسم، وهذا هو الأفصح والأشهر في الاستعمال.
بالإضافة إلى ذلك، رأى بعض النحويين أن ما قد تكون ملغاة زائدة، فلا تكف رب عن العمل، بل تبقى رب عاملة والاسم بعدها مجروراً. من ذلك قول عدي بن الرعلاء: “ربما ضربةٍ بسيف صقيل، دون بصرى، وطعنة نجلاء”، فجر “ضربة” بـ رب على أن “ما” زائدة ملغاة لا عمل لها. لكن هذا الوجه نادر جداً، والأكثر أن تكون ما كافة فتدخل رب على الفعل.
فما هي الحكمة من كف رب بـ ما؟ إن الحكمة من ذلك هي التوسع في الاستعمال، فرب في أصلها تختص بالأسماء النكرة، فإذا أُريد الدلالة على معناها مع الأفعال كُفت بـ ما فصارت تدخل على الأفعال. وهذا من سعة اللغة العربية ومرونتها في التعبير عن المعاني المختلفة بطرق متنوعة.
ما لغات رب المختلفة؟
أشار النحويون إلى لغات رب سواء أكانت مفردة أم متصلة بتاء التأنيث، وقد تعددت هذه اللغات حتى بلغت ستة عشر وجهاً في النطق والكتابة. إن تعدد لغات رب يدل على كثرة استعمالها في القبائل العربية المختلفة، وعلى اختلاف لهجاتهم في نطقها وضبطها. لقد جمع النحويون هذه اللغات من كلام العرب شعراً ونثراً، ودونوها في كتبهم ليحفظوها للأجيال.
لغات رب المفردة والمقترنة بالتاء
أما لغات رب فهي كالتالي:
- رُبَّ بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة، وهي اللغة المشهورة الفصحى
- رُبَ بضم الراء وتخفيف الباء المفتوحة
- رُبْ بضم الراء وإسكان الباء
- رَبْ بفتح الراء وإسكان الباء
- رَبَّ بفتح الراء وتشديد الباء المفتوحة
- رِبَّ بكسر الراء وتشديد الباء المفتوحة
أما لغات رب المقترنة بتاء التأنيث فهي:
- رُبَّتْ بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رَبَّتْ بفتح الراء وتشديد الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رُبَتْ بضم الراء وتخفيف الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رَبَتْ بفتح الراء وتخفيف الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رُبَّتْ بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رَبَّتْ بفتح الراء وتشديد الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رَبَتْ بفتح الراء وتخفيف الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رُبَتْ بضم الراء وتخفيف الباء المفتوحة والتاء الساكنة
- رُبَتَ بضم الراء وتخفيف الباء وفتح التاء
- رَبَّتَ بفتح الراء وتشديد الباء وفتح التاء
لقد حكي عن الكسائي أنه أجاز أن تقلب تاء التأنيث هاءً في “ربت” لانفتاح ما قبلها، فتقول: ربه رجلاً، كما تقول في الوقف على المربوطة. لكن هذا الوجه قليل جداً في الاستعمال. بينما ذكر الرماني أن “رِبَّ” بكسر الراء ليست بلغة صحيحة، وإنما اللغات الصحيحة هي بضم الراء أو فتحها. كما روي عن ابن فُضال المجاشعي أنه لا يجيز “ربَ” دون تاء التأنيث، فلا يقول: ربَ رجل، بل لا بد من التاء فيقول: ربت رجل.
لغات رب المكفوفة
أما لغات رب المكفوفة بـ ما فقد ذكر النحويون منها ثمانية أوجه، هي:
- رُبَّمَا بضم الراء وتشديد الباء وهي الأشهر
- رُبَمَا بضم الراء وتخفيف الباء
- رُبَّتَمَا بضم الراء وتشديد الباء وإدخال تاء التأنيث
- رُبَتَمَا بضم الراء وتخفيف الباء وإدخال تاء التأنيث
- رَبَمَا بفتح الراء وتخفيف الباء
- رَبَّمَا بفتح الراء وتشديد الباء
- رَبَتَمَا بفتح الراء وتخفيف الباء وإدخال التاء
- رَبْتَمَا بفتح الراء وإسكان الباء وإدخال التاء
إن تعدد لغات رب يعكس ثراء اللغة العربية وتنوع لهجاتها. كما أن معرفة هذه اللغات تساعد على فهم النصوص القديمة التي قد ترد فيها رب بلغات مختلفة عن المشهور. ومما يجدر ذكره أن اختلاف اللغات لا يؤثر في المعنى ولا في الإعراب، وإنما هو اختلاف في النطق والضبط فقط.
الخاتمة
لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة المفصلة أن رب من الأدوات النحوية المهمة التي لها أحكام خاصة ومعانٍ دقيقة. فقد اختلف النحويون في معناها بين التقليل والتكثير، واختلفوا في طبيعتها بين الحرفية والاسمية، واختلفوا في عامل الجر عند إضمارها. كما أن لها خصائص تركيبية فريدة تتعلق بمجرورها الذي يجب أن يكون نكرة، وبموقعها الإعرابي الذي يُراعى فيه المحل لا اللفظ.
إن فهم أحكام رب يتطلب إدراكاً عميقاً للنظام النحوي العربي وقواعده الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة لغاتها المتعددة وطرق استعمالها في السياقات المختلفة يُثري الحصيلة اللغوية للدارس ويمكنه من فهم النصوص العربية القديمة. وعليه فإن دراسة رب ليست مجرد حفظ لقواعد نحوية جافة، بل هي استكشاف لجوانب من روعة اللغة العربية ودقتها وثرائها.
لقد حاولنا في هذه المقالة أن نجمع شتات المسائل المتعلقة بـ رب، وأن نعرضها عرضاً واضحاً ميسراً يناسب المبتدئين والطلاب وكل من يرغب في الفهم العميق لهذه الأداة. كما حرصنا على إيراد الشواهد الشعرية والنثرية التي تُوضح الأحكام وتُقرب المعاني، فالشاهد خير معين على فهم القاعدة واستيعابها. ومما لا شك فيه أن إتقان استعمال رب يرفع من مستوى التعبير اللغوي ويضفي على الكلام رونقاً وجمالاً.
هل أنت مستعد الآن لتطبيق ما تعلمته عن رب في كتابتك وتعبيرك اللغوي، وهل ستحرص على تتبع استعمالاتها في النصوص التي تقرؤها لتزداد فهماً وإتقاناً؟