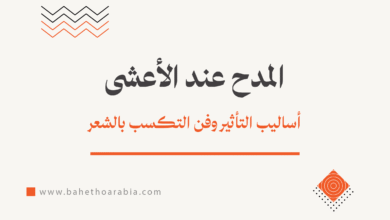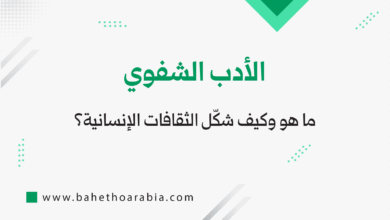الرثاء في الشعر الجاهلي: تعريفه ودوافعه ومعانيه وأنواعه وخصائصه
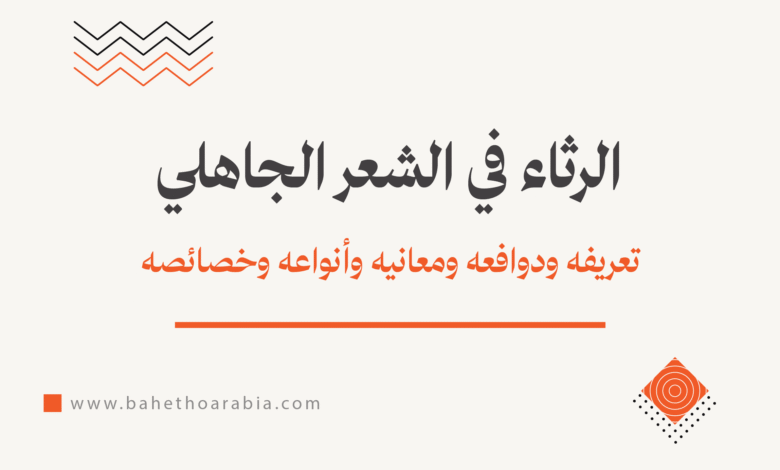
يتناول هذا التحليل الأكاديمي موضوع الرثاء في الشعر الجاهلي، مستعرضاً تعريفه الدقيق، ودوافعه العميقة، ومعانيه المتعددة، بالإضافة إلى نوعيه الرئيسيين، وهما الرثاء الفردي والرثاء القبلي، مع تسليط الضوء على الخصائص الفنية التي شكلت هذا الغرض الشعري الهام. إن فهم الرثاء في الشعر الجاهلي يقتضي الوقوف على أبعاده النفسية والاجتماعية.
تعريف الرثاء
يُعرَّف الرثاء في الشعر الجاهلي في جوهره بأنه فن بكاء الميت ومدحه وتعداد مآثره. وقد ورد في معجم لسان العرب: “رثى فلان فلاناً يرثيه رثياً ومرثية إذا بكاه بعد موته. قال: فإن مدحه بعد موته قيل: رثّاه يرثيه ترثية.. ورثوت الميت أيضاً إذا بكيته، وعددت محاسنه. وكذلك إذا نظمت فيه شعراً”. وجاء كذلك في جوهر الكنز توضيح للمعنى: “تقول: رثي فلان للفلان إذا رقّ له، لأنّ الميت تخشع له القلوب، وترق له النفس، ويقال: رثأت بالهمز”.
من منظور بلاغي، يتوافق الرثاء في الشعر الجاهلي مع غرض المدح في المعاني والمناقب المذكورة، ولكنه يختلف عنه جذرياً في المشاعر المصاحبة. وقد أوضح ابن رشيق القيرواني هذه العلاقة بقوله: “وليس بين الرثاء والمدح فرق. إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أنّه المقصود به ميت، مثل: (كان) أو (عدمنا به كيت وكيت وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت”. وهذا التفريق الدقيق يضع الرثاء في الشعر الجاهلي في خانة مستقلة عاطفياً.
دوافعه ومعانيه
إذا كان الدافع الأساسي للمدح يتمثل في إعجاب قد يمازجه الطمع، فإن الدافع المحرك لفن الرثاء في الشعر الجاهلي هو إكبار يخالطه الوفاء والجزع، أو حب عميق يساوره التفجع والتحسّر. وعليه، فإن دافع الرثاء في الشعر الجاهلي يُعد نبيلاً في منشئه، شريفاً في مقصده، حيث ينبع من حزن الشاعر الصادق على إنسان قطع الموت صلته بعالم الأحياء، فليس إلى نيل الصلة منه سبيل. ويهدف هذا الغرض الشعري إلى إفراغ النفس من لواعج وأحزان لا شفاء لها منها إلا بالبكاء على الراحل وتعداد مناقبه، مما يجعل الرثاء في الشعر الجاهلي وسيلة للتنفيس النفسي.
ولا يمكن استبعاد أن بعض صور الرثاء في الشعر الجاهلي تنبع من إحساس الشاعر بالضعف أمام حتمية الموت، وبالعجز المطلق عن مغالبته، فكأنه حينما يحزن على الفقيد، فإنه في حقيقة الأمر يحزن على نفسه، إذ يشعر على نحو ما أن موت غيره هو نذير بموته. وكلما كان الفقيد أقرب إلى الفاقد، كان إحساسه بالخسارة أشدّ، وتفجعه على الميت أعمق لأمرين اثنين: أولهما أن الفقيد يحمل معه بعضاً من حياة الفاقد، كالذكريات والأواصر والصلات التي جمعتهما معاً. والثاني أن رحيل الراحل يمثل إيذاناً للمقيم بالسفر القريب. وقد عبر عن ذلك أكثم بن صيفي بقوله: “وقد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفروع بعد أصولها”. وقال قس بن ساعدة الإيادي في ذات المعنى:
لمّا رأيت موارداً *** للموت ليس لها مصادر
أيقنت أنّي لا محا *** لة حيث صار القوم صائر
ويظهر من خلال استقراء نماذج الرثاء في الشعر الجاهلي أن نفوس العرب لم تكن شديدة الانكسار أمام الموت، لأن طبيعة الحياة الصحراوية القاسية فرضت على القوم التجلد في النكبات، ومجابهة الحزن بالعزم، وتحويل فاجعة القتل – التي تمثل موضوع أكثر مراثي الجاهليين – إلى تصميم على الانتقام ومفاخرة بالمآثر. وهذا يعكس صلابة الشخصية العربية التي يصورها الرثاء في الشعر الجاهلي.
وحسبك أن تمر بأيام العرب وما واكب هذه الأيام من مراثٍ لتقف على صلابة العرب في هذه المواقف التي يخشع لها الناس. وفي هذا السياق، يشير الدكتور عفيف عبد الرحمن إلى أن: “شعر الرثاء في مجموعة شعر الأيام هو صورة من الفخر والحماسة في تلك الحروب، ولا نجد في رثائهم من التفجع والتوجع للقتيل إلا ما جاء على ألسنة النوائح أو نسوة القتيل وأهله، كزوجه أو أمه أو شقيقته. وحتى أولئك النسوة كن يتجلدن ولا يظهرن الجزع والحزن، لأنّ القتيل مات في ساحة الشرف دفاعاً عن قبيلته وعن عرضه وحماه”. ولعل ارتباط هلاك القوم بالمنازعات القبلية يجعل الشاعر لا يقنع بالتعبير عن حزنه وأساه، بل يضيف إلى ذلك التعبير عن شدة سخطه وبالغ حقده على أعداء قومه الذين كانوا سبب هلاكه. ونرى الشاعر لا يلبث أن يخلع رداء الحزن، ويثوب إليه تجلده، وتضطرم في نفسه الأحقاد، وهذا جانب مهم في فهم الرثاء في الشعر الجاهلي.
تتمثل أشيع المعاني في الرثاء في الشعر الجاهلي في أن يصوّر الشاعر الفجيعة، وأن يحلل تأثيرها في نفسه وفي نفوس الناس الذين تربطهم بالفقيد رابطة من صداقة أو نسب. وأن يعدد مناقبه كالشجاعة والكرم والنجدة والشرف، وأن يدعو له بالسقيا بعد الموت، كما كان يدعو له بها في الحياة. فإذا دعا له أحس بأنه ردّ إليه بعض الحياة التي فارقته. وربما وصف الشاعر حزنه، وربما أعرض عنه، لأن الدموع لا تليق بالرجال. فإن كان الفقيد قتيلاً، مضى الشاعر يهدّد قتلته، ويحرّض على إدراك الثأر. وإن كان قد لقي الموت حتف أنفه، تجلد وتصبر، والتمس السلوان ومضى يقيس مصابه بمصاب الآخرين. ويأخذ العبرة من مصارع الملوك والجبابرة، ومن هلاك الضواري والكواسر. وقد أشار ابن رشيق إلى هذه السمة في الرثاء في الشعر الجاهلي بقوله: “ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأمم السالفة، والوعول الممتنعة في قلل الجبال والأسود الخادرة في الغياض وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار، والنسور والعقبان والحيات للباسها وطول أعمارها. وذلك في أشعارهم كثير موجود، لا يكاد يخلو منه شعر”.
أنواع الرثاء
إن الدوافع والمعاني التي ذكرناها آنفاً لا تسود الرثاء في الشعر الجاهلي كله على نحو واحد من السيادة، أو بدرجات متساوية من التوتر، لأن ارتباط الرائي بالمرثي يحدد درجة التوتر العاطفي، ولأن طبيعة الفقيد تحدد المعاني اللائقة برثائه. فقد يكون المرثي قريب الرائي أو صديقه الحميم، فيغدو الرثاء في الشعر الجاهلي في هذه الحالة عاطفياً شديد التوتر. وقد يكون سيداً أو أميراً، فيغلب على الرثاء الإكبار وتفتر عواطف الحزن، وتبرز المبالغة لتهويل شأن الميت. وبناءً على ذلك، يمكن تقسيم الرثاء في الشعر الجاهلي إلى نوعين رئيسيين: رثاء فردي ورثاء قبلي.
١) الرثاء الفردي
يُعد الرثاء الفردي أصدق نوعي الرثاء في الشعر الجاهلي، وأعلقهما بالنفس، وأقربهما إلى الفطرة والطبع. وفي هذا النوع تحديداً، تبرُّ النساء الرجال لا بجودة النظم وعمق المعنى، بل بصدق الإحساس وتصوير الفجيعة. قال ابن رشيق في هذا الصدد: “والنساء أشجى الناس قلوباً عند المصيبة، وأشدهم جزعاً على هالك، لما ركب الله عزّ وجلّ في طبعهن من الخور وضعف العزيمة”. وحسبك دليلاً على ما قال ابن رشيق شهرة الخنساء في العصر الجاهلي – على كثرة شعراء الرثاء – بمراثيها في أخويها صخر ومعاوية، فإنّها لم تكن لتفوق الرجال لولا هذا الطبع الانفعالي الذي يميز المرأة من الرجل ويجعلها أقدر منه على التأثر والتأثير، وهذا ما جعلها علامة فارقة في تاريخ الرثاء في الشعر الجاهلي.
ولمراثي النساء أشكال عدة، فقد ترثي الأم ولدها، وتندب الأخت أخاها، وتبكي البنت أباها. وفي أيام العرب مادة عظيمة لمثل هذا الرثاء في الشعر الجاهلي، شغلت نساء العرب، وملأت قلوبهن بأحداثها الجسام، ومآسيها المروّعة. ومن الأمثلة الكثيرة التي حفلت بها أيام العرب، رثاء دخنتوس لأبيها لقيط بن زرارة، سيد بني تميم. وكان قد عزم على غزو بني عامر للأخذ بثأر أخيه معبد. وبينما يتجهز، أتاه الخبر بحلف بني عبس وعامر، وكان لقيط وجيهاً عند الملوك، فخالف النعمان بن المنذر ملك الحيرة، والجون الكلبي ملك هجرة. ومع ذلك كان الموت قدره المحتوم، فصرعه بنو عبس. ورثته ابنته دخنتوس بثلاث قصائد، بكته في بعضها ودعت على قبيلة عبس بمصاب كمصابها. وأقسى ما آلمها في مقتل أبيها هو الغدر والغيلة لا المجاهرة بالعداوة؛ فأبوها لقيط فارس متمرس بالسلاح، لا يُنال إلا بالكيد والحيلة. ولذلك تفجعت لاغتياله، ومزقتها الحسرات حينما تصورت محياه الوسيم معفّراً بالثرى، دفيناً تحت الصخور الصلاب، فقالت:
ألا يالها الويلات ويلة من بكى *** لضرب بني عبس لقيطاً وقد مضى
لقد ضربوا وجهاً عليه مهابة *** ولا تحفل الصم الجنادل من ثوى
فلو أنكم كنتم غداة لقيتم *** لقيطاً ضربتم بالأسنة والقنا
وسلكت في بعض مراثيها مسلك الفخر، فجعلت أباها أفضل العرب كهولاً وشباباً، وأشرفهم حسباً ونسباً، ونوهت بمنزلته عند الملوك، فقالت:
بكَر النّعيُ بخير خنـ *** دف كهلها وشبابها
وبخبرها نسباً إذا *** عُدّت إلى أنسابها
وريثها عند الملو *** ك وزين يوم خطابها
ورثاؤها في القصيدتين كلتيهما لا يبلغ مبلغ رثاء النساء المعتاد في البكاء. وعلة ذلك أن الفقيد عظيم من عظماء العرب، فالتنويه بفضله كان خيراً من البكاء على فقده. إن رجولة طغت على أنوثة الرائية، فأضعفت الحزن أو كادت تلغيه. لكن الرثاء في الشعر الجاهلي الذي نظمته النساء في الأعم الأغلب كان غزير الدموع حارّ التفجع. ومن أصدقه ما قالته عزة بنت مكدم في رثاء أخيها ربيعة حامي الظعائن، وفي مقتل هذا الفتى الشهم قصة تروى.
خرج نبيشة بن حبيب السلمي غازياً، فلقي ظعناً من بني كنانة بالكديد في خفارة ربيعة بن مكدم. فحمل بعض السلميين على ربيعة فقتله ربيعة، وأصابه منه جرح، فذهب إلى أمه، فشدت على جرحه عصابة ثم رجع إلى الظعائن. فلما ألح عليه النزف وأدرك أنه هالك، قال للظعائن: “سوف أقف دونكن لهم على العقبة، فأعتمد على رمحي فلا يقدمون عليكن لمكاني”. فمضت النسوة إلى قومهن يطلبن المأمن وربيعة دونهن يتقاوى متكئاً على رمح يصارع النزف. ورآه نبيشة بن حبيب فقال: “إنه لمائل العنق، وما أظنه إلا قد مات”. وصدق نبيشة، فقد مات ربيعة وأعداؤه منه خائفون، وحمى الظعائن حياً وميتاً. فبكته أخته عزّة بكاء صادقاً، وودت لو تستطيع ببكائها أن ترد إليه الحياة، وهيهات. وحينما ثاب إليها عقلها وأدركت أن حقيقة الموت لا تُجحد، استسلمت للقدر المقدور وعاهدت أخاها على الإخلاص له والبكاء عليه ما عاشت:
على هالك أودى، فأورتني أبكي *** بعد التّفرّق حزناً حرّه باق
لو كان يُرجعُ ميتاً وجد ذي رحم *** أبقى أخي سالماً وجدي وإشفاقي
فأذهب فلا يبعدنك الله من رجل *** لاقى الذي كل حي مثله لاقي
فسوف أبكيك ما ناحت مطوقةً *** وما سريت مع الساري على ساق
أبكي لذكرته عَبْرى مُفجعةٌ *** ما إنْ يجفُّ لها من ذكرة ماقي
وإذا كانت الخنساء قد فاقت غيرها من شواعر العرب في البكاء على صخر في الجاهلية، فإنّ الإسلام ذهب بحزنها وأبدلها منه أمناً وسكينة. أما الشواعر الجاهليات فقد أقمن على التفجع، فجاء شعرهن حارّ العواطف، مشتعل المواجد. وزادته الحروب القبلية اضطراماً، إذ أوقدت فيه نيران الحقد والثأر، فاجتاحته حرائق يصعب إخمادها، وهو ما يعكس الطبيعة القاسية التي أنتجت الرثاء في الشعر الجاهلي.
وأعنف هذه الحرائق تلك التي لا يستطاع إخمادها لأن الواتر والموتور شخص واحد، أو يوشكان أن يكوناه. وربما كانت جليلة بنت مرة هذا الشخص الذي تمثلت فيه هذه الحالة من التناقض المروّع، والتمزّق العنيف بين الثأر والعفو، والحزن والغضب. فقد قتل أخوها جسّاس زوجها كليباً، فأيمت ووورثت ثأراً لا يمكن دركه، فلم تجد غير البكاء مسلاة، وراحت اللائمات يلمنها، فلا يزيدها اللوم إلا إمعاناً في البكاء. لقد قصم المصاب ظهرها ودمر حياتها، وقوّض أركانها، وأدناها من الموت، فكيف تسلو، وعجزها عن السلوان كعجزها عن الثأر؟
يا بنةَ الأقوامِ إنْ لُمتِ فلا *** تعجلي باللّوم حتّى تسالي
إن تكن أختُ امرئ ليْمَتْ على *** جزعٍ منها عليه، فافعلي
فعل جسّاسٍ على ضنّي به *** قاطعٌ ظهري، ومُدنٍ أجلي
يا قتيلاً قوّض الدّهرُ به *** سقفَ بيتي جميعاً من علِ
ولك أن تتصور هذه المرأة الممزقة بين الحزن والغضب، تتقلب على جمر يكنفها من كل جانب. وأقلّ هذه النار ضراوة حزنها على زوجها، وأكثرها ضراوة تلك التي تعتمل في قلبها ولا تشتعل. إن تفكيرها في الثأر من أخيها ليشعل حاضرها ومستقبلها، فيروعها تصوّرُ ما تفكر فيه، فتقلع وتحس أن إطفاءها نار كليب بدم جساس سيضاعف حزنها، فتغدو أيّماً ثكلى، وتغدو الفجيعة فجيعتين:
مسني فقد كليب بلظیً *** من ورائي ولظىً مُسْتَقبِلي
يشتفي المدْركُ بالنّار وفي *** دركي ثأريَ نُكْلُ المنْكِلِ
وتود لو أنها كانت هي القتيل، وأن عروقها تتقطع فتنزف دمها لتستريح من هذا الصراع الضاري:
ليتهُ كانَ دمي، فاحتلبُوا *** دِرراً منه دمي من أكحلي
إنني قاتلةٌ مقتولةٌ *** ولعل الله أن يرتاح لي
أما رثاء الرجال للرجال ضمن منظومة الرثاء في الشعر الجاهلي، فقد كان زاهداً في البكاء، حريصاً على الإشادة بالمآثر، صادقاً في مزجه الحزن بالفخر. لأن الشاعر الجاهلي كان واقعياً في الرثاء كما كان واقعياً في المدح، فهو لم يكن يختلق فضائل لم تؤثر عن الفقيد، ولم يكن يخلع على الصعلوك جلال الملوك، بل كان يصف الميت بما فيه، ولا يعنيه بعد ذلك أن تكون الخلال التي يذكرها حميدة عند قوم وذميمة عند آخرين.
كان الشنفرى صعلوكاً، أي صعلوك، فيه الطيب والخبيث، والخير والشر، وكان كثير المعروف قليل الأذى، مصون الشرف، أوتي العزيمة القادرة على قهر الأزمات وتذليل الصعاب بقوسه الشديدة وسيفه الرهيف. وكان – على نفوره من الناس – براً بأصحابه، يرصد لهم وهو رابض في مربضه على قمة الجبل منافذ الشعاب، ويذلل لهم سبل الغزو والأخذ بالثأر. وهذه الخصال جعلته رائداً من روادهم، وجعلت رحيله عن الدنيا خطباً لا يدرك فداحته إلا صعلوك مثله، كتأبط شرّاً الذي بكاه، ونوه بشجاعته وسرعته وصبره واحتماله الشدائد، فقال:
قضى نحبه مستكثراً من جميله *** مقلاً من الفحشاء والعِرضُ وافر
يفرج عنه قمة الروع هزمه *** وصفراءُ مِرْتانَ وأبيضُ باترُ
ومرقبةٌ شماء أقعيتَ فوقها *** ليغنم غازٍ ليدرك ثائر
فلا يبْعَدَنَّ الشّنفرى وسلاحُه *** حديد، وشد خطوه متواتر
إذا راع روعُ الموتِ راعَ، وإن حمى *** حمى في معه حرّ كريم مصابر
وهذه الواقعية تظهر في الرثاء في الشعر الجاهلي عند رثاء الملوك ظهورها في رثاء الصعاليك، لأنها سمة من سمات الشعر الجاهلي كله. فحينما رثى امرؤ القيس أباه لم يكن ليبكيه أو يستبكي الناس عليه، لأن مكانته تجله عن الدموع، بل فاخر به وبمكانته، وكذب الخبر الذي بلغه عن مقتله، إذ لم يدر في خلده قط أن يجرؤ بنو أسد على قتل سيدهم حجر. وحينما تبين وجه الحق، ثقل عليه الرزء وراح يباهي بموضع أبيه من الملك، ويصور القبائل العربية من ربيعة وتميم وأتباعهما خدماً له وموالي تسعى إلى مرضاته، وتلتقط من فتاته:
أرقت ببرق بليل أهلّ *** يضيء سناه بأعلى الجبلْ
أتاني حديث، فكذّبته *** بأمر تزعزع منه القُللْ
بقتل بني أُسد ربهم *** ألا كلّ شيء سواء جلل
فاين ربيعة عن ربّها *** وأين تميم وأين الخول
ألا يحضرون لدى بابه *** كما يحضرون إذا ما أكل
على أن الرثاء في الشعر الجاهلي لم يبرأ من الغلو والشطط، ولم ينج – على واقعيته – من المبالغات التي فشت فشيتها في شعر المتأخرين. لكنّها في الشعر الجاهلي أتت تعبيراً عن الدهشة التي تصحب موت العظيم، وفي الشعر المتأخر أتت عوضاً عن الصدق في الإحساس. وهذه المبالغات لا تشغل من القصيدة الجاهلية غير بيت أو بيتين، يخرج فيهما الشاعر عن المألوف، فمتى أحس أنه جاوز الحد ارتد، والتزم الواقعية المألوفة في الرثاء في الشعر الجاهلي.
وأوضح دليل على ما نذهب إليه قصيدة رثى فيها أوس بن حجر صديقاً قريباً إلى قلبه وسيداً من سادة بني أسد، وشاعراً من شعرائها، هو فضالة بن كلدة. فطلب من الشمس أن تنكسف ومن القمر أن ينخسف ومن النجوم أن تنطفئ حزناً على فضالة. ثم أدرك أن مطلبه مستحيل، فتحسّر على الفضائل التي انطوت بانطوائه، كإقالة العاثر، وجبر المكسور، والشجاعة في الملمات:
الم تُكسفِ الشّمس والبدرُ والـ *** كواكب للجبل الواجبِ
لفقد فَضَالة لا تستوي الـ *** فقود ولا خَلَّهُ الذاهبِ
ألهفاً على حسن أخلاقه *** على الجابر العظم والحـاربِ
وربما كان الشعراء الذين ربطتهم بالأمراء صلات المعايشة أميل إلى هذا النمط من الرثاء في الشعر الجاهلي، فهم لحرصهم على التعظيم تعوّدوا المبالغة في المدح، ثم نقلوا المبالغة من إطار المدح إلى إطار الرثاء، ومن رثاء الأمراء إلى رثاء الأصدقاء وذوي القربى. رثى النابغة الذبياني حصن بن حذيفة بن بدر، فبالغ، وغلا في تصوير المصاب. وأول غلوه تكذيب الناعي، وآخر غلوّه تهويل الفاجعة، وأول الأمر مفضٍ إلى آخره، إذ لو صح خبر الموت لتداعت الجبال وأخرجت القبور موتاها من أجوافها، وبارحت النجوم أفلاكها، وتفطّرت السماء، وتشققت الأرض. وحينما دفعت الحقيقة الظن، وقمع اليقين التردّد، بكى النابغة وبكى معه أهل الحي:
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم *** وكيف بحصن والجبال جنوحُ
ولم تلفظ المـوتــى الـقـبــورُ ولم تزل *** نجوم السماء والأديم صحيحُ
فعمّا قليل، ثم جاء نعيّه *** فظلّ نديّ الحيّ، وهو ينوحُ
والشكل الأخير من أشكال الرثاء الفردي في الرثاء في الشعر الجاهلي هو أن يبكي الإنسان نفسه قبل أن يبكيه الناس. وهذا البكاء نوع من التعلق بالحياة، أو التعلق بما بقي للشاعر فيها. وهو لذلك يدعو أصدقاءه، ويستعينهم على البلاء النازل، ويوصيهم بالحزن عليه إذا مات، وبالاستسقاء لقبره بعد الموت. كأن في هذا الاستسقاء ضرباً من ضروب الحرص على البقاء. إنه باختصار تعبير عن الرغبة في الخلود والخوف من الفناء. ولذلك يحاول الشاعر أن يهرب من تصوّر الفناء، وأن يرتد إلى الطفولة زمن الحياة النضرة، وإلى الشباب الريان زمن الشهوات والنزوات. قال المتلمس:
خليلي إما مت يوماً وزحزحت *** منايا كما فيما يزحزحه الدّهرُ
فمرّا على قبري، فقوما فسلّما *** وقولا سقاك الغيثُ والقطرُ يا قبرُ
كأنّ الذي غيّبْتَ لم يلهُ ساعةٌ *** من الدّهر، والدنيا لها ورقُ نضرُ
وسيبلغ هذا النمط من رثاء الشاعر نفسه قمة النضج في العصر الأموي، حينما يرثي مالك بن الريب نفسه (ت ٦٠ هـ) باليائية المشهورة.
٢) الرثاء القبلي
إن ارتباط الشاعر بقبيلته حمله تبعات كثيرة، كان ينهض بها مختاراً في السلم والحرب. فهو في السّلم لسانها الناطق بالمفاخر، وفي الحرب شعلتها التي تضرم الغضب في النفوس، وبعد الحرب نادبها الباكي على القتلى. ولما كانت حياة العرب في الجاهلية حروباً موصولة بحروب، فقد كثر في شعرهم الرثاء، واتخذ بعضه طابع الرثاء القبلي العام، وهو ما يعرف بـالرثاء في الشعر الجاهلي ذي البعد الجماعي. وبرز فيه الشعراء بروز القادة، يقودون الأبطال إلى سوح المعارك بالحماسة، ثم يودعونهم إذا قتلوا بالتأبين.
ولذلك، شاع في هذا النوع من الرثاء في الشعر الجاهلي البكاء على أبطال القبيلة والقبول بالقدر المقدور، لأن القبائل العربية كلها أو جلّها تلتقي في ملتقى واحد هو النزوع الدائم إلى القتال، والرحيل عن المنازل إلى المقابر في موكب لا ينقطع. قال عبيد بن الأبرص يرثي الذاهبين من قومه:
لمن طلل لم تعف منه المذانبُ *** فجنبا حِبِرّ قد تعفّی فراهبُ
ديار بني سعد بن ثعلبة الأُلى *** أذاعَ بهم دهرٌ على الناس رائبُ
فأذهبهم ما أذهب النّاسَ قبلهم *** ضِراسُ الحروب والمنايا العواقبُ
وقد يشتد الحزن في هذا الرثاء القبلي، لكن الشاعر – على حزنه – يظل نزاعاً إلى المفاخرة بالقبيلة، يؤثر الإدلال بالمفاخر على الإعوال والجزع، وهذا ما يميز الرثاء في الشعر الجاهلي. لقد حزنت أميمة بنت عبد شمس على مَنْ قُتل مِنْ قومها في يوم الحريرة، لكنها قمعت الحزن بالتجلد، وانتقلت من النواح إلى إقناع السامع بأن القتلى جديرون منها بالدموع الغزيرة، فهم ركنها الذي تداعى، وشرفها الذي تعتز به، وقلعتها التي تحتمي بها:
الا يا عين فأبكيهم *** بدمعٍ منك مستغربْ
فإن أبكِ فهم عزّي *** وهم ركني وهم منكبْ
وهم أصلي وهم فرعي *** وهم نسبي إذا أنسبْ
وهم مجدي وهم شرفي *** وهم حصني إذا أرهبْ
وكيف لا تفاخر الشاعرة بقومها وفيهم جماع الفضائل كالصدق والبلاغة والبطولة:
فكم من قائل منهم *** إذا ما قال لم يكذب
وكم من ناطق فيهم *** خطيب مصقع معرب
وكم من فارس فيهم *** كميّ مُعلّم مِحْرَب
ومهما تكن نفوس العرب متسعرة بنار الغضب قبل الحرب، فإن الموت الذي يتخطف أرواح القتلى يكسر شرة الأحياء، ويقفهم أمام حقيقة تطمسها الحماسة أحياناً، وتبقى ماثلة كلّ حين، وهي حقيقة الموت أو حقيقة الرعونة في الحروب القبلية. والمنصف من الشعراء من أوتي الجراءة على رثاء الفريقين، والمساواة بين الخصمين. وربما كان المفضل النكري أصدق الشعراء في هذا النمط من الرثاء في الشعر الجاهلي.
لقد نظر المفضل إلى ميدان القتال بعد انطفاء جذوة الحرب، فإذا الحصاد الذي تمخضت عنه المعركة الرعناء أصابع مقطعة، ورؤوس مكسرة، وحلوق تحشرج فيها الأنفاس، وأجساد ممزقة تأكلها الضواري. والرابح من الفريقين خاسر اليوم أو غداً، فقال:
بكل قرارة منا ومنهم *** بنان فتى وجمجمة فليقُ
وكم من سيد منا ومنهم *** بذي الطرفاء منطقه شهيقُ
فأشبعنا السباع وأشبعوها *** فراحت كلها تئقٌ يفوقُ
ثم صرف الشاعر نظره عن المشهد المرعب إلى خيام النساء، فلم يلق إلا الباكيات المعولات، وأصغى إلى النواح فإذا الأصوات تتجاوب، وإذا البكاء واحد لا نسب له، وإذا حناجر الفريقين بحاء تخنقها الغصص:
فأبكينا نساءَهُم وأبكوا *** نساء ما يسوغُ لهنّ ريقُ
يجاوبن النِّياح بكلِّ فخر *** فقد صحلت من النّوح الحلوقُ
وفي هذا النمط المتقدم من الرثاء في الشعر الجاهلي، يفارق الشاعر أفقه القبلي الضيق، ويرقى إلى أفق إنساني كريم، تذوب فيه العصبية، وتزول الفوارق، وتنتصر الروح النبيلة العامة على الأثرة المغلقة. فإذا الأشلاء المبعثرة في الميدان عامل من عوامل توحيد العرب، وإذا العقلاء من القبائل المختلفة ينظرون إلى الحرب بعيون العقول المنصفة، لا بالعيون التي عصبتها العصبية، فلا يجدون فيها إلا الدمار والخزي، فيرثون العدو كما يرثون الصديق. وهم في حقيقة الأمر لا يرثون للبكاء على الموتى، بل للإبقاء على الحياة في جسوم الأحياء، ونفخ الروح القومية في مفهوم الأمة الذي طغى عليه الحمق حتى كاد يغرقه. إن هذا التسامي هو من أرقى صور الرثاء في الشعر الجاهلي.
خصائص الرثاء الفنية
لما كان الرثاء في الشعر الجاهلي شكلاً من أشكال المدح، فإن خصائصه الفنية تماثل خصائص المدح إلى حد كبير، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
١) امتزاجه بالأغراض الأخرى: من أبرز خصائص الرثاء في الشعر الجاهلي امتزاجه بالأغراض الشعرية الأخرى كالحماسة والفخر ووصف الحرب في أكثر الأحيان. وإفراده بقصائد ومقطعات في أحيان قليلة كمراثي النساء لإخوتهن وآبائهن وأبنائهن.
٢) مجانية الغرابة اللفظية: تتجلى في الرثاء في الشعر الجاهلي ظاهرة مجانية الغرابة اللفظية. وتعليل هذه الظاهرة يسير، وهو أنّ الشاعر المحزون يقربه الحزن من الفطرة ويقصيه عن الصنعة، فيستخدم من الألفاظ أشيعها، وأعلقها بالذاكرة، وأسيرها على الألسن.
٣) التعلق بالحياة: من يستعرض الرثاء في الشعر الجاهلي يجد فيه الخوف من الموت واضحاً وضوح الحرص على الحياة، ولا يجد إيماناً قوياً بحياة أخرى، أو تصوراً واضحاً لبعث وحساب. ولذلك طغت في هذا الشعر النزعة المادية على النزعة الروحية، وقويت هذه النزعة عند الشعراء المقبلين على اللذات كالخمر والنساء والصيد، ومنهم طرفة وامرؤ القيس والأعشى.
٤) غياب المقدمة الطللية والغزلية: إن للموت لهيبة، وهذه الهيبة تقصيه عن الغزل وعن التفكير في الجمال. غير أن قصائد قليلة شذت، وخالفت القاعدة المطردة في الرثاء في الشعر الجاهلي، وتضمنت مقدمات طللية أو غزلية، منها قصيدة دريد بن الصمة في رثاء أخيه عبد الله، وقصيدة لبيد في تأبين أخيه، ورثاء المرقش في البكاء على ابن عمه وهي الميمية التي مطلعها:
هل بالديار أن تجيب صَمَمْ *** لو كان رسم ناطقاً كلّمْ
الدار قفر والرسوم كما *** رقّشَ في ظهر الأديم قلم
٥) الواقعية والزهد في المبالغة: وقد أشرنا إلى هذه الظاهرة التي تعد من سمات الرثاء في الشعر الجاهلي، وربطناها بالصدق والصراحة اللذين جُبل عليهما الخلق العربي، وبطبيعة الخيال الحسي عند العرب.
٦) ندرة رثاء النساء: وتعود هذه الظاهرة في الرثاء في الشعر الجاهلي إلى حرص الشاعر على الظهور بمظهر التجلّد، وإلى طبيعة الحياة التي تربط الضعف بالمرأة، والقوة بالرجل. ولما كان المجتمع الجاهلي يقدر القوة ويمقت الضعف، فقد قلّ رثاء الرجال للنساء. ومن هذا القليل ما رثى به عمرو بن قيس المرادي زوجه سعدى، إذ بكاها واستبكى عليها النساء، فقال:
سُعيد قومي على سعدى، فبكّيها *** فلست محصـيـة كل الذي فيها
في مأتم كظباء الرّوض قد قرحت *** من البكاء على سعدى مآقيها
٧) إشراك الطبيعة في الحزن: إن السبب المعقول لهذه الظاهرة في الرثاء في الشعر الجاهلي هو أن الشاعر الجاهلي كان شديد الاتصال بالطبيعة، يحسّها في كل جانب من جوانب حياته. وأن لهذا الاتصال امتداداً يجاوز الحياة إلى ما بعدها، ويتمثل في دورة الحياة الملموسة؛ فالناس يأكلون من الأرض ثم تأكلهم الأرض، فينتزع باطن الأرض البشر من ظاهرها، كما تنزع الضواري بغاث الطير من أوكارها، فلا غرو أن تحزن الأفلاك والجبال على الذين فارقوها. وإذا كنا نستغرب في العصر الحاضر هذا الإشراك، فلأن الحياة الحديثة قطعت ما بين الإنسان والطبيعة من وشائج، وغلبت الصناعة على الطبيعة، والآلة على الفطرة، ففتر حس الناس بما حولهم وبهت. إن الرثاء في الشعر الجاهلي يعكس هذه العلاقة العميقة. وهكذا يكتمل فهمنا لغرض الرثاء في الشعر الجاهلي.
الأسئلة الشائعة
١- كيف يُعرَّف الرثاء أكاديمياً في سياق الشعر الجاهلي؟
الإجابة: يُعرَّف الرثاء أكاديمياً بأنه غرض شعري يتمحور حول بكاء الميت وتعداد محاسنه ومآثره. وهو يتوافق مع المدح في ذكر الصفات الحميدة، لكنه يختلف عنه جوهرياً في المشاعر الحزينة المصاحبة له، وغالباً ما يتم تمييزه لغوياً باستخدام ألفاظ تدل على الموت والفقدان مثل “كان” أو “عدمنا”.
٢- ما هو الفرق الجوهري بين الرثاء والمدح في الشعر الجاهلي؟
الإجابة: الفرق الجوهري يكمن في الدافع والسياق؛ فالمدح ينبع من الإعجاب وقد يختلط بالطمع، ويكون موجهاً لشخص حي. أما الرثاء، فينبثق من حزن الفقد والوفاء، وهو موجه لميت انقطعت صلته بالحياة، مما يجعله تعبيراً عاطفياً أكثر صدقاً ونبلاً.
٣- ما هما النوعان الرئيسيان للرثاء في الشعر الجاهلي، وما أبرز ما يميز كلاً منهما؟
الإجابة: النوعان هما: الرثاء الفردي الذي يتميز بصدق العاطفة وقوة التعبير عن الفجيعة الشخصية، وتبرز فيه النساء غالباً لعمق إحساسهن. والرثاء القبلي الذي يتخذ طابعاً جماعياً، يمتزج فيه الحزن بالفخر بأبطال القبيلة، وقد يتضمن التحريض على الثأر.
٤- لماذا تميزت النساء، كالخنساء، في الرثاء الفردي على الرغم من قلة الشواعر عموماً؟
الإجابة: تميزت النساء لسبب فطري، كما أشار ابن رشيق، وهو أنهن “أشجى الناس قلوباً عند المصيبة”، مما منحهن قدرة فائقة على التعبير الصادق عن لوعة الفقد. فطبيعة المرأة الانفعالية جعلت رثاءها أكثر تأثيراً وعمقاً من رثاء الرجال الذين غلب عليهم التجلد.
٥- كيف تفاعل الحزن مع دعوات الثأر في مراثي القتلى ضمن الشعر الجاهلي؟
الإجابة: في مراثي القتلى، لم يكن الحزن مجرد بكاء، بل كان وقوداً يضرم نار الغضب والحقد. كان الشاعر يحوّل الفاجعة الشخصية إلى قضية قبلية، فيمتزج رثاؤه بتهديد القتلة والتحريض على الأخذ بالثأر، مما يجعل القصيدة أداة للتعبئة والحماسة بجانب كونها تعبيراً عن الأسى.
٦- ما المقصود بخاصية “الواقعية” في الرثاء الجاهلي؟
الإجابة: المقصود بالواقعية هو أن الشاعر الجاهلي كان يصف الميت بصفاته الحقيقية دون اختلاق فضائل وهمية. هذه السمة تظهر بوضوح في رثاء الصعلوك الشنفرى بخصاله الواقعية، كما تظهر في رثاء الملوك، حيث كان الصدق في الوصف سمة أساسية نابعة من طبيعة الحياة العربية الصريحة.
٧- كيف وظف الشاعر الجاهلي عناصر الطبيعة في قصائد الرثاء؟
الإجابة: وظف الشاعر الطبيعة كشريك في الحزن، بسبب اتصاله الوثيق بها. فكان يخاطب الشمس والقمر والنجوم ويدعوها للانكساف حزناً على الفقيد، مما يعكس عمق الفاجعة ويضفي عليها بعداً كونياً، ويظهر مدى تغلغل البيئة الطبيعية في وجدانه.
٨- لماذا يُعد رثاء الرجال للنساء ظاهرة نادرة في الشعر الجاهلي؟
الإجابة: يعود ذلك إلى طبيعة المجتمع الجاهلي الذي يقدّر القوة والتجلد في الرجل ويمقت إظهار الضعف. وبما أن البكاء الشديد كان يُربط بالنساء، فقد حرص الشاعر على الظهور بمظهر الصابر المتماسك، مما قلل من قصائد الرثاء الموجهة للنساء بشكل مباشر.
٩- هل اقتصر الرثاء في الشعر الجاهلي على بكاء الآخرين فقط؟
الإجابة: لا، بل ظهر شكل فريد وهو “رثاء النفس”، حيث يبكي الشاعر نفسه قبل موته. وهو لا يعبر عن يأس بقدر ما يعبر عن تعلق شديد بالحياة، ورغبة في الخلود الذكري، ووصية للأصدقاء بأن يتذكروه ويدعوا لقبره بالسقيا بعد رحيله.
١٠- كيف تطور الرثاء القبلي ليتجاوز العصبية ويصل إلى أفق إنساني؟
الإجابة: في بعض النماذج الناضجة، ارتقى الشاعر فوق النزعة القبلية الضيقة، خاصة بعد رؤية بشاعة الحرب. فكان يرثي قتلى قبيلته وقتلى أعدائه معاً، مدركاً أن الموت هو المصير المشترك وأن الخسارة إنسانية. وفي هذا، تحول الرثاء من أداة للثأر إلى دعوة للتأمل في عبثية القتال.