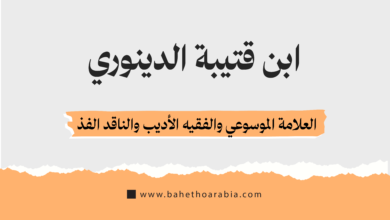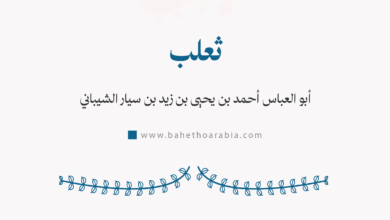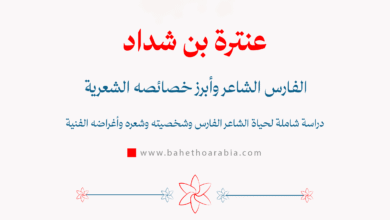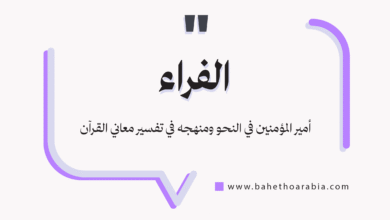الحارث بن حِلِّزة اليشكري: سيرة الشاعر ومكانته في العصر الجاهلي
دليل شامل لفهم حياة صاحب المعلقة ومساهمته في الشعر العربي القديم

يُعد الحارث بن حِلِّزة اليشكري أحد أعمدة الشعر في العصر الجاهلي، وصاحب إحدى المعلقات السبع التي خلدها التاريخ. تتناول هذه المقالة مسيرته الأدبية وأبرز خصائص شعره وقيمة معلقته الخالدة.
حياة الحارث بن حِلِّزة اليشكري
الحارث بن حلزة هو واحد من ثلاثة شعراء عُرف كل منهم بابن حلزة، وهم: الحارث وعمرو وعباد، وأشهر الثلاثة هو شاعرنا الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري البكري الذي سلكه صاحب الطبقات مع خصمه عمرو بن كلثوم في شعراء الطبقة السادسة. وللشاعر كنيتان هما: أبو عبيدة، وأبو الظليم، وله أخ شاعر، ذكره المرزباني، اسمه عمر ورثى أخاه الحارث بأبيات، ولم ينبه من عقب الشاعر بنيه وحفدته غير واحد، هو حفيده شهاب بن مذعور بن الحارث العالم بالأنساب.
إن أهم ما في حياة الحارث بن حِلِّزة اليشكري تلك المباراة الشهيرة بينه وبين عمرو بن كلثوم التي عنيت كتب الأدب بذكرها، وخلاصة خبرها أن عمرو بن هند حسم حرب البسوس بين تغلب وبكر بالصلح، وطلب من تغلب شاعراً ينافح عنها، فاختارت عمرو بن كلثوم، ومن بكر شاعراً، فاختارت الحارث بن حلزة، وكلا الشاعرين سيد شريف في قومه. وقد أنشد عمرو بن كلثوم معلقته، ففخر وأسرف وتعجرف، وتجاوز ما تفخر به العرب في مجالس الملوك، ولم يرع حرمة عمرو بن هند، وهنا نهض الحارث لينشد.
معلقة الحارث بن حِلِّزة اليشكري
في نظم القصيدة روايتان: توحي الأولى بأن الحارث ارتجلها ارتجالاً، فقد روي عن ابن السكيت أنه قال: “كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجال الحارث هذه القصيدة في موقف واحد، ويقول: لو قالها في حوّل لم يلم”. وتدل الثانية – وهي الصحيحة في زعمنا – على أنه نظمها قبل سفره إلى الحيرة، ورواها جماعة من قومه لينشدوها عنه بسبب البرص فيه، الذي كان يمنعه أن ينشدها بين يدي الملك، لأن عمرو بن هند كان يتأذى من البرص فإن رغب في الإصغاء إلى شاعر أبرص حجبه عن مجلسه بسبعة ستور، ثم أمر بغسل أثره بالماء.
ولما طرد الملك النعمان بن هرم شاعر بني بكر – من مجلس سبق المباراة – لإساءته الأدب، خاف الحارث بن حلزة على قومه، ونزل على رسم الملك، وقام ينشد معلقته من وراء سبعة ستور. فوقع شعره في نفس الملك موقعاً حسناً، أصلح به ما أفسده النعمان بن هرم، فأمر ابن هند بالأستار فرفعت، وبالحارث فأدني من مجلسه، فدنا وجالسه، وآكله في جفنته، وأمر ألا يغسل أثره بالماء، ثم جز نواصي البكريين المرتهنين عنده، ودفعهم إلى الحارث. فما هذه القصيدة التي استطاعت أن تترك هذا الأثر الطيب في نفس الملك؟ إن معلقة الحارث بن حِلِّزة اليشكري هي قصيدة سياسية، عدة أبياتها في شرح التبريزي واحد وثمانون بيتاً، وفي شرح ابن الأنباري أربعة وثمانون، وهي همزية على الخفيف، مطلعها:
آذنتنا ببيْننا أسماءُ رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الشّواء
وهي إحدى القصائد الملحمية الهامة في العصر الجاهلي، وقد قال المستشرق نلينو في إطرائها: “وما تفرد به معلقنا الحارث وعمرو عن أغلب سائر قصائد الجاهلية أن معظمها يدور على الموضوع الأساسي، فلا يبقى فيهما للغزل والوصف وسائر لواحق القصائد إلا أبيات قليلة جداً”. فالمقدمة الغزلية ثمانية أبيات (١ – ٨) ذكر فيها الشاعر فراق الحبيبة، وعدد منازلها، وشكا فراقها، وبعدها عنه، وبعد المقدمة تأتي ستة أبيات في وصف الناقة (٩ – ١٤) والصورة البارزة في هذا الوصف تشبيه الناقة بنعامة أفزعها القناص. أما القسم الثالث فيبدأ بالبيت الخامس عشر، ويستغرق بضعة وستين بيتاً، وينتهي بانتهاء المعلقة، وفيه يعالج الشاعر القضية السياسية التي ندبه قومه للاضطلاع بها، فيفخر بقبيلته بكر، ويعرض ببني تغلب، ويدفع عن قومه مكايد التغلبيين، ويعدد مفاخر بكر وأيامها، وهكذا تبدو القصيدة – على طولها – فكراً واحداً، متلاحم الأجزاء، لا يعروها استطراد من موضوع إلى موضوع، ولا يتشتت عقل الشاعر بين أفكار متباينة، وعواطف متنوعة.
أغراض شعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري
إن الشعر القليل الذي عثرنا عليه للشاعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري لا يسمح لنا بتقسيمه إلى أغراض على النحو الذي سلكناه في دراسة غيره من شعراء المعلقات، لكننا نستطيع على هدي القليل الذي وقفنا عليه أن نزعم أن في شعره أكثر الأغراض كالوقوف على الأطلال، والغزل، والوصف، والفخر والرثاء، والحكمة، والمدح. وحسبنا أن نلم ببعض هذه الأغراض الرئيسة التي تميز بها شعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري.
١- الأطلال والغزل:
ارتباط الشاعر الجاهلي بالطلل شكل من أشكال الإخلاص للماضي وللأهل وللمحبوبة، ويبرز الحارث بن حِلِّزة اليشكري كواحد من شعراء الجاهلية المخلصين لمنابتهم، ولهذا نراه حينما يعرّج على (الحبس) موطن حبه الأول يعرف الدار من علاماتها الدالة عليها، وكيف يجهلها وهي تبوح بما فيها كما يبوح الورق الأبيض بما كتب فيه. وبعد أن عرف الدار أرسل عينيه تجوسان خلال الأطلال فإذا هي مرتع ليوفر الوحش، ترفل فيها آمنة، فتلتمع ظهورها البيضاء ووجناتها السوداء في وهج الهاجرة كما يضيء وجه الشمس، وإذا حوافر الجياد التي وطئت الرمال منقوشة في جنبات الديار، وإذا هو يعود إلى الماضي يستثير الذكريات من مكامنها، ويقلب أمور الحياة على وجوهها المختلفة، يعمل فيها العقل المفكر مرة، ويرسل فيها الحدس الكشاف أخرى ومحصلة ذلك كله نهاية موجعة، ويأس قاتل، وأماني مخفقات دوارس مصيرها كمصير الديار، دروس ودثور:
لمن الدِّيارُ عُفَوْنَ بِالحَبْسِ آياتها كمَهَارقِ الفَرسِ
لا شيء فيها غير أصورة سُفْعٌ الخُدُودِ يَلُحْنَ كالشمسِ
أو غير آثار الجياد بأغـ ـراض الجماد وآيةِ الدَّعسِ
فحبسْت فيها الركبَ أحدس في كلِّ الأمور وكنت ذا حدْسِ
وَيَئسْتُ ممَا قَدْ شَعَفْتُ به منها ولا يسْليك كاليأسِ
وفي معلقته أبيات أخرى ينحو فيها هذا النحو الباكي اليائس، فيبكي الأطلال، ويذكر اثنتين من صويحباته ذكر اليائس من اللقاء، وهما هند وأسماء.
٢- المفاخرة والمنافرة في ظلال السياسة:
درجنا في دراسة الشعراء على الاجتزاء بالفخر عنواناً لما يقول الشعراء في الاعتزاز بأنفسهم وأقوامهم، وهنا شفعنا المفاخرة بالمنافرة، لأن قصيدة الحارث بن حِلِّزة اليشكري تنحو في الفخر نحواً موسوماً بسمة خاصة، إذ تبدو كأنها خطبة ألقاها داعية من دهاة السياسة، أو مرافعة قانونية، أعدها محام بارع، يعرف كيف يدافع عن حقه، وعن حق من ندبوه، ويعرف كيف يدحض باطل الخصم بالحجة مرة، وبالتعريض ثانية، وبالتحريض أخرى.
- أصل المنافرة: هي المفاخرة التي تأخذ شكل المحاورة، وموضوعها الدفاع عن المكارم والاعتزاز بالمناقب. جاء في اللسان: “نافرت الرجل منافرة إذا قاضيته، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة، والمنافرة المحاكمة في الحسب”. قال أبو عبيد: “المنافرة أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه، ثم يحكما بينهما رجلا … والمنفور المغلوب، والنافر الغالب.. وكأنها جاءت المنافرة في أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعز نفراً؟”.
- سياق المنافرة: في حديثنا عن عمرو بن كلثوم ذكرنا جانباً من هذه المنافرة، وأن ملك الحيرة بعد حرب السوس احتجز في قصره رهائن من بكر وتغلب ليضمن التزام القبيلتين ما اصطلحنا عليه، وأن عمرو بن هند سير ركباً من تغلب وبكر إلى جبال طيء فأجلى البكريون التغلبيين عن الماء، ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطشاً، وان عمرو بن هند دعا الفريقين إلى التقاضي بين يديه، فانتدبت تغلب شاعرها وسيدها عمرو بن كلثوم، وانتدبت بكر أحد أشرافها النعمان بن هرم، وكان عمرو بن هند يفضل التغلبيين على البكريين فطرد مندوب بكر بعد مجادلة احتدمت بينهما، قالت تبعة الدفاع عن بكر إلى شاعرها الحارث بن حلزة.
- براعة الحارث: أتى الحارث بن حِلِّزة اليشكري المنافرة وفي جعبته سهام أعدها أحسن إعداد، وطفق يرميها بعد تسديد محكم، وبصيرة واعية. فالسهم الأول هو التعريض بعمرو بن كلثوم ورميه بالوقيعة والكيد، والسهم الثاني هو مديح ذو شعبتين للملك عمرو بن هند وجده المنذر بن ماء السماء، أما السهم الثالث فكان الإصرار على الوفاء بالعهد المكتوب والتحذير من مخالفته، وبهذه الملاينة الحازمة استطاع الشاعر أن يستميل قلب الحكم لصالحه.
٣- الحكمة:
ذكرنا أن الشعر الجاهلي القليل الذي بلغنا عن الحارث بن حلزة لا يتضمن أغراضاً كثيرة، كالأغراض التي نجدها لدى الشعراء المكثرين، وفي هذا القليل طائفة من النظرات تدل على أن الشاعر أوتي ذهناً حصيفاً، وبصيرة نفاذة، وأنه كان قادراً على نقد الحياة، واستخلاص الحكمة من التجربة.
- نظرته للحياة: يرى الحارث أن السعادة في الحياة لا تتحقق بالسعي الدؤوب، بل بالحظ السعيد، فقد أشقى الزمان الحارث، وأعطى أغبى الأغبياء الثراء العريض، ولو نظرت فيها يملك الأغنياء من نعم وفيما وهبوا من ملكات وما أحسنوا من عمل لراعك هول التناقض.
منْ حاكمٌ بيني وبيـ ـن الدَّهرِ مالَ عليَّ عمداً
فَلَكَمْ رأيتُ معاشراً قدْ جمَّعوا مالاً وولدا
وهم ربابٌ حائرٌ لا يُسْمع الآذانُ رَعدا - خلاصة حكمته: إذا كان ذلك كذلك فالرأي السديد عنده ألا يعبأ الإنسان بالذكاء، وألا يسرف في السّعي، فرب أحمق مجدود بلغه القدر ما يقصر عنه الأذكياء الأقوياء.
عيشي بِجَدّ، لا يَضرْ ك النّوْكَ ما لاقيت جدّا
والعيشُ خيرٌ في ظلا لِ النَّوكِ ممنْ عاشَ كدّا
منزلته وخصائصه الفنية
يحسن أن نتريث في الأخذ بآراء القدماء في الشاعر المقل، لصعوبة بناء الآراء المعقولة على نصوص قليلة، وتزداد صعوبة الحكم حينما يكون الشاعر المقل على صلة بالسياسة، كعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة، لأن من يحكم للشاعر أو عليه لا ينظر في الفن وحده، بل ينظر في الفكرة، وفي جدوى هذه الفكرة، وربما كان الناقد متعصباً للشاعر أو عليه، لسبب ظاهر أو خفي، فتشوب حكمه شائبة التحيز، ويتعذر علينا الوقوف على الحقيقة.
وقد أحسن صاحب الطبقات حينما قرن ابن كلثوم بابن حلزة في قرن، وجعلهما كبشي نطاح، وذكر المفضل الضبي أصحاب السبع (المعلقات) التي تسمى السمط فأسقط عنترة والحارث بن حلزة، وجاء في العمدة: “فمن رفعه ما قال من القدماء الحارث بن حلزة اليشكري فجعله أول الناس الذين رفعهم شعرهم، وذكر المقلين، وقال: ومنهم عنترة، والحارث بن حلزة، وعمرو بن كلثوم”. نستنبط من هذه الأقوال أن قدماء النقاد لم يقدموا الحارث كما قدموا غيره من شعراء المعلقات، وأن وضعه بينهم أمر يقبل النقض، ولا نستبعد أن يكون موضوع القصيدة أثر في الرقي بها إلى منزلة المعلقات، فما خصائص شعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري الفنية؟
إن المنطق وسوق الحجج من أبرز خصائص شعر الحارث بن حِلِّزة اليشكري؛ فلم يفرض نفسه على عمرو بن هند بقوة فنه وجمال تصويره وتعبيره، بل فرض نفسه عليه وعلى النقاد بالمنطق الصائب، والجدال المحكم، وسوق البراهين. وأول مظاهر هذه الملكات العقلية أنه زهد في المقدمات التي تشتت انتباه السامع، فلم يكثر من الغزل والوصف، بل حدد غرضه تحديداً دقيقاً، وشفع فكرته ببراهين متعاقبة على نحو واضح مقنع.
كذلك، أغنى الحارث فكرته المحددة بأحداث التاريخ، وعرض هذه الأحداث بأسلوب ملحمي، يمتزج فيه الخيال بالحقيقة، والتصوير بالتحليل، وأبرزها عدوان الأراقم – وهم بطن من تغلب – على بني بكر، وإغارة بكر على قبائل البحرين والإحساء، وعلى بني تميم. والجميل في سرد هذه الأحداث أسلوب الشاعر الملحمي الذي جمع الوصف إلى القصة، ومزج العصبية القبلية بالدعوة إلى السلم والتهديد الزاجر بالعتاب الوادع بلغة فخمة واضحة، تثير الحمية والنخوة والمروءة، وتنفخ روح الحماسة في نفوس العرب، وتقنع أعداء الشاعر وأصدقاءه بسمو مقاصده.
أما عن سهولة اللغة، فلغة الحارث بن حِلِّزة اليشكري لينة طبعة، وهي في لينها لا تعوزها القوة، ضمنها الشاعر بشيء من محاورة، ويسير من جمل إنشائية تحرك العواطف بالأمر والنداء والاستفهام، كقوله:
أيها الناطِقُ المُبْلَعُ عَنا عِنْدَ عَمرو، وهل لذاك انتهاءُ
وقوة الأسلوب لا تخالطها غرابة في اللفظ، والألفاظ الغريبة القليلة ترد في صفة ناقته السريعة التي تشبه نعامة طويلة، تحيا في المفاوز مع صغارها.
بِزَفوفٍ كَأَنَّهَا هِقْلةُ أمّ رِئالٍ دوّيّةٌ سَقْفَاءُ
ومثل هذا البيت لا يعكر صفو الأسلوب، ولا يذهب بتناغم الإيقاع العام، ولا يفسد الموسيقا التي ترق في صفة الأطلال، وتشتد في الفخر، وفي تصوير الحرب والاستعداد لها، حتى ليواكب الصوت المعنى، ويرافقه بما يوائمه من نغمات، كقوله:
أَجْمَعُوا أَمْرُهُمْ عِشَاءُ، فلمّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَتْ هُمْ ضَوْضَاءُ
مِنْ مُنَادٍ، وَمِنْ مُجيبٍ، وَمِنْ تَصـ ـهالِ خَيْلٍ خلالَ ذاكَ رُغَاءُ
وهكذا، يظل الحارث بن حِلِّزة اليشكري علامة فارقة في تاريخ الشعر العربي، وشاعراً استطاع أن يوظف فنه لخدمة قضية قومه في واحدة من أروع قصائد الدنيا.
أسئلة شائعة
١- من هو الحارث بن حِلِّزة اليشكري؟
هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري البكري، أحد أبرز شعراء العصر الجاهلي، وصاحب إحدى المعلقات السبع، وقد عُرف بدفاعه عن قبيلته “بكر” في حضرة الملك عمرو بن هند.
٢- ما هو السياق التاريخي لمعلقته الشهيرة؟
نُظمت المعلقة في سياق المنافرة بين قبيلتي بكر وتغلب أمام الملك عمرو بن هند بعد حرب البسوس، حيث ألقاها الحارث لدحض حجج خصمه عمرو بن كلثوم التغلبي والدفاع عن قومه.
٣- لماذا ألقى الحارث معلقته من وراء سبعة ستور؟
ألقاها من وراء حجب لأنه كان مصاباً بالبرص، وكان الملك عمرو بن هند يتأذى من رؤية المصابين به، فلم يسمح له بالدخول إلى مجلسه مباشرة إلا بعد أن أعجبه شعره فأمر برفع الستور.
٤- ما هو الغرض الرئيس لمعلقة الحارث بن حلزة؟
الغرض الرئيس للمعلقة هو سياسي بامتياز، فهي تعد مرافعة قانونية ودفاعاً سياسياً عن قبيلة بكر، حيث يفخر الشاعر بقومه ويدفع عنهم التهم ويذكر مآثرهم وأيامهم.
٥- ما هي أبرز الأغراض الشعرية التي تناولها في شعره؟
تناول في شعره أغراضاً متعددة أبرزها الوقوف على الأطلال، والغزل، والمفاخرة والمنافرة ذات الطابع السياسي، بالإضافة إلى الحكمة التي تعكس نظرته الفلسفية للحياة.
٦- بمَ تميز أسلوب المفاخرة لدى الحارث بن حلزة؟
تميز أسلوبه في المفاخرة بأنه لم يكن فخراً مجرداً، بل كان أشبه بخطبة سياسية أو مرافعة قانونية محكمة، استخدم فيها الحجج المنطقية والبراهين التاريخية لدعم موقف قومه وإقناع الملك.
٧- كيف تبدو نظرة الحارث إلى الحياة من خلال شعره الحكمي؟
يرى الحارث في حكمته أن الحياة محكومة بالحظ السعيد (الجد) أكثر من كونها نتيجة للسعي والكد، وأن الأرزاق قد تُوهب لمن هو أقل ذكاءً وقوة، بينما يشقى الأذكياء.
٨- ما هي الخصائص الفنية البارزة في شعر الحارث بن حلزة؟
تتمثل خصائصه الفنية في المنطق القوي وسوق الحجج، والأسلوب السردي الملحمي الذي يمزج التاريخ بالخيال، بالإضافة إلى لغته السهلة الواضحة التي لا تخلو من القوة والفخامة.
٩- هل أجمع النقاد القدماء على منزلة الحارث الشعرية؟
لم يقدمه جميع النقاد القدماء على غيره من شعراء المعلقات، فبينما جعله البعض في طبقة عمرو بن كلثوم، أسقطه آخرون مثل المفضل الضبي من قائمة أصحاب المعلقات السبع.
١٠- كيف استطاع الحارث التأثير في الملك عمرو بن هند؟
استطاع التأثير فيه من خلال ثلاثة محاور رئيسة: التعريض بالخصم، ومدح الملك وأجداده بأسلوب ذكي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق، مما أدى إلى استمالة قلبه.